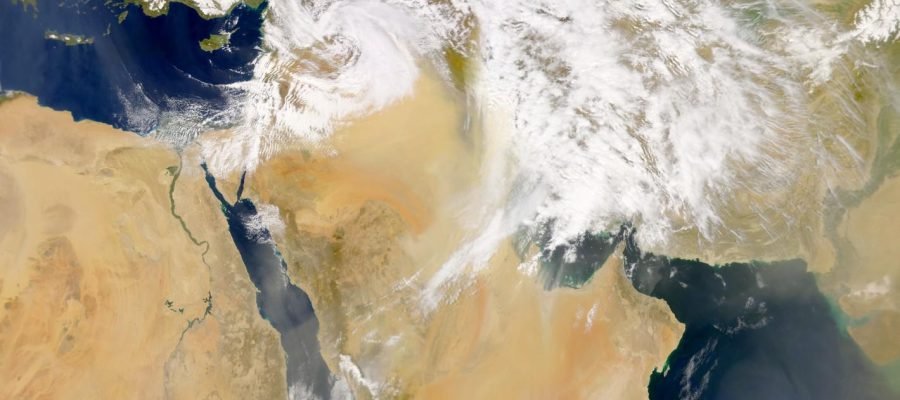المحتوى
- المقدمة
فريدريك ويري - ما وراء “التعهدات الخضراء”: المملكة العربية السعودية وإصلاحات مناخية هدفها المجتمع.
جستين دارجين - الحفاظ على أهوار بلاد الرافدين في العراق في مواجهة التحديات المناخية.
زينب مهدي - ثمن التعثر في إصلاح الحوكمة المناخية في الأردن.
مروان المعشّر - هل يتمكن الاقتصاد الأخضر من إنقاذ لبنان من مهالك الانهيار الاقتصادي؟
مها يحيى وعصام قيسي - السياسات البيئية الإقليمية التي تدعمها فلسطين والولايات المتحدة الأمريكية لمكافحة التغير المناخي وشُح المياه.
زها حسن وماديسون اندروز وماثيو مضاعين - مصر: المجتمعات الريفية الهشة وإدارة الموارد في ظل شُح المياه.
عمرو حمزاوي ومحمد المويلم - العوائق الفيدرالية التي تواجه الزخم المناخي في تونس.
سارة يركيس وهيلي كلاسين - ليبيا: لامركزية القرار والتكيف مع آثار هشاشة الوضع المناخي.
فريدريك ويري - التغير المناخي وآفاق الهجرة بين غربي وشمال إفريقيا.
جيلز أولاكونلي يابي
المقدمة
فريدريك ويري
لطالما شُغِلَت شعوب الشرق الأوسط عبر تاريخها الطويل بالتغير المناخي وآثاره التي تَجَلّت عبر آلاف السنين في تَطَرُّف درجات الحرارة وتواتر موجات الجفاف والفيضانات. ولطالما اهتمت هذه الشعوب بالدور الذي يلعبه البشر فيما تعانيه الأرض من دمار بيئي ومن استهلاك جشع للموارد الطبيعية.
فريدريك ويري
تناول التراث الأدبي التاريخي لسكان المنطقة هذه المشكلة، وعَرَض الشعراء والأدباء، عبر مخيلة أدبية فريدة، ملمحاً واقعياً موثّقاً لمدى اهتمامهم بهذه الظاهرة الطبيعية وآثارها. وتروي لنا الملاحم التي خَطّها شعراء بلاد ما بين النهرين منذ أربعة آلاف عام ما جناه البشر على الطبيعة. حيث تحكي لنا قصيدة “ملحمة جلجامش”، أقدم نص أدبي في التاريخ، كيف يرثي البطل حال الأرض قائلاً: “أواه يا صديقي! لقد حولنا الغابة إلى أرض قاحلة، كيف سنبرر فعلتنا هذه لإنليل في نيبور؟” وبعد خمسة قرون تطالعنا قصيدة ” لعنة أكاد” التليدة بوصفٍ أسطوريٍّ ساحر لما حل بالإمبراطورية الأكادية، التي ازدهرت يوماً جنوبي بغداد، من تدهور عزاه العلماء جزئياً لموجة ” الجفاف الهائل” التي تسبب بها التغير المناخي، والتي تضاعفت آثارها السلبية على الشعب الأكادي بسبب سوء الحوكمة ومركزية الإدارة وسوء التخطيط الزراعي.وينعى النص لقارئه أن ” المساحات الزراعية الشاسعة لم تطرح الحبوب … وأن السحب المجتمعة لم تنزل بالمطر.”
ولنتجاوز الماضي وننطلق إلى بلاد ما بين النهرين في عام 2013، بعد مرور عشر سنوات على الغزو الأمريكي للعراق، لنجد أن الأدب المَحَلّي لا يزال مهموماً بما تعانيه الأرض من تبعات التغير المناخي. يأخذنا الكاتب حسن بلاسم عبر أحداث روايته التأملية ” حدائق بابل” إلى عالم ما بعد النفط في العراق حيث جفت الأنهار والحقول “وزحفت الصحراء على المدن لتمحيها ” جرّاء الاحترار العالمي الذي استفحل نتيجة لامبالاة الساسة. يتعجب راوي القصة العراقي قائلاً ” كم هي محيرة ومؤلمة مسيرة الإنسان!” ويحكي لنا كيف سارعت إحدى الشركات الصينية لإنقاذ ما تبقى من الحضارة عبر إنشاء وتشغيل مدينة ذكية تعلوها القباب وتزينها “حدائق الإنترنت” وتنتشر في جنباتها أجهزة تنقية الهواء والقطارات السريعة الإيرانية الصنع التي تنقل المياه النادرة والثمينة من دول شمال أوروبا.
تعرض لنا الرواية كيف أضحت بابل تحت إِمْرَة دمية مستبدة في صورة موظف يحكمها ويتحكم بها. وكيف بٌعِثَت المدينة من جديد لتصبح مركزاً للابتكار الرقمي ومصدراً ينشر ” أذكى البرمجيات” في كافة أرجاء المعمورة. ولكن كل شيء ليس على ما يرام في “عصر السلام والأحلام” هذا. ينقلنا الكاتب إلى جانب آخر من الحياة في المدينة المنكوبة حيث تُوَصّل الشاحنات الآلية المدرعة حصص المياه المُقَننّة إلى الفقراء من المواطنين الذين يعانون لدفع ثمنها من محافظ الائتمان الإلكتروني الخاصة بهم، بينما ينعم الأثرياء بمَدَدٍ لا ينتهي من المياه التي تملأ حمامات السباحة في بيوتهم الفارهة. وتتوالى الأحداث ليندلع في المدينة تمرد يقوده من يُسَمَّوْن ب” متمردي المياه” الذين يتمكنون من اختراق الأنظمة الإلكترونية للشركة الصينية ويستخدمون أدواتها للسيطرة على أنظمة البنية التحتية للمياه في المدينة.
الحقيقة أن ما تعرضه الرواية هو رؤية مقلقة ومثال حي على نوع ناشئ من الأدب العربي هو أدب الخيال العلمي الذي يحذر من خطر الاعتماد الحصري على الحلول التقنية في الاستجابة لمشكلة التغير المناخي خاصة في المجتمعات التي تعاني من أنظمة الحكم غير الديمقراطية ومن تراث متجذر لانعدام العدل والمساواة. وعلى صعيد آخر تشير رؤية الرواية إلى مستقبل تتحول فيه الشراكة الصينية الاقتصادية -الحميدة في ظاهرها – مع دول الشرق الأوسط إلى إمبريالية جديدة، وهي رؤية تحذيرية تحاول لفت الانتباه إلى تزايد الولع الذي اجتاح بعض دول المنطقة بالعملاق الصيني حالياً.
وإن كانت بعض ملامح هذه المدينة الفاسدة المُتَخَيّلَة، والمفرطة في التشاؤم كما هو متوقع من مثل هذه الكتابات، تبدو مألوفة لنا، فذلك لأننا نعيش تجلياتها المخيفة في عالمنا الحالي بالفعل. تُعد دول الشرق الأوسط، خاصة الناطقة باللغة العربية، من أكثر دول العالم تعرضاً للآثار المتسارعة للتغير المناخي الناتج عن عوامل التدخل البشري والتي تتمثل في اشتداد الموجات الحارة وانخفاض معدلات هطول الأمطار وتواتر نوبات الجفاف وكثرة العواصف الرملية والفيضانات وارتفاع منسوب مياه البحار. ولكن دول المنطقة لن تعاني من عواقب كل هذا على قدم المساواة، إذ ستعاني الدول فقيرة الموارد والتي لا تتوفر لها قدرات التكيف الضرورية – مثل البنية التحتية المناسبة والتكنولوجيا المتطورة ورأس المال البشري والمادي الكافي – معاناة شديدة للتغلب على تطرف الظواهر المناخية خاصة وأن الاحترار العالمي يؤدي إلى تردي سبل العيش في المناطق الريفية ما يفاقم أخطار الأمن الغذائي.
ولا شك أن آثار التغير المناخي ستؤدي إلى تعاظم ما تعانيه تلك المجتمعات من إجحاف أنتجته عقود من السياسات الحكومية غير المستدامة لا سيما تلك المتعلقة بإدارة المياه والأراضي. وعلى النقيض من ذلك، نجد أن الدول الغنية المُصَدِّرة للنفط لديها من التدابير والآليات ما يساعدها على تخطي الصدمات المناخية بشكل مثالي; سواءً من خلال الاستثمار في مشاريع تحلية المياه والمشاريع الزراعية -غالباً خارج منطقة الشرق الأوسط – أو عن طريق استيراد ما تحتاجه من المواد الغذائية. ومع ذلك، فإن قدرة هذه الدول الريعية-التي تعتمد على توزيع ريع الموارد الهيدروكربونية التي تجود بها أراضيها على مواطنيها في شكل إعانات ووظائف ومزايا اجتماعية- على مواجهة التحديات المناخية سَتخضع لاختبار الزمن في ظل الضغوط المالية التي يفرضها التحول العالمي نحو الطاقة الخضراء. ويمثل هذا التحول محور التعهدات التي قدمتها هذه الدول لخفض انبعاثات غازات الدفينة حتى الوصول إلى تحقيق صافِ انبعاثٍ صفري ووضع مخططات لاستبدال مصادر الطاقة المُلَوِثَة وغير المتجددة، كالفحم والغاز والنفط، بالطاقة المتجددة، وحجز انبعاثات ثاني أكسيد الكربون وتصدير الهيدروجين الأخضر.
ولكن عجز الخطط الحكومية في هذه الدول عن إجراء تغييرات حقيقية في منظومة الحوافز الأساسية التي تساعد على بناء أنظمة اقتصادية وتنظيمية وسياسية أكثر تَكامُلاً، يضع جدوى تلك التعهدات والخطط موضع الشك. والأهم في نفس هذا السياق، أن كُلاً من الدول المُصَدّرة والمستوردة للنفط لا تزال حتى الآن تضع محاولات التخفيف من آثار التغير المناخي على رأس أولوياتها بدلاً من تبني خطط التكيف مع هذا التغيير والتي عرّفتها الأمم المتحدة على أنها “عملية التكيف مع الأحوال المناخية الراهنة أو المتوقعة، والآثار المترتبة عليها بغرض تخفيف ما قد ينجم عنها من أضرار”. والحقيقة أن التكيف المناخي وما يتطلبه من تمويل لم يأخذ بعد مكانه المُستَحَق بين الأولويات العالمية، ولكن تأخره في البلدان العربية يرتبط ارتباطاً وثيقاً بطبيعة أنظمة الحوكمة العربية.
الواقع أن سنوات طويلة من تبني الأنظمة العربية الحاكمة، وهي أنظمة يغلب عليها الانغلاق والاستبداد والقمع والشمولية بدرجات متفاوتة، لسياسات مركزية ومناهج إدارة فوقية، قد أنتج حكومات تتردد في السماح بأي نوع من أنواع النشاط الشعبي التصاعدي أو تشجيعه -على الرغم مما بعثته الانتفاضات العربية في 2011، من آمال في الصدور- وهو ما تحتاجه تلك الدول لبناء قدرة حقيقية وفعالة على مواجهة التغير المناخي القادم.
نتيجة لذلك، تَعد الشرائح السكانية الأكثر عُرضة لآثار التغير المناخي سواءً بسبب موقعها المكاني أو بسبب ما تعرضت له عبر تاريخها الطويل من إهمال حكومي وسياسات اجتماعية واقتصادية فاشلة وتهميش سياسي هي الفئات التي يتم إقصاؤها من الحوارات المناخية، على الرغم مما قد ينتجه هذا الإقصاء من عواقب وخيمة ليس فقط على أمن ورفاه تلك المجتمعات المتضررة-والتي يمكنها أن تسهم من خلال خبراتها المحلية بمدخلات قيمة تساعد في التكيف مع التغير المناخي والتخفيف من آثاره- ولكن أيضاً على التنمية والاستقرار في بعض البلدان.
ولعله من الأهمية هنا، أن نوضح أن التغير المناخي ليس هو المحرك الرئيس أو العامل الأهم فيما يحدث في منطقة الشرق الأوسط من صراعات واحتجاجات. والحقيقة أن الافتراض الشائع بوجود صلة سببية مباشرة بين ظاهرة الاحترار العالمي والجفاف والهجرة الريفية إلى الحضر، وبين الاحتجاجات الاجتماعية التي اندلعت في 2011، وأدت إلى الحرب الأهلية السورية، قد دحضها العديد من العلماء الذين انصب اهتمامهم على عوامل أخرى مثل التأثيرات السلبية لسياسات النظام السوري وأيديولوجيته الفاسدة، وغياب ما يسمى بمهاجري المناخ عن الفترة الأولى من المظاهرات وغيرها من العوامل التي خضعت للفحص الدقيق. وقد توصلت العديد من الدراسات التي أجريت في بلدان أخرى شهدت تحركات سياسية مماثلة إلى نفس النتيجة التي تؤكد أن تحول أي حدث مناخي إلى حرب أو اضطرابات شعبية لابد أن تدفعه أو تُحَرّكْه العديد من العوامل المتداخلة خاصة المتعلقة باختيارات السلطة السياسية.
أما التوصيف السياسي المفضل للتغير المناخي على أنه “عامل مُضاعِف للمخاطر”- بمعنى أنه مُحَفِّز يعمل على تسريع وتضخيم المخاطر والضغوطات الأمنية الموجودة- فقد تعرض لانتقادات عديدة لما يشوبه من غموض وقصور ولتناقضه مع ما يفترضه من تعريف مبسط للأمن على أنه “غياب الصراع العنيف”.
وبالمثل فإن الكثير من التنبؤات المتعلقة بحجم الهجرة البشرية التي قد يتسبب بها التغير المناخي، خاصة عبر الدول، تعتبر استشرافية أكثر مما ينبغي ولا تدعمها البيانات، والأخطر من ذلك أن الحكومات التي تعاني من رهاب الأجانب قد تحتج بها لعرقلة التحركات البشرية نحو أراضيها بدلاً من أن تعتبر هذه التحركات شكلاً من أشكال التكيف المناخي. وحتى النبوءة التي راجت بشدة بأن التغير المناخي سيزيد احتمالات وقوع ما يسمى ب “حرب المياه”، تتحداها دراسات أشارت إلى غياب مثل هذه الصراعات عن السجلات التاريخية، وإلى إمكانيات مستقبلية “للتعاون المائي” والدبلوماسي.
والخلاصة أن هذه الرؤى التحليلية المتباينة للتناول الحتمي والأمني المبالغ فيه لمشكلة التغير المناخي سيكون لها آثار سياسية كبيرة على منطقة الشرق الأوسط، وبالأخص على الدول العربية، وذلك لأن هذه التحليلات تميل إلى إغفال الأسباب الحقيقية لمشكلة الهشاشة المجتمعية أمام تحديات التغير المناخي، وتُعفي حكام المنطقة من الاعتراف بأن سياساتهم القاصرة والتي تسببت في هُزال شبكات الأمن الاجتماعي وتضخم القطاع العام واستشراء الفساد وتردي الخدمات البيئية واندلاع الحروب الأهلية والإقليمية، هي السبب الرئيس فيما تسبب به تغير المناخ من آثار على رفاهية مواطنيها.
ويمكن أن تؤدي هذه القراءات ايضاً إلى إعطاء الحلول التكنولوجية لمشكلتي تحول الطاقة والتكيف المحلي مع التغير المناخي أكثر مما تستحق من اهتمام، وهو أمر من شأنه أن يؤدي إلى استمرار سياسات “سير العمل كالمعتاد” فيما يتعلق بالحفاظ على الاقتصاد الريعي وما يدعمه من ترتيبات سُلطَوية عفا عليها الزمان.
وبعبارة أخرى فإن السياسة والحوكمة وعوامل الوعي البشري كلها مجتمعة لا يمكن الاستغناء عنها في تخفيف ما تتعرض له المجتمعات من المخاطر البيئية والتغيرات المناخية. وهذه مُسَلَّمَة حتى وإن لم يعترف بها القائلون بالحتمية المناخية أو المدافعون عن الأنظمة العربية السائدة.
في هذا السياق، تهدف مجموعة المقالات التالية إلى عرض وجهات نظر تتحدى الإغراق في الفكر الأمني وفي نظريات الحتمية المناخية من خلال التعرض إلى قضايا الحوكمة والسياسة ودمجها في الحوار الدائر عن المناخ في العالم العربي.
وتستعين هذه المقالات بالخبرة الميدانية الكبيرة التي تتمتع بها مؤسسة كارنيغي في المنطقة لتقدم رؤى ومقترحات تساعد الأنظمة والجهات الفاعلة المحلية على بناء قدراتها لمواجهة التغير المناخي ليس فقط من خلال الإصلاحات التقنية، ولكن عبر مجموعة من الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية. وتغطي المقالات عينة جغرافية كبيرة وعدداً لا بأس به من التجارب والسياقات المتنوعة. وتولي هذه الدراسة اهتماماً خاصاً للفئات المهمشة والمجتمعات المُعَرّضَة للمخاطر التي تشمل، على سبيل المثال لا الحصر، المهاجرين واللاجئين ومحدودي الدخل من المواطنين والنساء، والعاملين في القطاعات غير الرسمية والزراعية والسياحية وسكان المناطق الريفية الداخلية والساحلية.
لا تُعْنَى هذه المقالات بأن تكون جامعة مانعة، بل تهدف إلى اقتراح بعض الأطر التحليلية المبدئية وبعض الأفكار المنهجية التي قد تسهم في معالجة بعض مجالات الهشاشة المجتمعية من خلال اتباع سياسات تحرص على إشراك المجتمعات المحلية، والشروع في الإصلاحات الإدارية والاقتصادية والسياسية كاللامركزية على سبيل المثال.
ويتقدم كتّاب هذه المقالات بالشكر والتقدير لجميع مُحاوِريهم في المنطقة العربية، الذين أَثْروا المقالات بِرُؤاهم، سواء من خلال حضورهم الشخصي أو عن بعد، والذين اضطرتنا الظروف أحياناً لإخفاء هوياتهم.
ونتقدم بالشكر لكل من هايلي كلاسين ولوري ميريت وأنجولي داس وناتالي بريز على خبراتهم المميزة في مراجعة المقالات. والشكر موصول لكل من آيه كامل وجوي عركة على مساعداتهما البحثية. كذلك، نعرب عن امتناننا للإدارة التنفيذية لمؤسسة كارنيغي على ما قدمته من تمويل داخلي ساعدنا على القيام بهذا البحث.
ما وراء “التعهدات الخضراء”: المملكة العربية السعودية وإصلاحات مناخية هدفها المجتمع
جستين دارجين
تواجه منطقة الخليج العربي تحدياتٍ هائلة في التصدي للنتائج الوخيمة لمشكلة التغير المناخي وما يترتب عليها من تبعات معقدة ومتشابكة. فبعد سنوات من التغافل والإنكار بدأت دول الخليج في استيعاب ما يمكن أن يسببه التغير المناخي من آثار قد تهدد استقرارها وأمنها وقدرتها على البقاء. ومع ذلك فإن ما يتطلبه تخفيف تلك الآثار من إرادة سياسية حازمة وجهود تعاونية تتضافر فيها كافة فئات المجتمع لا تزال في طور التكوين.
جستين دارجين
ومثل غيرها من دول المنطقة، تعتبر المملكة العربية السعودية عُرضةً للتغير المناخي الذي يهدد البيئة المناخية الطبيعية للبلاد فضلاً عما يشكله من خطر عام على المجتمع وعلى مؤسسات الدولة.
تعتبر مشكلة ارتفاع درجات الحرارة من أكبر المشاكل التي تواجه المنطقة حالياً. حيث فاقت درجات الحرارة في المنطقة المعدل المتوسط العالمي لتتجاوز درجة الحرارة في كل من إيران والكويت وعُمان والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة خمسون درجة مئوية في عام 2021. وفي حال استمرت هذه المعدلات، فمن المتوقع أن تصبح أجزاءً كبيرة من المنطقة غير صالحة للحياة الآدمية بنهاية هذا القرن. ويحذر علماء المناخ من أن درجات الحرارة في المنطقة قد تزداد بمقدار 4 درجات مئوية بحلول عام 2050، وهو ما يعني صعوبة العودة لعتبة 1.5 درجة مئوية التي قررتها اتفاقية باريس للمناخ كحد أقصى للاحترار العالمي، ما قد يتسبب في انهيار بيئي عالمي.
تعتبر الفيضانات المفاجئة مصدر قلق كبير آخر للملكة العربية السعودية التي تتعرض بشكل دوري، على الرغم من كونها دولة قاحلة للغاية، لموجات غزيرة من الأمطار التي تتحول إلى فيضانات مفاجئة بسبب انتشار التجمعات السكنية العشوائية وعدم وجود البنية التحتية اللازمة لتصريف مياه الأمطار في معظم المدن. وتعد الفيضانات حدثاً ملحوظاً وشائعاً في المناطق الجبلية الواقعة جنوبي غرب المملكة حيث تسببت في أضرار وخسائر كبيرة في الأرواح والممتلكات على مدار السنوات العديدة الماضية.
ومن المفارقات أن الجفاف يُعد أيضاً من مصادر القلق الكبيرة للمملكة. فعلى الرغم من الهطول العَرَضِي الغزير للأمطار إلا إنه من المتوقع أن يتسبب التغير المناخي في انخفاض عام في أنماط هطول الأمطار المسجلة محلياً وفي ارتفاع معدلات التبخر. وتشير توقعات التغير المناخي إلى أن البلاد ستعاني من فترات جفاف طويلة ستؤدي إلى استنزافٍ سريعٍ لخزانات المياه الجوفية، وإلى تفاقم مشكلة شُح المياه بين المجموعات السكانية الهشة والمهمشة. وتعد المملكة العربية السعودية واحدة من أكثر الدول التي تعاني من شُح المياه على سطح الأرض، خاصة مع تضاعف الاستهلاك الفردي اليومي للمياه ليصل إلى 265 ليتراً في اليوم.
وقد أدى الاستهلاك المتزايد للمياه الجوفية إلى انخفاض عنيف في مكامن المياه الجوفية في البلاد ما تسبب في هبوط حاد للأراضي في بعض أنحاء المملكة.
لا تقتصر أزمة المياه بأي حال من الأحوال على الحدود الوطنية للمملكة العربية السعودية، حيث من المتوقع أن تواجه منطقة الخليج بأكملها، بحلول عام 2050، انخفاضاً قد يصل إلى 50 في المئة في نصيب الفرد من المياه ما يشكل خطراً كبيراً على الأمن الغذائي والاستقرار الاقتصادي في المنطقة، فضلاً عما سيؤدي إليه من زيادة الانبعاثات الكربونية في المملكة التي تحاول توفير احتياجاتها من المياه عن طريق الاعتماد بشكل متزايد على عمليات تحلية المياه التي تضع ضغوطاً هائلة على استهلاك الطاقة.
يشكل ارتفاع مستوى سطح البحر تهديداً خطيراً آخر للمناطق الساحلية في المملكة العربية السعودية التي تشمل مدناً مثل جدة والدمام. وقد يتسبب هذا الارتفاع في مستوى مياه البحر في نتائج كارثية على البنية التحتية والنشاط الاقتصادي والنسيج الاجتماعي لهذه المناطق. حيث من المتوقع أن يتعرض ما يقرب من 200 ألف شخص لفيضانات ساحلية متتالية بحلول عام 2050.
ومن المتوقع أن تتسبب التعقيدات المركبة لمشاكل التصحر وارتفاع منسوب مياه البحار وشٌح المياه في آثار خطيرة على الإنتاج الزراعي والأمن الغذائي للبلاد بشكل عام. فالمملكة تستورد ما يربو على 80 في المئة من احتياجاتها الغذائية، وهي نسبة معرضة للتزايد مع ما تفرزه التغيرات المناخية من إشكالات. وإن لم تتمكن المملكة من تحجيم مستوى الانبعاثات الكربونية المرتفعة، فإن معدلات الجفاف الزراعي ستتزايد بنسبة قد تصل إلى 88 في المئة بحلول عام 2050، وهو ما سيؤدي إلى انهيار منتوجها الغذائي الضئيل كلياً.
المجتمعات المهمشة في السعودية: واقعٌ تعسفي
على الرغم من أن التغيرات المناخية تشكل تهديداً حقيقياً لكافة سكان المملكة، إلا أن بعض المجموعات السكانية مثل العمال المهاجرين والأقليات الطائفية والسكان البدون (وهم مجموعات سكانية لا تحمل جنسية دولة بعينها ويطلق عليهم بالعربية البدون جنسية) ستتحمل العبء الأكبر لما سينجم عن هذه التغييرات من عواقب.
ربما تكون أكثر هذه الفئات هشاشةً في مواجهة الآثار المدمرة للتغير المناخي هي فئة العمال المهاجرين الذين يعيشون ويعملون في ظروفٍ دون المستوى، ويتعرضون للاستغلال وسوء المعاملة، ويفتقرون للحماية القانونية ولا يتمتعون بالخدمات الاجتماعية الأساسية مثل الرعاية الصحية والتعليم. وكلما ازداد تواتر الظواهر المناخية وتطرفها كلما ازداد تعرض هؤلاء العمال لوطأة آثارها.
يعمل هؤلاء العمال في ظروف خَطِرَة ومُرهقة بدنياً، ما يجعلهم عرضة، أكثر من غيرهم، للإجهاد الحراري والتلوث الجوي وغيرها من المخاطر الناتجة عن التغير المناخي. حيث يؤدي طول ساعات العمل وانخفاض الأجور وتدني مستوى تدريبات الأمن والسلامة التي يتلقونها إلى تفاقم التحديات التي يواجهونها في التكيف مع آثار التغير المناخي. وما يزيد الطين بَلّة، افتقارهم إلى الحماية القانونية وعدم قدرتهم على تكوين النقابات أو الاستفادة من الخدمات الاجتماعية وهو ما يعوق حصولهم على ما يستحقون من حقوق ويمنع مطالبتهم بتحسين ظروف العمل.
كذلك تواجه الأقليات الطائفية، وخاصة طائفة الشيعة، تحدياتٍ كبيرة في التكيف مع التغيرات المناخية بسبب ما يلاقونه من صعوبات جَّمَّة في الحصول على ما يحتاجونه من معلومات وتدريبات. وعلى الرغم من التحسن الطفيف الحاصل في أوضاع الأقليات الطائفية حالياُ، إلا أنهم لا يزالون يُستبعدون من آليات اتخاذ القرار الهامة. وتساهم الحالة الاقتصادية المتردية في إعاقة فرصهم وقدرتهم على التكيف خاصة إن كانوا يعملون في مجالات الزراعة أو صيد الأسماك حيث يمكن لتأثيرات التغير المناخي، مثل الجفاف وتَحَمُّض المحيطات، أن تقلل من فرص العمل المتاحة لهم وتؤثر على مواردهم المادية. كما يؤدي ما يلاقونه من تمييز سلبي واستبعاد مجتمعي إلى زيادة هشاشتهم في مواجهة التغير المناخي.
أما البدون فهم مجموعة سكانية هشة أخرى تعيش في المملكة وتتألف في معظمها من أشخاص ينحدرون من قبائل البدو الرُحّل الذين لم يحصلوا على الجنسية السعودية خلال فترة نشوء الدولة. ويصعب الحصول على إحصاءات دقيقة تُوثّق أعداد البدون في المملكة بسبب تَعَقُّد قضيتهم وغياب البيانات الرسمية، ولكن التقديرات تشير إلى أن عددهم يتراوح ما بين 70.000 و250.000 شخص. وتضع هذه الأعداد الكبيرة نسبياً المملكة بين الدول التي تضم أكبر عدد من الأشخاص عديمي الجنسية. غالباً يعيش البدون في مستوطنات غير نظامية ويفتقرون إلى المساكن والبنية التحتية الملائمة وإلى الاعتراف والحماية القانونية. والحقيقة أن استحكام شُح المياه الناجم عن التغيرات المناخية سيكون له تأثير مدمر على حياة السكان البدون الذين يعتمد أغلبهم على الزراعة كمصدر رزق. كما أن الجفاف والتصحر سيجعل تربية الماشية ورعي الأغنام، وهما مصدران من أهم مصادر الدخل بين البدون، أمراً صعباً. أما البدون الذين يعيشون في المجتمعات الساحلية فهم مهددون بفقدان منازلهم وأراضيهم وسُبُلِ عيشهم بسبب الارتفاع المتوقع في منسوب سطح البحر وما سيعقبه من فيضانات ساحلية. والحقيقة أن مجتمعات البدون ستكون في وضع غيرِ مواتٍ بالمرة عندما يتعلق الأمر بجهود إعادة البناء والتعافي.
الاستجابة لمتطلبات التغير المناخي عبر الإصلاحات التقنية الشاملة
على الرغم من أن المملكة قد استثمرت مليارات الدولارات في مبادرات التخفيف من آثار التغير المناخي، إلا إنها كانت تتكاسل في وضع التدابير والأٌطُرْ المؤسسية الداعمة التي تساعد على رفع قدرة ومرونة المجتمع على التكيف مع تلك الآثار.
ومع ذلك فقد وضعت الحكومة بعض الاستراتيجيات الاستباقية لمواجهة آثار التغير المناخي، ومنها مبادرة السعودية الخضراء التي أطلقتها المملكة في مارس 2021. هذه المبادرة هي خطة رائعة هدفها تعزيز حماية البيئة وتشجيع تحول الطاقة وبرامج الاستدامة في البلاد. وتشتمل الخطة على العديد من البرامج التي تهدف إلى زراعة 10 مليار شجرة وتقليل الانبعاثات الكربونية وتحسين جودة الهواء في مدن المملكة. ولا شك أن هذه البرامج كلها تمثل خطوات مهمة على مسار تخفيف آثار تغير المناخ إلا إنها قد لا تكون كافية لضمان إشراك المجتمعات المهمشة إشراكاً كاملاً في هذه الجهود وفي عمليات صنع القرار.
أما مشروع المرونة الحضرية بالدمام فهو أحد الأمثلة الواعدة على نهجٍ أكثرَ تشاركية. حيث يركز هذا المشروع على تحسين التخطيط العمراني بشكل يساعد في التخفيف من آثار تغير المناخ على سكان المدينة. ويسعى المشروع لإشراك المجتمعات المحلية ومنظمات المجتمع المدني في عمليات تخطيط وتنفيذ المشاريع البيئية لضمان تلبية الاحتياجات والشواغل الاستثنائية والخاصة للفئات المهمشة. يمكن أن يساعد هذا النوع من المشاريع على تمكين الأشخاص المهمشين، وتعزيز الشمولية والإنصاف، وزيادة احتمالية نجاح جهود التكيف مع التغير المناخي.
ولكن هذه المبادرات المُبَشّرة قد تعترضها بعض العقبات بسبب اعتماد غالبية برامج التغير المناخي في السعودية اعتماداً كبيراً على النهج الحكومي المنفرد الذي لا يأخذ احتياجات ووجهات نظر المجتمعات المحلية بعين الاعتبار. ومن أجل تحقيق مستقبلٍ مستدامٍ لجميع سكان المملكة، من الضروري أن تتبنى الحكومة منهاجاً تشاركياً شاملاً في مبادرات تغيير المناخ.
مشاركة المجتمعات المحلية في عمليات صنع القرار يساعدها على تمثيل وجهات نظرها ومصالحها بشكل أفضل ويساعدها أيضاً على دعم العمل المناخي. وعلى سبيل المثال يمكن تأسيس مبادرات لإعادة التحريج بقيادة المجتمعات المحلية في المناطق التي تعاني بشدة من آثار تغير المناخ. وبهذا يتم تمكين هذه المجتمعات من إدارة أنظمتها البيئية والمساهمة في التخفيف من آثار تغير المناخ.
لا يمكن، بطبيعة الحال، إغفال أهمية حملات التوعية والتثقيف في تشجيع المشاركة في هذه الجهود. حيث يمكن أن تساعد هذه الحملات على خلق شعور بالانتماء وعلى تعزيز العدالة البيئية من خلال تسليط الضوء على الآثار المتباينة للتغير المناخي على المجتمعات المختلفة. ولضمان تحقيق الاستفادة القصوى من هذه الحملات يجب على الحكومة وعلى قادة المجتمعات المحلية معالجة الحواجز الاجتماعية والقانونية والاقتصادية التي تعيق المشاركة البنّاءة للمجتمعات المهمشة.
تهدف رؤية الأمير محمد بن سلمان إلى تحقيق تنمية وطنية مستقبلية تعطي الأولوية لحقوق المرأة. سيتطلب تحقيق هذه الرؤية، من بين ما يتطلب، تعزيز المساواة بين الجنسين وتحقيق العدالة وتمكين المرأة وإشراكها إشراكاً حقيقياً في جهود حماية البيئة. وكلما زاد الاهتمام باحتياجات المرأة وبما تقدمه النساء من وجهات نظر فيما يخص برامج التغير المناخي، تمكنت المملكة من تسخير إمكانات جميع سكانها لمعالجة هذه القضية العالمية.
يمكن للمنظمات الدولية والحكومات الأجنبية أن تساهم في دعم جهود المملكة العربية السعودية بتقديم التدريب التقني والخبرات وأنشطة بناء القدرات. ويمكنها أيضاً أن تتعاون مع المجتمعات المحلية والسكان المهمشين لضمان وصول أصواتهم إلى السلطات المحلية ومراعاة احتياجاتهم عند اتخاذ القرارات السيادية. وعلى سبيل المثال، أطلقت بعض المنظمات الدولية، مثل البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، بعض المبادرات الرامية لتعزيز جهود التكيف مع المناخ وبناء قدرات المجتمعات الهشة في المنطقة. ويمكن دمج هذه الجهود الدولية في البرامج الوطنية بشكل يضمن تحقيق نتائج أكثر تماهياً مع متطلبات التكيف المناخي.
الخاتمة
تتطلب مكافحة التغير المناخي بشكل فعال في السعودية أن تضع الحكومة الفئات المهمشة من السكان على رأس أولوياتها، وأن تطرح منهجية شاملة تضمن لهم الحماية القانونية والخدمات الاجتماعية وظروف العمل المناسبة. وعلى الحكومة أن تشحذ إرادتها السياسية من خلال توفير خطط الدعم الاجتماعي والاقتصادي وتخصيص الموارد المالية المناسبة لضمان نجاح هذه البرامج بينما تتعاون المنظمات الدولية متعددة الأطراف والحكومات الأجنبية من خلال تقديم الدعم الفني وبرامج التدريب.
لتحقيق مستقبلٍ عادلٍ ومستدامٍ في المملكة العربية السعودية ينبغي إطلاق حملات تثقيف وتوعية مصممة خصيصاً لتحفيز المشاركة النشطة للمجتمعات المهمشة في جهود حماية البيئة. وفي نفس الاتجاه، ينبغي على الدولة أن تتبنى مبادئ المشاركة والاحتواء في كل ما تتخذه من إجراءات لتخطي الحواجز الاجتماعية والاقتصادية وتعزيز النهوض بالتنمية المستدامة.
الحقيقة أن رحلة المملكة العربية السعودية نحو تحقيق استراتيجية عادلة ومستدامة للتكيف مع التغير المناخي والتخفيف من آثاره لا يمكن أن تنطلق إلا من محطة التحول إلى المشاركة المجتمعية الشاملة.
الحفاظ على أهوار بلاد الرافدين في العراق في مواجهة التحديات المناخية
زينب مهدي
تعتبر مستنقعات بلاد ما بين النهرين، والمعروفة أيضاً بأهوار جنوب العراق أو الأهوار العراقية، واحدة من مواقع التراث العالمي المسجلة لدى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو)، والتي أشارت إلى أن “الأهوار منطقة فريدة، باعتبارها أكبر منطقة في العالم تضم أنظمة دلتا داخلية، في بيئة حارة وقاحلة.”
زينب مهدي
ولكن، ارتبط ذكر الأهوار مؤخراً بعناوين إخبارية قاتمة مثل ” الموت في الأهوار”، وذلك بسبب الظروف المتدهورة للمنطقة التي تهدد سُبُلَ عيش كافة أنظمتها البيئية ومجتمعاتها التي تكافح كفاحاً مريراً من أجل البقاء. وتقدر وزارة الموارد المائية في العراق أن ما يقارب 25 في المئة من احتياطي المياه العذبة بالبلاد مُعَرَّض للنضوب خلال السنوات العشر القادمة، وهو ما من شأنه أن يضع الأهوار على حافة التهلكة.
ونظراً لفداحة هذه النبوءة، فإن رفع الوعي بالوضع الحالي لمنطقة الأهوار العراقية يجب أن يكون على رأس أولويات الحكومة العراقية التي يتحتم عليها وضع خطط التدخل العاجل التي قد تحتاجها هذه المنطقة في السنوات القادمة، خاصة مع الارتفاع غير المسبوق في درجات الحرارة خلال أشهر الصيف.
يهدف المقال التالي إلى تقديم ملمحٍ عامٍ وتحليلٍ مفيدٍ لأوضاع الأهوار العراقية، يركز على حاضرها وعلى ما تعرضت له من تدمير عبر التاريخ العراقي المعاصر، فضلاً عن مناقشة موجزة للمشاريع الرئيسة المزمع تنفيذها للحفاظ على الأهوار ولا سيما مبادرة مياه الصرف الصحي المسماة “جنة عدن في العراق”.1
تطور الأهوار العراقية
تتكون منطقة الأهوار من سبعةِ مواقع: ثلاثةِ مواقعٍ أثرية، وأربعِ مناطقٍ مستنقعات رطبة في جنوب العراق. وتشكل مدن أور، والوركاء، وتل أريدو، جزءاً من بقايا المدن السومرية والمستوطنات التي تطورت في جنوب الهلال الخصيب بين القرنين الرابع والثالث قبل الميلاد. وتُعرف مناطق المستنقعات الرطبة الأربعة في الأهوار باسم الحويزة، وشرق الحمر وغرب الحمر والأهوار الوسطى، ويغذي نهري دجلة والفرات كافة مستنقعات منطقة الأهوار.
بدأ تدمير منطقة الأهوار العراقية بتجفيف بعض المناطق بهدف التنقيب عن النفط في جنوب العراق، حيث شهدت خمسينات القرن العشرين بداية عمليات اكتشاف النفط في المنطقة، ولكن الإنتاج على نطاق واسع لم يبدأ إلا في سبعينات القرن ليصل إلى ذروته في عام 1979. وفي الفترة ما بين 1980 و1988، تعرضت منطقة الحويزة الحدودية ومنطقة الأهوار الوسطى الواقعة بين نهري دجلة والفرات لأضرارٍ جسيمة بسبب الحرب العراقية الإيرانية. وفي المرحلة التي تلت حرب الخليج في عام 1991، أطلقت حكومة الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين حملة واسعة النطاق لتجفيف الأهوار معللة ذلك بأسبابٍ اقتصادية. ولكن العديد من المصادر يؤكد أن إصرار الرئيس صدام حسين على تجفيف الأهوار كان ينبع من رغبته في الانتقام من سكانها الذين اتهمهم بالخيانة وقرر حرمانهم من منطقة مثالية للاختباء. وكان الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش الأب قد ” شجع الأكراد والشيعة على التمرد” ضد صدام حسين بعد أن هزمت قوات التحالف التي تقودها الولايات المتحدة الأمريكية الجيش العراقي في مارس 1991. ولكن الولايات المتحدة لم تقدم لهؤلاء المتمردين الدعم العسكري اللازم لإنجاح تمردهم ما ساعد صدام حسين على إعادة تجميع حرسه الثوري وإرسال طائراته الحربية لقتل عشرات الآلاف من المدنيين. والتجأ متمردو الشيعة على وجه الخصوص إلى الأهوار التي تقلص حجمها إلى أقل من 10 في المئة من مساحتها الأصلية بسبب حملات التجفيف. ووصف برنامج الأمم المتحدة للبيئة عمليات التجفيف تلك على أنها أسوأ كارثة بيئية تسببت بها عوامل بشرية في القرن الماضي.
استمر الوضع كما هو حتى حرب العراق في عام 2003، عندما بدأت الجهود المحلية لإعادة غمر بعض أجزاء الأهوار. وعلى الرغم من أن استعادة الأجزاء المتبقية كان بطيئاً، إلا أن العام 2007 شهد إعادة غمر ما يقرب من 70 في المئة من المستنقعات.
غير أن عمليات ترميم وصيانة المناطق المستعادة تعرضت خلال السنوات الأخيرة إلى معوقات كبيرة بسبب انخفاض منسوب المياه نتيجة بناء السدود عند منابع وروافد الأنهار داخل العراق وخارجه في بلدان المنبع، وبسبب سوء إدارة الموارد المائية بشكل عام وتدهور نوعية المياه والتغير المناخي. وقد أجبر انخفاض منسوب المياه عرب الأهوار على الهجرة إلى المناطق الحضرية المجاورة، مثل مدينة البصرة الجنوبية، بحثاً عن سبل العيش. ولكن عمليات الهجرة لم تكن سهلة، حيث إن الانتقال إلى المناطق الحضرية يُعَرّض المهاجرين لنوع جديد من التعقيدات والصراعات خاصة فيما يتعلق بقدرتهم على الحصول على رأس المال المادي والاجتماعي الذي يحتاجونه، والذي قد يؤدي نقصه لإعاقة تلقيهم الخدمات والحقوق الضرورية التي تكفل لهم سبل العيش الكريمة.
لكن، ولحسن الحظ أعلنت الحكومة العراقية، في يوليو/تموز 2013، عن مبادرة إنشاء أول حديقة بيئية وطنية في البلاد في منطقة الأهوار. وفي 2017 أعلنت وزارتي الموارد المائية والبيئة أنهما لا تزالان تعملان بنشاط على تنفيذ هذه المبادرة وأنهما تكرسان الموارد المائية التي تحتاجها تلك الحديقة كجزء من خطة إدارة الموارد المائية في البلاد والتي تمتد على مدار 25 عاماً.2
بعد بضع سنوات اقترحت الحكومة العراقية أن تكون الأهوار، وكذلك بعض المواقع الأثرية الواقعة حول الجزء المجفف منها، مواقعاً للتراث العالمي. ووافقت اليونسكو على هذا الاقتراح في أوائل يوليو /تموز2016، بشرط أن يقدم العراق خطط إدارة جيدة للمنطقة تأخذ بعين الاعتبار محدودية إمدادات المياه بها. والحقيقة أن إعلان الأهوار موقعا من مواقع التراث العالمي سيضمن بشكل أو بآخر الحفاظ على المناطق المستعادة في الأهوار للأجيال القادمة خاصة أن الحكومة العراقية هي التي تقدمت بالاقتراح طواعية.
لكن وبغض النظر عن هذه التطورات الإيجابية، فإن الأهوار العراقية تتعرض لتهديد كبير في هذا اليوم وهذه الساعة. وقد أشار جاسم الأسدي، المدير الإداري لمجموعة ” طبيعة العراق” البيئية، في مقابلة أجراها، إلى عدد من العوامل الهامة المسؤولة عن تدهور منطقة الأهوار والتي تتمثل في بناء السدود عند منابع الأنهار والتغيرات المناخية وغيرها.3
بناء السدود عند منابع الأنهار
يعتبر بناء السدود عند منابع الأنهار واحداً من أخطر العوامل وأشدها ضرراً على مستويات المياه في الأهوار العراقية. حيث حبست السدود التي أقامتها إيران وسوريا وتركيا مياه نهري دجلة والفرات وغيرهما من الأنهار التي تغذي الأهوار على مدى سنوات طويلة. وتؤدي عمليات التبخر إلى تفاقم المشكلة خاصة خلال أشهر الصيف الحارة عندما يؤدي ارتفاع درجات الحرارة إلى استنزاف مخزون المياه.
على الرغم من أن العراق قد شارك في العديد من المفاوضات مع جيرانه عند المنبع للسماح بتدفق المزيد من المياه عبر حدوده، ولكن الوضع لا يبدو مبشراً. أما بالنظر إلى المستقبل فإن تسوية حصص المياه من خلال الاجتماعات الفنية على مستوى الوزراء سيكون أمراً بالغ الأهمية لتمهيد الطريق لاتفاقيات وتفاهمات تخدم كِلا البلدين. وقد أثبتت هذه الاستراتيجية نجاحها منذ مارس/آذار 2023، حيث التقى ممثلو تركيا والعراق أخيراً، واتفقوا على تحسين العلاقات الثنائية والتعاون في جميع القطاعات بما فيها الأمن والتجارة والاقتصاد ومعالجة شُح المياه في العراق.
التغير المناخي
تعتبر مشكلة تغير المناخ من أصعب المشاكل التي تواجه العالم حالياً. ويعد العراق خامس أكثر بلدان العالم تعرضاً لآثار التغير المناخي حيث تواجه البلاد تحديات خطيرة في هذا الشأن تتجلى في ارتفاع درجات الحرارة وانخفاض معدل هطول الأمطار وزيادة تملح التربة والعواصف الترابية المتكررة. ويعتبر العراق ومصر من أكثر بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عرضة لارتفاع مستوى سطح البحر بسبب وجود مناطق الدلتا في كلا البلدين وتحديداً دلتا نهر النيل في مصر ودلتا نهري دجلة والفرات في العراق. ومن المتوقع أن يؤدي ارتفاع مستوى سطح البحر في العراق وخاصة في محافظة البصرة إلى أن تتحول هذه المنطقة إلى مدينة عائمة تشابه مدينة فينيسيا الإيطالية. ومع الزيادة المتوقعة لكمية الفيضانات ستكثر المستنقعات المالحة وسيؤدي ارتفاع مستوى سطح البحر إلى نقل الوتد الملحي من منطقة الخليج إلى منطقة شط العرب وهو النهر الذي شكله التقاء نهري الفرات ودجلة في جنوبي العراق. وتدعم هذه التوقعات نماذج بحثية تظهر تسرب مياه البحار للأهوار، وتتنبأ بأن تدفق نهر الفرات أيضاً سينخفض. وبحسب عزام علوش، وهو مهندس ميكانيكا حركية وباحث بيئي عراقي، فإن انخفاض تدفق نهر الفرات سيؤدي إلى تسارع ارتفاع منسوب مياه البحر ما سيؤدي لحدوث فيضانات ومشاكل أخرى في البصرة العراقية وفي المدن الإيرانية الواقعة في حوض الفرات السفلي.
لقد بدأ تسرب المياه المالحة إلى الأهوار في التأثير على إمدادات المياه العذبة الضرورية للشرب، والصناعة، والري والوقاية الصحية. وفي عام 2015، ارتفعت نسبة معدلات تركيز الملوحة إلى 20.000 جزء في المليون، ما أثر سلباً على عمليات رعي الجاموس وصيد الأسماك التي يعتمد عليها السكان في كسب عيشهم. وكذلك أضر ارتفاع درجات الحرارة المصحوب بنقص هطول الأمطار (الناتج عن التغير المناخي) على موارد رزق سكان المنطقة.
يتضح من كل ما تقدم أنه يجب على الحكومة العراقية الحالية أن تضع مسألة التغير المناخي على رأس أولوياتها. في عام 2021، أعلنت حكومة الرئيس العراقي السابق برهام صالح عما أسمته “مبادرة إنعاش بلاد الرافدين”، التي وضعت عدداً من أهداف مكافحة التغير المناخي ركزت على جهود إعادة التحريج الوطنية في جنوبي وغربي البلاد (والتي تعتمد بشكل كبير على زراعة أشجار النخيل)، وعلى تحديث عمليات إدارة المياه وزيادة الاعتماد على الطاقة الشمسية. ولكن هذه الخطة الطموحة لم تسفر عن أي نتائج بنّاءة.
وفي 15 فبراير /شباط من عام 2023، أكد بيان مشترك أصدرته لجنة التنسيق العليا العراقية الأمريكية التزام الوفد العراقي بإعلان استراتيجية الحكومة العراقية الشاملة لمواجهة التغير المناخي. وفي البيان اتفق كلٌ من الولايات المتحدة الأمريكية والعراق على المسارعة في تنفيذ مشاريع احتجاز الكربون وتحقيق صفر حرق روتيني للغاز بحلول 2030، والوفاء بتعهد الميثان العالمي خاصة وأن العراق تحتل المركز الثاني في قائمة أعلى الدول حرقاً للغاز على مستوى العالم.
بالإضافة إلى ذلك ناقش الوفد العراقي مع نظيره الأمريكي خطط توسيع برامج التغير المناخي في العراق، حيث قدمت الولايات المتحدة الأمريكية للعراق ما يزيد عن 1.2 مليار دولار كمساعدات إنمائية خلال السنوات الخمس الماضية. وركزت اللجنة بشكل خاص على الحاجة لتطوير مشاريع المزارع الشمسية وإنشاء إطار عمل تنظيمي للحصول على التمويل اللازم لدعم مجالات الطاقة المتجددة. وعلى الرغم من أنه يصعب التكهن بمدى النجاح الذي حققته هذه المقترحات إلا أن إعطاء خطط مكافحة التغير المناخي الأولوية سيكون مسألة حاسمة في الحد من تعرض العراق لآثار هذا التغير وتعزيز قدرة البلاد على التكيف.
وبالإضافة إلى تغير المناخ، يسهم سوء الإدارة مساهمةً لا يُستهان بها فيما يحدث لمنطقة الأهوار من تدهور، فاستخدام تقنيات الري التي عفا عليها الزمان، وانعدام الاستثمار في البيئة التحتية يؤدي إلى هدر وتلوث الموارد المائية المحدودة للعراق الأمر الذي يدفع الأوضاع من سيء إلى أسوأ.
ومع كل ذلك، لا ينبغي هنا أن نغفل الجهود التي بُذِلت على مدار السنين، خاصة في منطقة الأهوار، على يد المنظمات المحلية العاملة في العراق، للتخفيف من حدة كل ما أشرنا إليه من مشكلات. وإحدى المبادرات الهامة حالياً هي مشروع ” جنة عدن في العراق” وهو مشروع لتنقية مياه الصرف الصحي ترعاه منظمة “طبيعة العراق” غير الحكومية التي تُعْنَى بحماية الأهوار، ومعهد تقنيات البيئة الموجود في كل من الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا.
بحسب ميريديل روبنستاين، مديرة المشروع، فإن مبادرة ” جنة عدن في العراق” ستقدم لمنطقة الأهوار في جنوبي العراق ما تحتاجه من تجديد بيئي وثقافي.4 ويتكون المشروع من جزئين رئيسين أولهما، ويمثل ثلث المشروع تقريباً، يُعنى باستعادة الأراضي الرطبة في الأهوار والحفاظ عليها، أما ثانيهما، وهو يمثل ثلثي المشروع، فهو التصميم الثقافي للمنطقة. وقد اكتملت حالياً جهود البناء التي تُشَكِّل الثلث الأول من المشروع، ومازال العاملون ينتظرون تلقي التمويل البالغ 2 مليون دولار لاستكمال العمل على الجانب الثقافي.
سيضمن المشروع، الذي يغطي مساحة تصل إلى 29.500 متر مربع، إعادة بناء 10.000 متر مربع من الأراضي الرطبة باستخدام التقنيات المستدامة لإعادة تدوير مياه الصرف الصحي. حيث سَتُعاَلج مياه الصرف الصحي بطريقة التدفق تحت السطحي التي تزيل الملوثات وتستغل البكتريا الموجودة في التربة لتحويل المواد العضوية إلى المعادن والعناصر الغذائية الضرورية لنمو النباتات.
أما الجانب الثقافي للمشروع فسيحتوى على عدد من المشاريع الفنية التي ستستخدم في الحديقة البيئية المُزْمَع إنشاؤها في الأهوار ومنها:
- استخدام مخططات وتصميمات مُسْتوحاة من طُرُز الورود التي تميز أغطية الأعراس في بلاد ما بين النهرين.
- الاستعانة بعناصر فنية وتصميمات بيانية ونقوش جدارية خزفية مستوحاة من الأختام الأسطوانية السومرية التي يتراوح عمرها ما بين 3000 و5000 عاماً، والمطعمة بنقوش تمثل إنخيدوانا، الكاهنة الكبرى للآلهة نانا إلهة القمر عند السومريين، وجلجامش الملك شبه الأسطوري لدولة الوركاء السومرية.
- إنشاء مباني مظللة واستراحات تُبنى باستخدام هندسة القصب، وهي تصاميم محلية تقليدية ومستدامة كانت تستخدم لما يزيد عن 7000 عام لإنشاء مساحات باردة مع السماح بمرور ضوء الشمس.
الخاتمة
بمراجعة كل ما عرضناه سابقاً من تحديات، نجد أن مشروع “جنة عدن في العراق” لن يكون في حد ذاته كافياً لاستعادة الأهوار العراقية والحفاظ عليها. والحقيقة أن عملية الحفاظ على الأهوار تحتاج إلى إرادة سياسية على الصعيدين المحلي والإقليمي. وعلى الرغم من أن محمد شياع السوداني قد وعد في مارس/آذار 2023، بالتصدي لمشكلة التغير المناخي عن طريق التحول إلى مصادر الطاقة المتجددة إلا أنه يجب أن يُعَضِّدْ هذا الوعد الكثير من الجهد والتفاني لضمان نفخ الروح في هذه المخططات بدلاً من تركها لتذبل على أغصانها كما حدث لمشروع إحياء بلاد الرافدين الذي أطلقته حكومة الرئيس السابق برهم صالح. وعلاوة على ذلك يجب على الهيئات المختصة استكمال تمويل مشروع ” جنة عدن في العراق”. أما على المستوى الإقليمي فينبغي ممارسة ضغوط سياسية مستمرة على بلدان الجوار لإقناعها بالإفراج عن حصص عادلة من المياه. وعلى الرغم من نجاح المفاوضات التي تمت بين العراق وتركيا في مارس/آذار من عام 2023، يجب على العراق أن يستمر في حماية مصالحه المائية من خلال التعاون مع مجموعة من الجهات الفاعلة غير الحكومية التي تستطيع أن تمارس ضغوطها على بلدان الجوار عندما يستدعي الأمر. لا يمكن للعراق أن يعتمد فقط على مواسم كثافة الأمطار لتأمين احتياجاته المائية خاصة في منطقة جنوب العراق حيث يندر هطول الأمطار. باختصار، في غياب وجود إرادة سياسية قوية ستزداد احتمالات اندلاع حرب مياه وهي حرب لا يستطيع العراق أن يتحمل كلفتها بعد ما عاناه من ويلات الحروب الطويلة.
ثمن التعثر في إصلاح الحوكمة المناخية في الأردن
مروان المعشّر
على الرغم من أن التحديات الاقتصادية والجيوسياسية التي يتعرض لها الأردن الآن قد تدفع به لوضع مشكلة التغير المناخي في ذيل قائمة مخاوفه الاستراتيجية، إلا إن الآثار العميقة والطويلة المدى للتغير المناخي قد تسبب تهديداً وجودياً لاستقرار البلاد إن لم تٌُعالَجْ بشكلٍ سليم.
يعتبر التغير المناخي من القضايا الشاغلة في الأردن حالياً نظراً لما تتسبب به مشكلة الاحترار العالمي من آثار ملحوظة على أجواء البلاد. ويشهد الأردن ارتفاعاً كبيراً في درجات الحرارة تصحبه موجات جفاف متواترة ومعدلات تبخر متزايدة يرافقها غير ذلك من الظواهر الجوية المتطرفة. وبما أن المملكة الأردنية لا تزال تعتمد اعتماداً كبيراً على الوقود الأحفوري المستورد، فعليها أن تسارع في اتخاذ ما يلزم من إجراءات للحد من تفاقم أخطار التغير المناخي التي قد تؤدي إلى زيادة شُح المياه وانخفاض الإنتاجية الزراعية وتنامي المخاطر الصحية. وقد يؤدي التغير المناخي كذلك، إلى التأثير سلباً على المكانة التنافسية التي تحتلها الأردن كوجهة سياحية مهمة زاخرة بالمواقع التاريخية، كمدينة البتراء، والكنوز البحرية المتمثلة في الشعاب المرجانية الخلابة. وعلى الرغم من أن مساهمة الأردن في الانبعاثات الكربونية العالمية تكاد لا تذكر، فلا شك بأن المملكة تتعرض كغيرها من دول العالم لآثار تلك الانبعاثات.
مروان المعشّر
على الرغم من كل هذه التحديات، وكون الأردن واحداً من أكثر بلدان العالم معاناةً من شُح المياه، إلا أن استجابة المملكة لهذه المشكلة حتى الآن تفتقر إلى اعتماد نهج شامل إزاء قضايا المياه والطاقة والأمن الغذائي يقدم الحلول الفعالة والقابلة للتنفيذ. وعلى الرغم من وجود خطط استراتيجية وطنية إلا إنها تفتقد الإرادة السياسية المطلوبة لوضعها موضع التنفيذ، فالحكومة، على ما يبدو، غير قادرة على طلب ما تحتاجه من التمويل الدولي المخصص لمكافحة التغير المناخي والاستفادة منه. وأخيراً ومثل غيرها من الدول، يبدو أن قرارات السياسة الخارجية الأردنية غالباً ما تعطي الأولوية للمشاكل الاقتصادية الآنيّة بدلا من التعامل مع المشاكل البيئية المؤجلة.
الإطار العام للسياسة المناخية
دعماً منها للنظم الدولية للحوكمة المناخية، وضعت الأردن مجموعة قوية من السياسات المناخية الوطنية التي ترسم مساراً طموحاً نحو تقليص الانبعاثات الكربونية وتعزيز التنمية القادرة على مقاومة آثار التغير المناخي. ولكن هذه الخطط لا تزال ينقصها زخم التنفيذ والكفاءة المؤسسية.
يتكون إطار السياسة المناخية الحالي في الأردن مما يلي
- المساهمة المحددة وطنياً 2021: المساهمة المحددة وطنياً هي أهم مرتكزات اتفاق باريس حول التغير المناخي في عام 2015، والذي أوجب على الموقعين تقديم خطط عمل خمسية توضح الأهداف والمخططات الوطنية الموضوعة للتكيف مع التغير المناخي والتخفيف من آثاره. وتعتبر المساهمات المحددة وطنياً جزءاً من النظام العالمي لمقاومة التغير المناخي، وهي تحدد مسؤوليات الدولة فيما يتعلق بتحسين إدارة الموارد أو تقليل حجم البصمة الكربونية الناتجة عن حرق الوقود الأحفوري، أو زيادة كفاءة الطاقة واستخدام مصادر الطاقة المتجددة، على سبيل المثال لا الحصر. وتستهدف المساهمات المحددة وطنياً التي قدمتها الأردن في عام 2021، خفض انبعاث غازات الدفيئة في البلاد بنسبة 31 في المئة بحلول عام 2030، وهي زيادة تقدر بحوالي 14 في المئة عن النسبة التي حددتها في عام 2015، ما يعني تحولاً هاماً عن سياسة سير العمل كالمعتاد المتبعة عادة.
- خطة التكيف الوطنية (2021): وهي خطة تضع أهدافاً واضحة ونهجاً برامجياً لمعالجة آثار التغير المناخي على قطاعات المياه والزراعة والصحة والسياحة والنظام البيئي، والمناطق الساحلية، والظروف الاجتماعية، والاقتصادية.
- السياسة الوطنية للتغير المناخي (2022): وتتضمن هذه السياسة المعدّلة حديثاً هدفاً يسعى للوصول إلى الحياد الكربوني على مستوى الاقتصاد الكلي بحلول عام 2050.
في عام 2022، أصدر الأردن رؤية التحديث الاقتصادي، وهي خطة تنموية واقتصادية كبرى جاءت لتتوج الجهود الضخمة التي قام بها مئات الخبراء في مختلف القطاعات الاقتصادية. وتحدد الخطة ثماني محركات للنمو للسنوات العشر المقبلة، تشتمل على “الاقتصاد الأخضر” و”الموارد المستدامة”. ومن الجدير بالذكر أيضا أن الأردن كان من أوائل دول المنطقة التي أصدرت خطة وطنية للنمو الأخضر في عام 2017، واتبعها بخطة عمل وطنية للنمو الأخضر في عام 2021، اشتملت على ستة قطاعات رئيسة وهي المياه والزراعة والطاقة والنقل والسياحة والصرف الصحي.
أما على المستوى التشريعي فقد أصدر الأردن لائحة نظام التغير المناخي رقم (79) لعام 2019، لضمان المشاركة الفعالة لجميع الجهات المعنية في الدولة وتحديد أدوار ومسئوليات الوزارات التنفيذية المختلفة. ومن المدهش أن هذه السياسات الحكومية قد أسفرت بالفعل عن إنتاج ما يزيد عن 20 في المئة من الطاقة الكهربائية التي تحتاجها البلاد عن طريق الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وهو إنجاز كبير لا يمكن تجاهله حتى وإن كان زخم إنتاج الطاقة البديلة قد خبا نوعاً ما بسبب تضارب الأهداف السياسية. ومن اللافت أيضاً أن الحكومة، في إطار تعاملها مع متطلبات التكيف مع التغير المناخي والتخفيف من آثاره، قد أعلنت نيتها لمعالجة قضايا اجتماعية هامة مثل قضايا المساواة بين الجنسين واحتياجات ومطالب المجموعات الهشة من سكان البلاد.
ولكي تتمكن الحكومة من تعزيز سياساتها المتعلقة بقطاعات المياه والزراعة والطاقة والنقل، وهي قطاعات محورية ومترابطة، سيتوجب عليها وعلى الجهات الفاعلة الداعمة للبيئة في الأردن أن تزيد من كفاءة وفعالية جهود حوكمة التغير المناخي وتدابير الاستجابة له على المستويين الاجتماعي والاقتصادي. وفيما يلي لمحة عامة عن كل قطاع من القطاعات الأربعة وتوصيات عامة للعمل بها.
المياه
للأردن تاريخ طويل مع شُح المياه. حيث بدأت معاناة البلاد مع نقص المياه منذ خمسينات القرن العشرين عندما بدأ تعداد السكان في التزايد المطرد والسريع. وأدى تدفق اللاجئين الفلسطينيين في عامي 1948 و1967، واللاجئين العراقيين في عام 2003، واللاجئين السوريين في بدايات عام 2011، إلى تفاقم المشكلة. ومنذ عام 2015، أصبح الأجانب و/ أو اللاجئون يمثلون ما يقرب من ثلث سكان الأردن البالغ عددهم نحو 10 ملايين نسمة، ما وضع المزيد من الضغط على الموارد المائية المحدودة للبلاد.
في تسعينات القرن العشرين، تسببت فترة جفاف طويلة في انخفاض منسوب المياه الجوفية في الأردن انخفاضاً كبيراً، الأمر الذي اضطر الحكومة، سعياً منها للحفاظ على المياه، لاتخاذِ عددٍ من التدابير الاحترازية التي شملت بناء السدود والاستعانة بتقنيات الحفاظ على المياه. لكن وعلى الرغم من هذه الجهود، لا يزال الأردن واحداً من أكثر بلدان العالم معاناة من شُح المياه حيث تقل مستويات المياه بشكل كبير عن عتبة ” ندرة المياه المطلقة”.
حاول الأردن بناء خط أنابيب يحمل المياه من البحر الأحمر إلى البحر الميت، وهي فكرة اقترحتها الحكومة لأول مرة في مطلع خمسينات القرن الماضي. وبما أن إسرائيل تقوم بتحويل معظم مياه نهر الأردن المتجهة إلى البحر الميت لتستخدمها محلياً، فقد تم تصميم مشروع يستهدف (1) توفير مصدر دائم ومستقر للمياه العذبة للأردنيين (وكذلك الفلسطينيين والإسرائيليين)، (2) توليد الطاقة الكهرومائية، (3) وقف الانخفاض الحاصل في مستوى مياه البحر الميت والناتج عن التبخر وقلة المياه العذبة الرافدة. وعلى الرغم من أن المشروع قد أُعيد إحياؤه بعد اتفاقية السلام الأردنية الإسرائيلية في عام 1994، إلا أن الحكومة الأردنية انتهى بها الأمر لإهماله في عام 2021، بسبب عدم اهتمام إسرائيل التي كانت موافقتها كدولة جوار شاطئي ضرورية لتنفيذه، وكذا بسبب بعض القضايا البيئية التي أثارتها دراسة جدوى أجراها البنك الدولي.
تحاول الحكومة، بدلاً من ذلك، بناء ناقل مياه وطني من البحر الأحمر لمناطق أخرى من البلاد. ويهدف مشروع تحلية ونقل المياه من العقبة إلى عَمان إلى توفير مصدر مستدام للمياه العذبة للأردن وحده، ولن يحاول رفع مستوى مياه البحر الميت بسبب المخاوف البيئية التي ذكرناها أعلاه. ومن خلال المشروع ستتم عملية تحلية المياه والتخلص مما ينتج عنها من محلول ملحي في منطقة البحر الأحمر، ومن ثم يتم نقل المياه المحلاة إلى عَمّان عبر خط أنابيب مخصص.
في الآونة الأخيرة، في عام 2021 تحديداَ، وقع الأردن مذكرة تفاهم أثارت الكثير من الجدل مع إسرائيل والإمارات العربية المتحدة. وبحسب المذكرة يقوم الأردن بتوليد الطاقة الكهربائية من خلال الطاقة الشمسية الوفيرة في البلاد ومن ثم يقوم ببيعها لإسرائيل التي ستستخدمها لتحلية المياه وإعادتها إلى الأردن. ومن المفترض أن تمول الإمارات العربية المتحدة هذا المشروع وأن تتعاون الدول الثلاث على تطوير مشاريع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وبناء شبكة كهرباء إقليمية.
أثارت الخطة الأردنية الإسرائيلية الإماراتية اعتراضات المجتمع المدني الأردني الذي تشكك في العديد من جوانبها خاصة فيما يتعلق بالتمويل الإماراتي والحصول على المياه من إسرائيل بدلاً من استخدام الطاقة المولدة في الأردن لتحلية المياه التي يتم الحصول عليها محلياً من البحر الأحمر. والحقيقة أن انعدام الشفافية الذي شاب المشروع قد أدى بالمجتمع المدني إلى اتهام الحكومة بتنفيذ صفقة سياسية من شأنها أن تدفع البلاد للاعتماد، ولو جزئياً، على إسرائيل في واحد من أهم قطاعات الحياة ألا وهو المياه، على الرغم من وجود بدائل محلية.
ولكن مؤيدو الصفقة يقللون من شأن عواقبها على إمدادات المياه الإجمالية في البلاد ويحاولون التركيز على ما حققه مشروع النقل الوطني من نجاح. وبغض النظر عن وجهة النظر هذه، فمن الواضح أن المشروع ليس مجرد اجتهاد تقني لحل المشكلة، بل له جوانب سياسية متعددة تعترض عليها الجهات الفاعلة في المجتمع المدني.
وبالنظر إلى أن الأردن يعاني من مشاكل مزمنة في شُح المياه، وأن معظم موارده المائية تأتيه من خارج حدوده، فيجب تصنيف مسألة المياه كأولوية أمنية رئيسة وليست مجرد تحدٍ تقني أو قطاعي، خاصة أن نقص المياه الناتج عن فترات الجفاف الطويلة كان أحد مسببات الاضطرابات الاجتماعية التي شهدها عدد من المحافظات الأردنية التي يسود فيها الاعتقاد بأن سكان عمّان والزرقاء هم أكبر المستفيدين من معظم موارد المياه الجوفية الموجودة في جنوب الأردن.
الطاقة
يستورد الأردن نحو 90 في المئة من احتياجاته من الطاقة، معظمها في هيئة النفط ومشتقاته. نتيجة لذلك تواجه البلاد مهمة صعبة في تنويع خليط الطاقة الكلي المستخدم وطنياً وفي وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.
تهدف استراتيجية الطاقة الأردنية (2020-2030) إلى زيادة نسبة الطاقة المتجددة في إجمالي الطاقة المُنْتَجَة في البلاد لتصل إلى 31 في المئة بحلول عام 2030. وعلى الرغم من أن الأردن يقترب بالفعل من تحقيق هذا الهدف بعد أن وصلت نسبة إنتاج الطاقة المتجددة إلى 29 في المئة من إجمالي الطاقة المُنتجة، فإن زخم الإنتاج قد تباطأ. وما يزيد الأمر تعقيداً أن ديون الشركة الوطنية للطاقة الكهربائية قد تجاوزت 7 مليارات دولار بسبب سنوات طويلة من تقديم الطاقة المدعمة حكومياً، وبسبب انقطاع الغاز المصري الذي كانت تشتريه الدولة بأسعار رخيصة. الحقيقة هي أن شركة الكهرباء الوطنية لم تَسعَ في أي مرحلة من المراحل لتشجيع القطاع الخاص على توليد الكهرباء وبدلاً من ذلك تحاول الشركة الآن الضغط على المواطنين وإجبارهم على دفع فواتير باهظة تساعدها في تسديد ديونها، وهو ما أدى إلى تباطؤ الجهود الحكومية الرامية لتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري. وعلى سبيل المثال، صرح مسؤول حكومي سابق بأن الدولة قد حددت سقفاً لا يمكن تجاوزه لكمية الطاقة البديلة التي يَحِقُ لكل مُوَلّد إنتاجها. وتَدّعي شركة الكهرباء الوطنية أن مشاكل هيكلة الشبكة والتوليد غير المقنن للطاقة المتجددة هي الأسباب التي دفعت الحكومة لوضع تلك الحدود. لكن، وعلى الرغم من كل ذلك، ما زالت مطالبات القطاعين الصناعي والخَدمي وكذلك مطالبات البيوت الأردنية بتوفير المزيد من الألواح الشمسية وغيرها من تدابير الطاقة المتجددة تتزايد، ويبدو أن هذه المطالبات ستستمر في التزايد مع ارتفاع أسعار الكهرباء التي تقيد القدرة التنافسية للقطاع الصناعي.
الزراعة
لطالما كان توزيع المياه قضية خلافية في الأردن. وقد حاولت الحكومة على مدار عقود من الزمان تقليل كمية المياه المستخدمة في قطاع الإنتاج الزراعي مقابل كمية المياه المستخدمة منزلياً. وعلى الرغم من أن حصة القطاع الزراعي من المياه قد تقلصت مؤخراً إلا أنها لا تزال في حدود 51 في المئة، على الرغم من أن الزراعة تسهم فقط بما قيمته 5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي للأردن، وتوظف فقط 3 في المئة من إجمالي القوى العاملة في البلاد.
وتعتبر الاستراتيجية الوطنية للزراعة المستدامة (2022-2025) أحدث سياسة حكومية للتنمية الزراعية. وتهدف هذه الاستراتيجية، التي لا تتضح حتى الآن احتمالات نجاحها من عدمه، للحفاظ على التنوع البيولوجي الحيواني والنباتي في البلاد وتشجيع الاستثمارات في القطاع الزراعي وتوفيرِ قدرٍ أكبر من الأمن الغذائي والمساعدة في خفض معدل الهجرة من المناطق الريفية لمناطق الحضر.
لكن، وكما أشرنا بالفعل، فإن التغير المناخي سيؤدي إلى تزايد نقص المياه وبالتالي من المتوقع أن ينخفض انتاج الخضروات بنسبة قد تصل إلى 50 في المئة، وهو ما يحتم على الدولة أن تسعى لتحسين أنظمة الري ومعالجة مشكلة تبخر المياه باتباع مناهج إدارية أكثر تكاملاً وكفاءة تضمن لها نجاح ما تبذله من جهود لتقليل حصة المياه التي يستهلكها القطاع الزراعي، والحد من هجرة سكان غور الأردن إلى المراكز الحضرية وهي الظاهرة التي تحاول الحكومة عكسها دون جدوى حتى الآن.
النقل
ينتج قطاع النقل وحده ما يقارب 28 في المئة من إجمالي غازات الدفيئة المنبعثة في الأردن، ولكن التدابير الموضوعة للتخفيف مما يتسبب به هذا القطاع من آثار سلبية على المناخ لا تزال متعثرة لسوء الحظ، بسبب سوء الإدارة والتخبط الذي يسم السياسة العامة للدولة والتغيير المتكرر للمسؤولين في الوزارات المعنية. على الرغم من وجود استراتيجية وطنية للنقل (2016-2030) فإن حال خدمات النقل في البلاد سيئة للغاية، حيث فشلت شبكة الطرق ونظام السكك الحديدية المتهالك في التعامل مع الزيادة الكبيرة في تعداد سكان الأردن وهو ما رتب ارتفاعا حادا في انبعاثات الغازات الدفيئة.
وعلى الرغم من اهتمام الدولة بوضع التشريعات المناسبة التي تقنن استخدام المركبات التي تعتمد على الطاقة الهجينة إلا أن سياسات الحكومات الأردنية المتعاقبة في هذا الشأن كانت متغيرة وغير مستقرة. على سبيل المثال، كانت الحكومات تارة ما تَخفِض الضرائب على هذه المركبات وتارة ما ترفعها ويرجع هذا الى حد كبير إلى عدم وجود سياسة واضحة تحدد ما إذا كانت الدولة تسعى لتعزيز الطاقة النظيفة أو تسعى لزيادة الإيرادات الحكومية. وهناك مخططات لإدخال أسطول حافلات كهربائية وأنظمة نقل ذكية، ولكن هذه الخطط لم توضع موضع التنفيذ حتى الآن.
توصيات عامة
بحسب تقرير تغير المناخ والتنمية الذي نشره البنك الدولي مؤخراً، يمكن للمخططات التنموية التي تلبي الاحتياجات المناخية في الأردن أن ترأب صدع انعدام المساواة وتحمي سُبل العيش وتعزز التماسك المجتمعي. وبالرغم من أن التغير المناخي يعتبر في الأساس مشكلة تنموية، بل ويمكن ايضاً اعتباره أحد التهديدات الأمنية التي تواجهها البلاد، إلا إنه قد يتيح للأردن فرصاً تساعدها على تنويع هياكل نموها الاقتصادي وتطبيق منظور العدالة المناخية على سياساتها التنموية البشرية والاقتصادية.
يجب على البلاد أن تعالج مشكلة التغير المناخي باعتبارها تهديداً استراتيجياً للأمن القومي وليس فقط كتحدٍ بيئي، وهو ما يستدعي الارتقاء بالقضية إلى أعلى مستويات اتخاذ القرار ودمجها في كافة القطاعات الاقتصادية والتنموية.
يعتقد كثير من الخبراء أن الأردن بحاحة إلى الدخول في شراكات مستدامة مع القطاع الخاص والمجتمع المدني لأن معالجة آثار التغير المناخي لا ينبغي أن تكون مهمة حصرية للحكومة. والحقيقة أن التجارب العالمية تدلل على الأهمية الكبرى لدور القطاع الخاص والمجتمع المدني في التصدي للتهديدات المناخية. وعلى حد تعبير أحد نشطاء المجتمع المدني “يجب تخفيف دور المجتمع المدني في دعم الأنشطة التنموية وتحفيز القطاع الخاص على المشاركة في التحول التكنولوجي وعلى تطبيق التدابير الفعالة التي تضمن الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة والمساهمة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية الصديقة للمناخ”.5
هناك أيضاً حاجة واضحة وملحة إلى تعزيز التنسيق بين الوزارات. فالتغير المناخي يعتبر تحدياً للعديد من قطاعات الدولة ويتطلب اتخاذ إجراءات جماعية يتشارك فيها عدد من الوزارات والمؤسسات العامة بما فيها وزارات التخطيط والبيئة والمياه والطاقة والنقل والصحة والتنمية الاجتماعية. وفي الوقت الحالي يبدو أن القرارات السياسية في الأردن تُوجِهُها الاحتياجات الاقتصادية بدلاً من متطلبات التكيف مع التغير المناخي والتخفيف من آثاره. وفي حين أن هذا الاتجاه قد يكون له ما يبرره في بلد فقير ذي موارد مالية محدودة مثل الأردن، إلا أن تحقيق نتائج استراتيجية طويلة المدى قادرة على مقاومة التغيرات البيئية والمناخية يجب أن يكون على رأس أولويات الدولة عوضاً عن السعي لتحقيق مكاسب اقتصادية عاجلة. ومن حسن الحظ أن مبادرة التحديث الاقتصادي الأخيرة تولي اهتماماً واضحاً لتبني منهج أكثر تكاملية. تصف شذى الشريف، الخبيرة في قضايا الاقتصاد الأخضر، وإحدى المشاركات في المبادرة، التنمية الاقتصادية المستجيبة للاحتياجات المناخية بأنها ” نهج استراتيجي يمكن أن يعزز الأمن المائي والغذائي والطاقي للبلاد”.
لا يمكن تحقيق تحول أخضر مستدام ومدعوم من القطاع العام بدون الاهتمام بقضية الاحتواء المجتمعي للفئات الضعيفة والهشة. حيث إن التحول نحو اقتصاد قادر على التكيف مع المناخ وعلى تخفيض الانبعاثات الكربونية سوف يسبب الكثير من المعاناة لبعض المجموعات الهشة من مواطني البلاد مثل العمال ذوي المهارات البسيطة والمزارعين ومستهلكي الطاقة وسكان الريف والمجتمعات الفقيرة. ويجب أن يساعد التحول على خلق فرص عمل جديدة وضمان تقديم خدمات عالية الجودة بتكاليف معقولة.
أخيراً، لا يمكن إغفال أهمية إيجاد توازن سياسي يأخذ خيارات التعاون الإقليمي بعين الاعتبار. فعلى الرغم من أن بعض القرارات التي اتخذها الأردن فيما يتعلق بالتغيرات المناخية كانت مدفوعة إلى حد كبير بالاعتبارات السياسية، ولا سيما القرارات المتعلقة بإسرائيل، إلا أن التغير المناخي لا يجب استخدامه كذريعة للترويج للقرارات السياسية غير المقبولة جماهيرياً.
من الأهمية بمكان أن يستفيد الأردن من التمويل والموارد العالمية المخصصة لمشروع مكافحة آثار التغير المناخي بطريقة تتناسب مع حجم التهديدات والعواقب المتوقعة لهذه المشكلة في المملكة. وهو ما فشلت الإدارات الحكومية حتى الآن في تحقيقه بسبب عدم قدرتها على تأمين تمويل وطني مشترك، أو صياغة المقترحات الفنية المناسبة أو إطلاق جهود دبلوماسية دولية قوية.
الخاتمة
قد لا يضع الأردن مشكلة التغير المناخي على رأس قائمة أولوياته بسبب انسياقه المتكرر إلى مسار الصراعات الاقتصادية والسياسية اليومية في الشرق الأوسط. ولكن لا يمكن تجاهل ما يمكن أن تتسبب به هذه المشكلة من تغيرات جذرية لا يمكن عكسها ولا تخفيف نتائجها على الظروف المناخية وقطاعات التنمية في البلاد. وبالتالي يجب وضع كافة القرارات السياسية والاقتصادية ومشاريع البنية التحتية في البلاد تحت مجهر التغير المناخي للتأكد من تكيفها السليم مع هذا التغير وقدرتها الاستباقية على التعامل معه. لا يزال الأردن حتى الآن في وضع متميز يهيئ له الاستفادة من الفرص التي يقدمها المجتمع الدولي للتعامل مع التغير المناخي، مع التركيز بشكل خاص على التنوع الاقتصادي. وعلى الرغم من التكلفة الكبيرة للمجهودات الاستباقية في مكافحة التغير المناخي على الصعيد المالي والاجتماعي والسياسي، فإن هذه التكلفة ستظل أقل بكثير من الثمن الذي قد يدفعه الأردن إن تراخى في اتخاذ ما يلزم من إجراءات.
يتقدم الكاتب بوافر الشكر للسيد/ باتر وردم، المتخصص الأردني في المناخ والبيئة، على ما قدمه للمقال من تعديلات وإضافات مفيدة.
هل يتمكن الاقتصاد الأخضر من إنقاذ لبنان من مهالك الانهيار الاقتصادي؟
مهى يحيى وعصام قيسي
شهد لبنان، منذ تشرين الأول/ أكتوبر 2019، مجموعة من الأزمات المتلاحقة والمُنهِكَة التي أفرزت انهياراً اقتصادياً ومؤسساتياً مُعْجِزاً، جعل إيلاء مشكلات التغير المناخي ما تستحقه من اهتمام أمراً بالغ الصعوبة. وعلى الرغم من أن هذا التقاعس قد يكون له ما يبرره، إلا إن ما رافقه من جمودٍ سياسي وسوء إدارةٍ مزمنٍ للموارد، أدى إلى مضاعفة الآثار الهدامة للتغير المناخي على لبنان، وجعل البلاد عُرْضَةً للمزيد من الأزمات المحتملة مستقبلاً. وبالتالي يجب أن تصبح مكافحة تأثيرات التغير المناخي ركيزةً أساسيةً تتمحور حولها السياسة العامة للبلاد، ويجب أن يكون التحول إلى الاقتصاد الأخضر جزءاً واضحاً من أي خطة للإنعاش الاقتصادي.
مهى يحيَ
كوارث متعاقبة ومترابطة
عصَفَت بلبنان على مدار الفترة الماضية العديد من الأزمات المتتالية والمترابطة التي تمثلت في الاضطرابات السياسية والانهيار الاقتصادي وسوء الإدارة المؤسساتي وهدر الموارد وتدهور البنية التحتية والتدفق الكبير للّاجئين السوريين. خلال العقود الماضية تفاقم العديد من هذه الأزمات، مثل عدم الاستقرار السياسي والمؤسساتي وسوء إدارة الموارد، تفاقماً تدريجياً بينما تفاقم غيرها، كالانهيار الاقتصادي بالذات، بشكل أسرع خلال السنوات الثلاث الماضية. حيث فقدت الليرة اللبنانية رسمياً 90 في المئة من قيمتها منذ خريف عام 2019، ما أدى إلى انخفاض كبير في الدخول والمعاشات التقاعدية. وفي الوقت نفسه تجاوز التضخم نسبة 200 في المئة وأصبح تقديم الخدمات أكثر صعوبةً وتقطعاً. وأدى الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي ونقص المياه إلى مضاعفة التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي يواجهها المواطن اللبناني. وكذلك تسبب تدفق مئات الآلاف من اللاجئين السوريين إلى لبنان في تصاعد الضغوط على موارد البلاد وبنيتها التحتية ما أَجَّجَ مشاعر السَّخَط الاجتماعي.
عصام قيسي
بحسب هذه المعطيات فإن معالجة الآثار الاجتماعية والاقتصادية لتغير المناخ ستمثل تحدياً كبيراً جديداً يضاف لقائمة التحديات التي يتعين على الدولة اللبنانية مواجهتها. ووفقاً لوزارة البيئة اللبنانية يمكن أن تؤدي الآثار التراكمية لمشكلة التغير المناخي إلى انخفاض الناتج المحلي الإجمالي للبنان بنسبة 14 في المئة بحلول عام 2040، وقد تزيد هذه النسبة لتصل إلى32 في المئة بحلول عام 2080. وعلى الرغم من ذلك، لا يزال إطار سياسة المناخ في البلاد قاصراً للغاية حيث لايزال سوء الحوكمة بشكل عام، وسوء إدارة الموارد بشكل خاص، يعوق اتخاذ أي إجراءات ذات مغزى بشأن التغيرات المناخية. وما لم تتم معالجة الوضع فإن معاناة لبنان الاقتصادية والاجتماعية ستتصاعد مع انعدام قدرة البلاد على تخفيف عواقب التغير المناخي.
تحديات سياقية
يعيش 89 في المئة من سكان لبنان في المناطق الحضرية التي يحتاج معظمها، وخاصة تلك التي تنتشر بها جيوب الفقر، إلى استخدام البنية التحتية والخدمات الحكومية أكثر من غيرها. ولكن، ولسوء الحظ أصبحت تلبية احتياجات تلك المناطق أكثر صعوبة نظراً لسوء إدارة الحكومة للموارد المحدودة بالفعل.
تضاؤل إمدادات المياه
ربما يكون أبرز تداعيات مشكلة التغير المناخي في لبنان هو تقلص حجم الغطاء الثلجي على المرتفعات اللبنانية، وهو ما تسببت به سنوات من الارتفاع المطرد في درجات الحرارة التي أدت كذلك إلى انخفاض كميات المياه الجوفية التي تعتبر المصدر الرئيس لمياه الشرب والزراعة في البلاد. وقد أدى هذا النقص إلى تزايد الضغوط على البنية التحتية وأنظمة إدارة المياه في لبنان، ما تسبب بدوره في زيادة تكلفة استهلاك وتوزيع المياه وانخفاض الثقة في وفرة المياه وجودتها. وفي يوليو/ تموز من عام 2021، حذر صندوق الأمم المتحدة للطفولة من أن أنظمة المياه في الدولة اللبنانية على شفير الهاوية، حيث ارتفع متوسط تكلفة 1000 ليتر من المياه التي تنقلها الشاحنات بمقدار ستة أضعاف تقريباً بين عامي 2019 و2022.
وقد أضر نقص المياه في لبنان بالإنتاج الزراعي ضرراً شديداً، حيث انخفضت مساهمة القطاع الزراعي في إجمالي الناتج المحلي للبلاد من نحو 7 في المئة في عام 1995 إلى 1.4 في المئة في عام 2021. وأدى هذا النقص إلى انخفاض غلة المحاصيل وهو ما أثر بدوره على موارد عيش المزارعين. وقد أظهرت دراسة حديثة أن المناطق الزراعية الكبرى، مثل المناطق الساحلية التي تتميز بزراعة الحمضيات وأشجار الزيتون والمناطق الجبلية التي تزرع أشجار الفاكهة الموسمية، تشهد انخفاضاً في الإنتاجية بسبب انخفاض ساعات التبريد (وهي الأوقات التي تتعرض فيها المحاصيل لدرجات حرارة مواتية) وقلة الأمطار. وتعرضت المناطق التي تعتمد على أنظمة الري في منطقة وادي البقاع، وهي المنطقة الزراعية الرئيسة في لبنان، للعديد من المشاكل بسبب استنزاف مخزون المياه الجوفية ومصادر المياه الأخرى. وأصبحت المجتمعات الزراعية في هذه المناطق تعاني من التداعيات السلبية للمشاكل المائية والتي تجسدت في عدم استقرار الإمدادات الغذائية المحلية. كما أدى انخفاض إمدادات المياه إلى خفض قدرة لبنان على توليد الطاقة الكهرومائية ما أدى إلى زيادة الاعتماد على وسائل توليد الطاقة الأقل ملائمةً للبيئة.
وقد تفاقم التأثير السلبي على المجتمعات المحلية بسبب تدفق أكثر من مليون لاجئ سوري إلى الأراضي اللبنانية. وتشير الأرقام الأخيرة إلى أن هؤلاء اللاجئين يشكلون ما بين 20 و22 في المئة من مجموع سكان لبنان. وأدت هذه الأعداد الكبيرة إلى ارتفاع نسبة استخدام مياه الشرب والمياه المخصصة للاستهلاك المنزلي بما يقارب من 20 في المئة، ورفعت كذلك الطلب على فرص العمل وعلى الموارد الشحيحة الأخرى ما أدى إلى زيادة التوتر بين المجتمعات المُضيفة وبين اللاجئين بشكل ملحوظ.
ارتفاع مستويات تلوث الهواء
ساهم سوء إدارة الموارد في لبنان في زيادة تلوث الهواء وما يترتب على ذلك من آثار صحية سلبية. وتدفع البلاد الآن واحدة من أعلى فواتير تلوث الهواء في المنطقة بنسبة تقارب 3 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي. وفي الآونة الأخيرة قدّر وزير البيئة في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية قيمة التكلفة الصحية الناتجة عن تلوث الهواء بمبلغ 900 مليون دولار سنوياً. وتعاني لبنان أيضاً من أعلى متوسط تقديري مُرَجَّح لمعدلات الوفيات المبكرة بسبب تلوث الهواء بالوقود الأحفوري. أما بالنسبة لأهم مصادر تلوث الهواء في لبنان، عدا سوء إدارة النفايات، فهي الأجهزة المُوَلِّدَة للطاقة، كمُوَلّدات الديزل، ووسائل النقل والمواصلات، كالمركبات الخفيفة بالأخص.
تتمثل سوء إدارة النفايات في لبنان في الحرق المتكرر للقمامة الذي يتم بدون معالجة سليمة وينتج عنه كميات كبيرة من المواد الكيمائية السامة. وتشير الأدلة العلمية إلى أن تعرض الإنسان لتلوث الهواء أو لمزيج من ملوثات الهواء (مثل الجسيمات الدقيقة PM2.5 وثاني أكسيد الكربون وغاز الأوزون) يؤدي إلى زيادة القابلية للإصابة بأمراض مثل الربو والسكري وأمراض القلب وسرطان الرئة والتهابات الجهاز التنفسي السفلي والولادة المبكرة.
أدى سوء تعامل الحكومة اللبنانية مع النفايات – الذي يزيده الفساد والإهمال وانعدام الكفاءة- إلى أن فَقَدَ المواطن اللبناني ثقته في القطاعين العام والتجاري، وأصبحت مشاعر اللامبالاة وعدم الاكتراث تسيطر على تصرفاته، وتدفعه للاعتراض على بناء مرافق إدارة النفايات الصلبة في المناطق السكنية بسبب الزيادة الخطيرة لعمليات حرق النفايات في العراء، وإلقاء ما يتراوح بين 80 و90 في المئة من المُخَلفات وطمرها بدون معالجة ، وبسبب الروائح الكريهة التي تُطْلقها عمليات تَخمُّر القمامة ومدافن النفايات البحرية، والفشل في معالجة المواد المرتشحة التي تنتجها مدافن النفايات.
تعتبر مولدات الديزل هي المسبب الرئيس الآخر لتلوث الهواء في البلاد، حيث يزداد استخدامها بشكل كبير بسبب نقص الكهرباء الحكومية. وتنتشر هذه المُولّدات لأن السلطات اللبنانية قد أساءت إدارة شركة الكهرباء اللبنانية، وهي مرفق الكهرباء الحكومي، لما يزيد عن ثلاثين عاماً. ولا يزال انقطاع التيار الكهربائي المتكرر يؤثر سلباً على كل شيء في الدولة من مستوى المعيشة إلى التعليم والصحة وحرية التنقل. وفي عام 2011 تعرض ما يربو على 93 في المئة من سكان بيروت لمستويات عالية من تلوث الهواء الناجم اساساً عن مُولّدات الديزل.
منذ الانهيار الاقتصادي الذي شهدته البلاد في عام 2019، ازداد هذا الوضع سوءاً. وفي الفترة ما بين نوفمبر 2021 ويناير 2022 لم تتمكن مؤسسة كهرباء لبنان من توفير أكثر من 10 في المئة فقط من احتياجات الأسرة اللبنانية المتوسطة في اليوم، ما يجعل معدل الاستقبال اليومي للكهرباء في المنزل اللبناني لا يزيد عن ساعتين يومياً. وهو ما أجبر الأسرة اللبنانية، كلٌ بِحَسْبِ دخله، على الاعتماد بشكل كبير على المُولّدات الخاصة لتعويض نقص الكهرباء.
لعل الجانب الإيجابي في هذه المشكلة، هو أن الأزمة المالية في لبنان قد أجبرت الحكومة على إنهاء نظام دعم الطاقة المكلف للغاية ما تسبب في ارتفاع أسعار الديزل إلى عنان السماء. وهذا بدوره أجبر المواطنين، الذين كانوا قد بدأوا بالفعل في الاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة مثل الألواح الشمسية، على البحث عن مصادر أرخص للطاقة. وبين عام 2021 ونهاية عام 2022، أنفق المواطن اللبناني والمنشآت التجارية المحلية ما يقرب من 350 مليون دولار على أنظمة الطاقة الشمسية المتجددة التي تصل قدرتها القصوى إلى 250 ميجا وات، بالإضافة إلى أنظمة ال 100 ميجاوات الحالية. وفي سبتمبر 2022، أصبحت تكلفة استخدام الطاقة الشمسية أقل من تكلفة استخدام مولدات الديزل بنحو 0.06 دولار لكل كيلو واط في الساعة بدون بطاريات، و0.025 دولار لكل كيلو واط في الساعة في وجود البطاريات. بالمقارنة، كان سعر المولدات 0.55 دولار لكل كيلو واط بالساعة عند احتساب التعرفة الرسمية لوزارة الطاقة.
أما الجانب السلبي لهذا التحول نحو مصادر الطاقة الخضراء وبالذات نحو الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، فهو أنه كان تحولاً عشوائياً أملاه الانهيار الذي شهدته البلاد، وبالتالي لم يحظَ بما يستحقه من الإشراف أو التنسيق من قِبَل مؤسسات الدولة. ورغم أن الألواح الشمسية تعتبر طريقة ممتازة لتوليد الطاقة دون استخدام الوقود الأحفوري إلا إن تركيبها وتشغيلها يجب أن يخضع لإشراف دقيق لتجنب المشاكل البيئية التي قد تنجم عنها. وفي نهاية دورة حياة هذه الألواح يجب التخلص منها بحرص وعناية وإلا تسببت في إطلاق مواد سامة في البيئة. علاوة على ذلك يمكن أن يتطلب تركيب الألواح الشمسية مساحات مكانية كبيرة، وقد يتسبب سوء تنظيم تلك المساحات في تدهور ودمار الغابات والأراضي الزراعية.
يعتبر نظام المواصلات في بيروت مصدراً آخر من مصادر التلوث. فهو يعتمد على المركبات التي تستخدم المصادر التقليدية للطاقة، مثل البترول والديزل، والتي تنبعث منها مستويات مرتفعة من غاز الدفيئة، وبالتالي تساهم بدورها في التغير المناخي. حيث يؤدي حرق هذه الأنواع من الوقود إلى إطلاق ملوثات ذات آثار جانبية ضارة بالصحة والزراعة، فضلاَ عن أن الاستخدام المفرط لوسائل النقل قد يؤدي إلى تدهور البيئة الحضرية، وانخفاض نوعية الحياة والإنتاجية الاقتصادية بسبب التأخيرات المرتبطة بالزحام والضغط الناتج عن ضوضاء المرور.
تزايد الحرائق البرية وعمليات ااجتثاث الغابات
يمتد سوء الإدارة في لبنان ليشمل غاباتِه أيضاً. إذ يُعد لبنان موطناً لأكبر تجمع لغابات الصنوبر في الشرق الأوسط، ولكنه حالياً يفقد ما بين 1500 إلى 2000 هكتاراً من الأراضي الغابية كل عام بسبب الحرائق البرية وعمليات اجتثاث الغابات. ومن الطبيعي أن تتعرض الغابات لبعض الحرائق البرية، ولكن عندما ترتفع درجات الحرارة إلى معدلات غير معتادة بالنسبة للمناطق الخضراء فإن هذه الحرائق تصبح أكثر تواتراً، وهو ما وصل إليه الحال في السنوات الأخيرة في لبنان الذي أصبح يعاني من أجل احتواء تلك الحرائق في ظل نقص الموارد الحاد الذي تعاني منه البلاد لرفع الوعي بهذه القضية، أطلقت وزارة البيئة، في يونيو 2022، ما أسمته “الأسبوع الوطني للوقاية من حرائق الغابات.”
دفعت الأزمات الاقتصادية الطاحنة المتلاحقة، وبالأخص أزمة الطاقة العنيفة، العديد من اللبنانيين إلى قطع الأشجار للحصول على الحطب اللازم للتدفئة، أو لبيعه وكسب المال، متجاهلين أن عمليات اجتثاث الأشجار تتسبب في تفاقم آثار التغير المناخي لأنها تحد من قدرة الغابات على امتصاص ثاني أكسيد الكربون من الغلاف الجوي وتزيد من خطر تآكل التربة والانهيارات الأرضية.
ارتفاع مستويات سطح البحر
يعيش معظم اللبنانيون في مدن ساحلية معرضة لارتفاع منسوب مياه البحر، وعلى الرغم من أن العلماء لم يتمكنوا بَعْد من تحديد مستوى هذا الارتفاع المتوقع بدقة، إلا أن منسوب سطح البحر عالمياً قد يرتفع بمقدار مترٍ أو أكثر بحلول نهاية القرن الحالي وهو ما سيتسبب في تآكل السواحل وكثرة الفيضانات وتسرب المياه المالحة وفقدان الشواطئ ونزوح السكان.
الإطار العام للسياسات المناخية
للخروج من هذه الحلقة المفرغة يتعين على القادة اللبنانيون اتخاذ إجراءات فورية لمعالجة الآثار قصيرة وطويلة المدى للتغير المناخي، وكذلك للتغلب على الاضطرابات السياسية والاقتصادية التي تعصف بالبلاد.
وبالرغم من أن الحكومة قد أنشأت لجنة مشتركة بين الوزارات في عام 2017، للتعامل مع التغير المناخي إلا أن الحاجة لمزيد من التنسيق لا تزال ملحة. ويرأس وزير البيئة لجنة التنسيق الوزاري التي تضم ممثلين معينين من عدد من الوزارات والهيئات الأخرى، ولكن حتى الآن لا يزال التنسيق العملي ضئيلاً بين أعضاء اللجنة.
يُعد لبنان إحدى الدول الموقعة على بروتوكول كيوتو (المَعني بتفعيل اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي) وعلى اتفاق باريس للمناخ. ومع ذلك، وفيما عدا المساهمة المحددة وطنياً التي يتطلبها اتفاق باريس، ليس لدى لبنان أي تشريع حقيقي وملزم لمعالجة التغيرات المناخية. وامتثالاً لبند 4.9 و4.11 من اتفاقية باريس، قدم لبنان مساهمته المحددة وطنياً المبدئية في عام 2015 وأتبعها بالنسخة المعدلة في عام 2017.
وضعت المساهمة المحددة وطنياً التي قدمها لبنان أهدافاً تدعو لدمج استراتيجيات التكيف مع التغير المناخي والتخفيف من آثاره في الجهود الوطنية لإنعاش الاقتصاد. وعلى الرغم من أن البصمة الكربونية للدولة اللبنانية تعتبر صغيرة نسبياً إلا أن المساهمة المحددة وطنياً تهدف إلى خفض الانبعاثات الكربونية بنسبة 20 في المئة بحلول عام 2030. ويُصِرّ مؤيدو هذا الهدف الطموح وغير المشروط على أن خفض الانبعاثات الكربونية سيساعد على تحسين جودة الهواء في لبنان بشكل عام.
حددت وزارة البيئة ستة عوامل تمكينية حيوية لتحقيق أهداف المساهمة الوطنية المحددة، وأكدت على أن العمل المناخي الفعّال يجب أن يستند إلى قواعد إرشادية وأنظمة حوكمة وشراكات قوية. وتشمل القواعد التمكينية الستة تحسين الحوكمة والقدرات المؤسسية وتحفيز العمليات والإصلاحات المالية وتعزيز الشراكات وإطلاق عمليات التطوير والبحث العلمي المبتكر، والدمج الشامل للمؤسسات الجندرية ومجموعات الشباب والمجتمعات الهشة، وتعزيز الرقابة والشفافية.
مع كل ذلك، لا تحصل إجراءات التكيف في لبنان على التمويل الكافي ولا يتم الإعلان عنها وتنسيقها بشكل مناسب من قِبَل الوزارات المعنية، ما يجعل متابعتها أمراً في غاية الصعوبة. ولكن وزارة البيئة قد حددت بعض الثغرات في مخططات العمل المناخي وأشارت إلى ضرورة تسريع تنفيذ تلك المخططات. وتتمثل أهم الثغرات في عدم وجود خطة استراتيجية ذات رؤية واتجاه واضح، وكذلك نقص الوعي والفهم المشترك لما يمكن تسميته بالعمل المناخي، وعدم وجود آليات تمويل تدعم الاستثمارات الخاصة، ونقص المعلومات التقنية عن التكنولوجيات المتاحة، وتشرذم المبادرات والجهات الفاعلة من خارج الدولة، وعدم تسجيل ما يُحرَز من إنجازات، وعشوائية جمع المعلومات، وغموض ما يُحرز من تقدم في اتجاه تحقيق الخطط الموضوعة. وتدل الثغرتان الأخيرتان على مدى محدودية التنسيق بين أهداف الوزارات.
ما الحل؟
يجب أن تصبح معالجة آثار التغير المناخي في لبنان أولوية رئيسة، خاصة في سياق التعامل مع الأزمات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية المتلاحقة. وسيتطلب هذا إجراء إصلاحات آنيّة عاجلة وإصلاحات أخرى متوسطة إلى طويلة المدى، على رأسها تحسين إدارة الحكومة للموارد والنهوض بقدرتها التنفيذية.
بالنسبة للبرامج قصيرة المدى، يمكن لصانعي القرار في لبنان التركيز على المبادرات محدودة التكلفة والاهتمام بتغيير السلوك المجتمعي فيما يتعلق بالعمل المناخي. ولتحقيق هذا الهدف يجب على الحكومة نشر الوعي بمخاطر التغير المناخي من خلال حملات التوعية العامة، ومن خلال إيلاء البرامج البحثية التي تشرف عليها الجامعات اللبنانية ما تستحقه من اهتمام. وعلى الدولة أيضاً أن تعمل على تحفيز المواطنين والقطاع الخاص على تبني سلوكيات مناخية مستدامة تتمثل في استخدام الأجهزة الموفرة للطاقة، والاعتماد على الدراجات في التنقل بدلاً من السيارات، أو على الأقل استخدام وسائل النقل الجماعي في السفر والتنقلات اليومية وذلك لتخفيف الانبعاثات الكربونية. بالإضافة إلى ذلك ينبغي على الحكومة تعزيز إنفاذ قوانين حماية البيئة، مثل تلك التي تمنع القطع غير القانوني للأشجار، وصياغة إطار تنظيمي شامل لمصادر الطاقة البديلة، مثل الألواح الشمسية. ومن جانبها يمكن للمؤسسات اللبنانية أن تدعم قدرة المزارعين على الصمود والتكيف مع المتغيرات المناخية من خلال تزويد المجتمعات الزراعية بكل ما تحتاجه من معرفة وأدوات وتمويل لتستمر في إنتاج المواد الغذائية بطرق مستدامة. ويمكن تحقيق هذا عن طريق مساعدة هذه المجتمعات (ربما من خلال التمويل الدولي) على امتلاك الأدوات التقنية والإمكانات المادية للحفاظ على منتجاتها الزراعية وتدريبها على استخدام تلك التقنيات بشكل صحيح. كما يمكن لمختلف المنظمات الحكومية وغير الحكومية أن تعمل معاً لتكثيف عمليات إعادة التحريج. وأخيراً يمكن أن تقوم اللجنة الوزارية المشتركة لمعالجة التغير المناخي ببذل مزيدٍ من الجهد للتغلب على التداعيات الحاصلة.
أما بالنسبة للبرامج متوسطة إلى طويلة المدى، فيجب على الحكومة أن تضع خطة إنعاش اقتصادي تتضمن سياسات خضراء، وأن تطرح الحلول المناسبة للتخفيف من الآثار السلبية المحتملة التي قد تنجم عن تنفيذ هذه السياسات في المجتمعات الأكثر هشاشة في لبنان. وفي حال نجاح هذه الجهود فإنها لن تخلق بيئة أكثر صحية ونظافة فحسب، بل إنها ستساهم أيضاً في تحقيق الاستقرار الاقتصادي للبلاد على المدى الطويل، وفي تحسين نوعية الحياة بشكل عام من خلال خلق فرص عمل جديدة وتعزيز كفاءة الطاقة والحد من الانبعاثات الكربونية. وكي يتمكن لبنان من دعم الاقتصاد الأخضر يجب على الحكومة أن تسعى للاستفادة من فرص الدعم المالي المخصصة دولياً للعمل المناخي والمشاريع البيئية. وعلى الرغم من أن المنتدى الإقليمي لتمويل المناخ قد عقد في بيروت في أيلول/ سبتمبر 2022، إلا أن البلاد لم تستفد بعد من هذه الفرصة، أو غيرها من الفرص التي أتيحت في أعقاب مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي في عام 2022.
وعلى الرغم من أن هذه المقترحات قد تبدو مغرقة في المثالية في ضوء ما تتعرض له البلاد من جمود سياسي وانهيار اقتصادي ومؤسسي إلا أن هذه السياسات قد تكون مفتاحية لتعافي البلاد على المدى البعيد.
أخيراً، تتطلب مكافحة تأثيرات التغير المناخي جهداً مجتمعياُ واسع النطاق يتمركز حول إقامة شراكات مع القطاع الخاص والمجتمع المدني والجامعات، وعلى الأخص مع المبادرات الخضراء التي يرعاها رجال الأعمال والتي تسعى لابتكار تكنولوجيا مستدامة وقادرة على التكيف مع التغير المناخي. ونظراً للتحديات الهائلة التي يواجهها لبنان فإن هذا لن يحدث إلا إن تمكنت الدولة من توفير ما تحتاجه الشركات الصغيرة ومبادرات الأعمال من برامج حاضنة وداعمة للابتكار ومن تدريب وإشراف يتمركز حول الاستدامة، وحوافز مالية وضريبية وغير ذلك من أشكال المساعدة التي تعزز نمو ونجاح تلك المشاريع والشركات.
الخاتمة
رغم أن هذه التوصيات قد لا تسفر عن نتائج فورية ملموسة إلا أنها يمكن أن تسهم بشكل كبير في تعافي لبنان وازدهاره على المدى الطويل، كما يمكن لها أيضاً أن تساعد قيادة البلاد في التغلب على أخطاء الماضي وضمان أن يلعب لبنان دوراً نشطاً في التخفيف من آثار التغير المناخي على مستوى العالم بينما يلبي احتياجاته المحلية.
السياسات البيئية الإقليمية التي تدعمها فلسطين والولايات المتحدة الأمريكية لمكافحة التغير المناخي وشُح المياه
زها حسن وماديسون اندروز وماثيو مضاعين
تتعرض دولة فلسطين إلى تحديات مناخية هائلة لا سيما فيما يتعلق بالتأثيرات المحتملة للتغير المناخي على الموارد المائية. ومن المتوقع أن تؤدي الانبعاثات الكربونية المتزايدة، إن استمرت، إلى رفع متوسط معدل درجات الحرارة السنوي في فلسطين بنحو 4.4 درجة مئوية بحلول عام 2100، وهي نسبة تضعها بين أعلى متوسطات درجات الحرارة في العالم. وبالإضافة إلى ذلك فإن انخفاض معدلات هطول الأمطار في شرق البحر المتوسط بنسبة 20 في المئة بحلول عام 2050، سيؤدي إلى ازدياد تواتر موجة الجفاف، التي تؤثر تأثيراً مباشراً على الأنظمة الغذائية، وتُفاقِم حالة الهشاشة القائمة بالفعل. ونظراً لقرب إسرائيل، وتماهي الحدود الجغرافية بين الدولة المُحتَلّة ودولة الاحتلال، فإن إسرائيل تواجه نفس هذه التحديات.
زها حسن
على الرغم من وحدة المصير المناخي الفلسطيني الإسرائيلي، إلا أن التعاون بين البلدين في مجال التكيف مع التغير المناخي والتخفيف من آثاره يكاد لا يذكر. وتَشغلُ كلٌ من دولة إسرائيل والأراضِ الفلسطينية المحتلة، مساحةً جغرافيةً صغيرةً للغاية إذا ما قارنّاها بإحدى الولايات المتحدة الأمريكية كولاية ماريلاند على سبيل المثال. وتمارس السلطة الفلسطينية ولايتها الإدارية على السكان الذين يعيشون في منطقة لا تتجاوز مساحتها ثلث الضفة الغربية (حوالي 2000 كيلومتر مربع). أما سلطة حماس في غزة فهي صاحبة القول الفصل في قطاع الأرض الصغير الذي تحكمه والذي يسكنه ما يقرب من 2.2 مليون مواطن فلسطيني. أما القطاع الساحلي فيخضع برمته لحصار كامل تفرضه إسرائيل، ولا يوجد به أي موارد مائية صالحة للشرب سواء كانت سطحية أو جوفية. ونظراً لوضع الاحتلال الإسرائيلي المستمر منذ ستةٍ وخمسون عاماً وتشرذم الهيئات الحاكمة الفلسطينية، اضطرت السلطة الفلسطينية لتقديم سيناريوهات مختلفة لحساب مساهمتها الوطنية المحددة لمعالجة التغير المناخي، ويفترض السيناريو الأول بقاء إسرائيل كدولة احتلال عسكري، أما السيناريو الثاني فيفترض أن تكون فلسطين دولة ذات سيادة كاملة (تشمل غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية). وفي المقابل قدمت إسرائيل مساهمة وطنية محددة عن قطاع يغطي ما يقرب من 24.000 كيلومتر مربع، كلها من الأراضي الفلسطينية السابقة لاحتلال عام 1948، ما يعني أن إسرائيل تتبنى خطة مستقبلية تحافظ فيها على ما احتلته من الأراضي ولا تكون بموجبها مسؤولة عن الشعب الفلسطيني.
ماديسون أندروز
في حين تبدو إقامة دولة فلسطينية أمراً مستبعداً في ظل الوضع الراهن، فقد وضعت الولايات المتحدة الأمريكية مسألة التعاون المائي بين فلسطين وإسرائيل كأولوية أولى في أدوات بناء السلام بين البلدين. ومن الضروري عند تقييم مبادرات المياه الإقليمية، خاصة تلك التي تتطلب دعماً من المانحين الدوليين، أن تنتبه الأطراف المعنية لتأثير الاحتلال الإسرائيلي على القدرات الفلسطينية، وما يعنيه ذلك من التزامات قانونية للدول المانحة، حيث إن تجاهل هذا العامل المهم من شأنه أن يرسّخ الاحتلال الإسرائيلي وهيمنته المائية بدلاً من بناء الأسس الضرورية لسلام شامل وعادل ودائم.
ماثيو مضاعين
الصراع والمنافسة على المياه في ظل التغيرات المناخية
لطالما كان التنافس على المياه عاملاً من عوامل الصراع بين إسرائيل وجيرانها العرب. ويذكر التاريخ الهجوم عام 1965، على حاملة المياه الإسرائيلية – وهو الهجوم الذي دشن حركة فتح – بهدف منع إسرائيل من تحويل مياه أعالي نهر الأردن. أما بالنسبة لإسرائيل فقد كانت المياه أيضاً هدفاً استراتيجياً من بين أهداف حربها مع العرب في عام 1967. حيث سعت حينذاك للسيطرة على المميزات المائية الاستراتيجية التي يتمتع بها جيرانها من الدول المُشاطِئِة التي تحظى بحقوق مائية في الأنهار الجارية داخل أراضيها أو على امتداد حدودها، وسعت كذلك للاستيلاء على حقوق استغلال المياه الجوفية الجبلية في الضفة الغربية. وقد استولى الجيش الإسرائيلي بالفعل على كافة مصادر المياه في الضفة الغربية، ودمر أو استولى على مضخات الري، ومنع الفلسطينيين من الوصول إلى نهر الأردن، وأوقف تطوير البنية التحتية للمياه في المنطقة، ورفض منح الفلسطينيين تصاريح لحفر آبار جديدة.
على الرغم من اعتراف إسرائيل بحقوق الفلسطينيين المائية في الاتفاق الإسرائيلي الفلسطيني المؤقت لعام 1995 بشأن الضفة الغربية وقطاع غزة والمسمى “أوسلو الثانية”، إلا إنها لم تعترف إلا بالحقوق المائية المتعلقة بالمياه الجوفية في منطقة الضفة الغربية، موضحةً أن الاتفاق ينطبق فقط على طبقة المياه الجوفية الجبلية في المناطق التي تكون فيها فلسطين من دول المُشاطَأة العليا وتتمتع بأفضلية هذا الموقع. أما بالنسبة لإطار الحقوق الفلسطينية في طبقة المياه الجوفية تلك وفي المصدرين الرئيسين الآخرين للمياه في فلسطين (تحديداً نهر الأردن وطبقة المياه الجوفية الساحلية التي تقع جزئياً تحت غزة ومصر) فقد تُرِكَت لمحادثات الوضع النهائي والتي كان يفترض أن تنتهي بحلول عام 1999. ولكن المفاوضات التي استمرت لعقود طويلة قد أعطت الفرصة لإسرائيل لاستغلال المياه العابرة للحدود بدون أي اعتبار لاحتياجات الفلسطينيين المحاصرين في قطاع غزة أو في الضفة الغربية، الذين تضاعفت أعدادهم بشكل كبير منذ تحديد مخصصات المياه في اتفاقية أوسلو الثانية قبل ربع قرن تقريباً. والحقيقة أن الاتفاق المؤقت (أوسلو الثانية) قد أضفى الشرعية على القيود السابقة التي كانت إسرائيل قد وضعتها على قدرة الفلسطينيين في الاستفادة من المياه، ما مَكَّنَ إسرائيل من الاستيلاء على 80 في المئة من المياه الجوفية في الضفة الغربية.
تدعو المساهمة المحددة وطنياً التي قدمتها السلطة الفلسطينية إلى تحسين نوعية المياه والشبكات والبُنَى التحتية التي تساهم في الحد من تسرب المياه، وإلى زيادة نسبة استصلاح مياه الصرف الصحي لتصل إلى 70 في المئة، وإعادة تأهيل 100 في المئة من الآبار والينابيع الموجودة بحلول عام 2030. لكن، ونظراً لافتقارها إلى السيطرة الفعلية على الأرض، فإن المساهمة المحددة وطنياً التي قدمتها السلطة الفلسطينية قد لا تزيد عن كونها تعبيراً عن التطلعات الوطنية الفلسطينية أكثر منها التزاماً فعلياً بتغيير السياسات. أما بالنسبة للمساهمة المحددة وطنياً التي قدمتها إسرائيل فهي لا تلبي احتياجات الفلسطينيين الخاضعين لسيطرتها العسكرية على الرغم من ادعاءاتها المتكررة بأنها مُنتِج للمياه وأنها مُبتَكرٌ رائدٌ في تكنولوجيا المياه.
المقاربات الأمريكية السابقة في التعامل مع الشُح الإقليمي في المياه
دعمت الحكومات الأمريكية السابقة المقاربات الإقليمية لمعالجة تحديات المياه التي تواجه الشرق الأوسط، وذلك للتخفيف من حدة الصراع ولوضع الأسس اللازمة لتحقيق سلام عربي إسرائيلي شامل. ولذلك فإن خطة جونستون لعام 1953، التي اقترحتها الولايات المتحدة الأمريكية، وكذلك المناقشات التي دارت بين مجموعة العمل متعددة الأطراف المعنية بالموارد المائية التي تم إنشاؤها خلال مؤتمر مدريد للسلام في عام 1991، والتي ترأستها الولايات المتحدة أيضاً، قد ركزت بشكل أساسي على الإدارة المشتركة للموارد. وبالرغم من عدم وجود اتفاق موقّع بين أصحاب المصلحة المعنيين، إلا أن اتفاقية السلام الأردنية الإسرائيلية التي تم توقيعها في عام 1994 اعتمدت في بنودها المتعلقة بالمياه على خطة جونستون.
لعل السبب في فشل الفريق العامل متعدد الأطراف (الذي توقف عمله في عام 1999 بتوقف المفاوضات الإسرائيلية الفلسطينية) هو أن الفريق لم يحرص على إشراك دول أخرى لها مصلحة في نجاح التنسيق المائي بين فلسطين وإسرائيل مثل سوريا ولبنان، اللتين أعربتا عن قلقهما بشأن التطبيع مع المحتل الإسرائيلي، الذي كان قد حظر أي مناقشة لحقوق الدول المُشاطِئة، قبل التوصل إلى اتفاقية سلام شاملة. وكما أشرنا سابقا، فإن التركيز على الإدارة المشتركة – مع استبعاد ما ينص عليه قانون المياه الدولي والقانون الدولي الإنساني عن حقوق الشعوب المحتلة أو واجبات سلطات الاحتلال نحو الموارد الطبيعية للشعوب المحتلة – كان جزءاً من اتفاقية أوسلو الثانية تحت الوساطة النرويجية.
ومع تضاؤل احتمالات التوصل إلى اتفاق سلام شامل، حرصت الولايات المتحدة الأمريكية على إلزام إسرائيل بزيادة تجارتها المائية مع الفلسطينيين من خلال دعمها لعدد مم مبادرات المياه الإقليمية في الشرق الأوسط مثل مشروع نقل المياه من البحر الأحمر إلى البحر الميت. ويتضمن المشروع بناء منشأة أردنية لتحلية المياه على البحر الأحمر، وتبادل المياه بين الأردن وإسرائيل بما يضمن توزيع المياه بشكل أكثر كفاءة في المناطق القاحلة بالبلدين، والتخفيف من انخفاض منسوب المياه في البحر الميت، وإتاحة الفرصة لإسرائيل لبيع مياهها لفلسطين، ما يساعد السلطة الفلسطينية على تلبية الاحتياجات الحالية المتزايدة للسكان الفلسطينيين الخاضعين لسلطتها الإدارية. وبالرغم من أن الكونغرس الأمريكي قد خصص مبلغ 100 مليون دولار للعمل الأولي على المشروع، إلا أن الأردن أعلن في العام الماضي عن عزمه التخلي عن المشروع بسبب عدم التزام الجانب الإسرائيلي. وربما تكون السياسة الداخلية الإسرائيلية قد لعبت دوراً في هذا التقاعس الإسرائيلي، ولكن لا يخفى على أحد أنه ليس من مصلحة إسرائيل، التي ترغب في بيع فائض مياهها للأردن، أن تسمح للمملكة بهذا القدر من الاستقلال المائي. وربما تكون إسرائيل قد قررت الاستفادة من الدعم الدولي لمبادرات نقل المياه في إنشاء محطة لتحلية المياه تطل على البحر الأبيض المتوسط على أراضيها وهو ما سيكون أكثر فائدة لها وسيمكنها من بيع فائض مياهها للأردن.
وأياً كان الأمر، يجادل النقاد بأن مشاريع المياه الإقليمية هذه تأخذ أكثر من حجمها كآليات لبناء السلام حيث إنها لا تزيد عن كونها مصدر جذب للممولين. ومن المؤكد أن الكتاب الذي أصدرته حكومة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بعنوان ” السلام من أجل الازدهار: رؤية لتحسين حياة الشعبين الفلسطيني والإسرائيلي” قد عرض استراتيجية مشابهة عندما قدم لائحة بمشاريع البنية التحتية الإقليمية التي تشمل خططاً متعلقة بالمياه والطاقة. ومع ذلك لم يتم إدراج أي مشاريع جديدة للبنية التحتية للمياه في الخطة الخاصة بالفلسطينيين على الرغم من وجود حاجة ماسة إلى منشأة جديدة لتحلية المياه في غزة، التي لا يصلح ما يقرب من 79 في المئة من مياهها للشرب، يمكنها أن تخدم الفلسطينيين بتكلفة أقل بكثير من مبيعات المياه الإسرائيلية. ومن شأن إنشاء مرفق فلسطيني على الأرض الفلسطينية أن يدعم السيادة الفلسطينية بشكل أفضل. ولكن وبموجب الخطط السابقة فإن معظم الموارد المائية المخطط توريدها للفلسطينيين سيكون مصدرها إسرائيل.
نهج الإدارة الأمريكية الحالية
تواصل إدارة الرئيس جو بايدن إعطاء الأولوية للحلول الإقليمية لمشكلة شُح المياه وما يترتب عليها من انعدام الأمن الغذائي في المنطقة من خلال آلية متعددة الأطراف تسمى منتدى النقب. وعلى الرغم من أن الأردن وفلسطين ليسا عضوين في هذا المنتدى في الوقت الراهن، إلا أن الإدارة الأمريكية ترغب بشده في إشراكهما، وتسعى لتشجيع الدعم الدولي للجهود الإقليمية التي تستهدف التكيف المناخي وتوفير الأمن المائي من خلال صندوق دعم مالي خصصته لهذا الغرض. يبقى الأمل في أن تؤدي المشاركة في هذه الآليات الإقليمية إلى محادثات سلام فلسطينية – إسرائيلية بشكل أو بآخر. وفي نفس السياق، تم تجديد مذكرة تفاهم ثلاثية بين إسرائيل والأردن والإمارات العربية المتحدة في مؤتمر المناخ COP27 الذي عقد في تشرين الثاني/ نوفمبر 2022، لتعزيز مبادرة إقليمية للتعاون في مجالات المياه والطاقة النظيفة تسمى “مشروع الازدهار”. وتنص مذكرة التفاهم التي وقعتها البلدان الثلاث على أن تبيع إسرائيل مياه البحر الأبيض المتوسط المُحلّاة إلى الأردن (أو بالأحرى تضاعف الكميات التي تبيعها بالفعل للمملكة) في مقابل أن تبيع الأردن الطاقة الشمسية التي تُمَوّلها الإمارات العربية المتحدة إلى إسرائيل. وعلى الرغم من أن مذكرة التفاهم لا تشمل الفلسطينيين إلا أنها استندت في الأصل إلى مشروع قدمته منظمة بيئية غير حكومية يقترح اتفاقية ترابط مائي – طاقي بمشاركة فلسطينية.
أما الأسباب الكامنة وراء محاولات ربط اتفاقيات المياه والطاقة المستقلة هذه ببعضها ومدى إمكانية التعويل عليها لتيسير بناء السلام مع الفلسطينيين أو مع غيرهم، فيشوبها الغموض. والحقيقة أن المبادرات الإقليمية أو المشتركة التي تشارك فيها إسرائيل لا تحظى بأي شعبية في الأردن المجاور الذي يتخوف سكانه من أن الاعتماد على الموارد الإسرائيلية قد يهدد الأمن الوطني الأردني ويقوض الحقوق والسيادة الفلسطينية.
وكما أشرنا سابقاً فإن المصلحة الإسرائيلية تقتضي أن تبيع الدولة العبرية كل فائضها المائي في الأسواق الأردنية. وعلى الرغم من إسرائيل قد ترغب في الوفاء بالالتزامات التي نصت عليها خطة المساهمة الوطنية المحددة خاصتها، والتي وعدت بالتقليل من الاعتماد على الوقود الأحفوري، إلا إنها ليست مضطرة لذلك على الإطلاق، خاصة بالنظر إلى مخزونها الاحتياطي الكبير من الغاز الطبيعي في البحر المتوسط والذي تعاقدت على بيع جزء منه للأردن.
تعتمد إسرائيل على الوقود الأحفوري لإنتاج ما يزيد على 90 في المئة من الطاقة الكهربائية اللازمة للاستهلاك المحلي، ونظراً لأن معدل استهلاك الكهرباء في إسرائيل قد بلغ 73 تيرا واط في الساعة في عام 2021 ، فإن كمية الطاقة الشمسية التي ستقدمها الأردن والتي تبلغ 600 ميغا واط لن يكون لها تأثير يذكر على هدف إسرائيل المتمثل في تقليل اعتمادها على الوقود الأحفوري بنسبة 27 في المئة بحلول عام 2030 ( بالمقارنة بعام 2015 ).لهذا، وعلى الرغم من أن الأردن بحاجة ماسة إلى المياه فإن إسرائيل ليس لديها نفس الاحتياج للطاقة الشمسية المتواضعة المتفق عليها في مذكرة التفاهم مع الأردن، وبالتالي فإن مشروع الازدهار في الحقيقة سيخلق تبعية أحادية بدلاً من أن يخلق تعاوناً ثنائياً.
الحقيقة هي أن ما ستفعله مذكرة التفاهم في نهاية المطاف هو أنها ستسمح لإسرائيل بتكبيل الأردن، الذي يعاني من ضائقة مالية ويعتمد على المساعدات الدولية، في حلقة المخططات الإسرائيلية للتكامل والتطبيع الإقليمي. ومع إعلان إدارة الرئيس بايدن – بعد توقيع مذكرة التفاهم الأولية – عن عزمها منح الأردن أكثر من 7 مليارات دولار على مدى سبع سنوات بحيث يتمكن الأردن من مواجهة تحديات نقص المياه والتغيرات المناخية، فإن الضغوط الواقعة على الملك عبد الله الثاني ملك الأردن لمواجهة المعارضة المحلية للاتفاقية ستزداد حتماً. من وجهة النظر الإسرائيلية فإن مثل هذه الاتفاقيات الإقليمية، التي تتم تحت الغطاء السياسي الأمريكي والإماراتي والأردني، تعتبر فرصة تتيح لإسرائيل – التي يصعب تخمين نواياها – طمس الحدود بينها وبين الضفة الغربية المحتلة التي قد تمر بها أجزاء من البنية التحتية المطلوبة لتوصيل الطاقة الشمسية لإسرائيل، وتوصيل المياه للأردن. وهكذا يتم تقويض السيادة الفلسطينية بينما يتم ترسيخ وتسهيل المستوطنات الإسرائيلية. مايزيد الأمور تعقيداً هو الممارسات الإسرائيلية المتمثلة في رفض منح أي تصاريح للمباني الفلسطينية، بل وتدميرها والاستيلاء على الألواح الشمسية الخاصة بالفلسطينيين، حتى تلك التي تم الحصول عليها بتمويل من الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي في المنطقة (ج) من الضفة الغربية. والمنطقة (ج) هي المساحة الوحيدة التي تحتوي على كل ما يملكه الفلسطينيون من احتياطي للبنية التحتية للمياه والطاقة، وهي أيضاً المكان الذي تتوسع فيه إسرائيل في بناء المستوطنات ما يجعل من المستحيل على الفلسطينيين تقليل اعتمادهم على الوقود الأحفوري وبالتالي على إسرائيل.
لعل أفضل نهج يمكن للولايات المتحدة الأمريكية وغيرها من الجهات المانحة أن تتبعه هو النهج الذي يتوافق مع التزامات مجلس الأمن الدولي والذي يقضي بتجنب التوسع غير الشرعي لإسرائيل. وعلى سبيل المثال، يمكن للمانحين الدوليين دعم مرافق تحلية المياه واسعة النطاق في غزة وسيناء بالشراكة مع مصر وهو ما من شأنه تلبية احتياجات غزة الحالية والمستقبلية والمساعدة في إعادة تأهيل طبقة المياه الجوفية الساحلية المشتركة مع إسرائيل. ومن ناحية أخرى يمكن للإمارات العربية المتحدة تمويل الطاقة المتجددة في الضفة الغربية والأردن التي تخدم الفلسطينيين والإسرائيليين المقيمين داخل الحدود الإسرائيلية المعترف بها. وستكون هذه المبادرات أكثر اتساقاً مع القوانين الدولية والمحاولات الإقليمية لبناء السلام عن المبيعات التجارية أحادية الاتجاه، وستكون كذلك أكثر مراعاة للحساسيات العربية.
الخاتمة
لا يمكن للحلول الإقليمية التي تستهدف مواجهة التغير المناخي وشُح المياه في المنطقة، والتي تشمل إسرائيل، أن تتجاهل السياق السياسي وتباين القِوَى. وعلى الولايات المتحدة الأمريكية وغيرها من الدول المانحة أن تسعى لتخفيف مشكلة انعدام المساواة، وذلك بأن تربط دعمها للمبادرات المحلية بمدى امتثال تلك المبادرات للقانون الدولي. سيتطلب هذا النوع من الدعم المشروط أن ينظر صناع القرار الأمريكيين إلى الفلسطينيين على أنهم ليسوا مجرد أسرى في سوق للمبيعات التجارية، وأن يكون لدى الولايات المتحدة الاستعداد الحقيقي لحشد رأس المال السياسي في خدمة بناء السلام.
مصر: المجتمعات الريفية الهشة وحوكمة الموارد في ظل شُح المياه
عمرو حمزاوي ومحمد المويلم
تغلب الطبيعة الصحراوية الجافة والبيئةُ الجدباء على معظم أراضي جمهورية مصر العربية وتَحول بينها وبين تحقيق ما تحتاجه البلاد من أمن مائي وإنتاج غذائي. وتعاني معظم أقاليم البلاد، خاصة تلك الواقعة جنوب القاهرة من قلة كميات الأمطار التي تتلقاها سنوياً.
لقد أدت هذه الطبيعة الجافة والندرة النسبية للأمطار إلى أن تقتصر المساحة الزراعية في مصر على نحو 4 في المئة فقط من إجمالي مساحة الأراضي المصرية، يتركز معظمها في دلتا نهر النيل وما حولها، وإلى أن يتحول نهر النيل إلى المصدر الرئيس، بل وتقريباً، الوحيد للري وللمياه العذبة في البلاد.
عمرو حمزاوي
على الرغم من أن اعتماد مصر على النيل قد ساعدها في التغلب على كثير من القيود البيئية وعلى إدارة أمنها الغذائي والمائي في الماضي، إلا أن السياسات الحالية للبلاد لن تكون مستدامة في مواجهة التغير المناخي والنمو السكاني المتوقع.
محمد المويلم
سيؤدي التغير المناخي إلى تفاقم أزمة شُح المياه، وتضاعف التحديات القائمة التي تواجهها الموارد والأنظمة، واستحكام حالة الهشاشة التي يعانيها المواطنين المصريين، بدرجات متباينة، في الريف والحضر. يجب على الدولة أن تعمل على إصلاح ممارساتها في إدارة المياه، وأن تتبنى حوكمة مناخية أكثر قوةً وإحكاماً لتتفادى تَعَرّض البلاد واقتصادها وأمنها البشري للأضرار الجسيمة.
التركيبة السكانية والتنمية – الزيادة السكانية وتنامي احتياجات الماء والغذاء
أدى الانفجار السكاني والتنمية الاقتصادية السريعة التي شهدتها مصر منذ تسعينات القرن الماضي إلى تصاعدٍ غير مسبوقٍ في الطلب على المياه تسبب في إنهاك الموارد المائية الشحيحة أصلاً في البلاد. فقد نما عدد سكان مصر بسرعة فائقة بلغ متوسطها نحو 2 في المئة سنوياً، بينما ارتفع متوسط الناتج الإجمالي للبلاد، رغم تعرضه لبعض التقلبات التي سببتها الصدمات العالمية، بنحو 4 في المئة.
على الرغم من المحاولات التي بذلتها الحكومات المصرية المتعاقبة للسيطرة على معدلات الإنجاب، إلا إنه من المتوقع أن يرتفع عدد سكان البلاد من 104 مليون نسمة في عام 2021، إلى 160 مليون نسمة في عام 2050. وهو ما سيضع مصر، حتى إن تمكنت من تجاوز تأثيرات التغير المناخي، تحت ضغوط مضاعفة لتوفير احتياجاتها من المياه.
لكن هذه المشكلة ليست جديدة على مصر، التي لطالما كافحت للتغلب على تداعيات الانفجار السكاني، وما تسبب به من ارتفاع صاروخي في مستويات الإجهاد المائي وانخفاض حاد في نصيب الأفراد من الموارد المائية. حيث تدنت المعدلات السنوية للموارد المائية المتجددة في البلاد، في بداية التسعينات، إلى ما دون عتبة مؤشر فالكينمارك للإجهاد المائي، ومنذ ذلك الحين تضاءل نصيب المواطن المصري من إمدادات المياه تضاؤلاً كبيراً، قد يزداد مستقبلاً ليصل إلى ما دون عتبة ” الندرة المائية المطلقة” في 2025.
ومع ذلك، فإن الزيادة السكانية ليست هي المشكلة الوحيدة. فاستهلاك المياه في المنازل وللأغراض المحلية، لا يمثل سوى نسبة ضئيلة لا تزيد عن 14 في المئة من إجمالي استهلاك المياه العذبة سنوياً في البلاد، وكذلك لا يحتاج الاستهلاك الصناعي إلا إلى نسبة ضئيلة أخرى لا تزيد عن 7 في المئة. أما حصة الأسد من إمدادات المياه الوطنية فيذهب بها القطاع الزراعي الذي يستهلك ما يقارب 79 في المئة من تلك الإمدادات على الرغم من الصِغَر النسبي لمساحة الأراضي الزراعية.
وبعبارة أخرى فإن محدودية إمدادات المياه في مصر هي نتيجة مباشِرة لسياسات امتدت على مدار عقود واستهدفت توسعة الإنتاج الزراعي في البلاد.
وقد روجت الحكومات المصرية المتعاقبة، منذ ستينات القرن الماضي، لفكرة استصلاح ما أسمته “الأرض الجديدة ” في صحراء الدلتا. وبعكس نوعية الزراعة محدودة النطاق التي انتشرت تاريخياً في أراض وادي النيل فإن زراعة الأرض الجديدة ارتبطت بإمكانية الإنتاج التجاري واسع النطاق على مساحات كبيرة باستخدام الميكنة والتقنيات الحديثة التي تستنفذ الموارد المائية الثمينة بسرعة البرق بسبب قلة خصوبة التربة عما كانت عليه في ” الأرض القديمة”.
هكذا اجتمعت التغيرات السكانية وتزايد الطلب على المياه مع تضخم القطاع الزراعي، لتنتج ممارساتِ ريٍّ غير فعالة وسياساتٍ مائية غير مدروسة أدت إلى استنزاف الموارد المائية في مصر وزادتها ضعفاً على ضعف.
وبالتالي يجب على مصر أن تسارع إلى إعادة النظر في ممارساتها المائية خاصة في ضوء ما يُتَوَقَّع من آثار فادحة لتغير المناخ على إمدادات المياه في البلاد.
تكلفة التغير المناخي على الموارد وعلى المجتمعات المحلية
على الرغم من أن القيود البيئية والسياسات الزراعية المُكلفة مائياً هي أهم مسببات شُح المياه في مصر، إلاّ أن تغير المناخ سيضع ضغوطاً إضافية على أنظمة المياه غير المستقرة في البلاد. حيث ستهدد درجات الحرارة المتطرفة ومعدلات هطول الأمطار غير المنتظمة ونوبات الجفاف المتكررة الموارد المائية المصرية تهديداً كبيراً. وبما أن النسبة الكبرى من معدلات استهلاك المياه تذهب لتلبية الاحتياجات الزراعية ورعي الماشية، فإن شُح المياه الذي يتفاقم بسبب تغير المناخ سيعوق الإنتاج الغذائي في مصر، وسَيُعَرّض أرزاق الرعاة والمزارعين المصريين للخطر.
مبدئياً، من المتوقع أن يؤدي التغير المناخي إلى تراجع معدلات هطول الأمطار في البلاد، وهي معدلات شحيحة يتركز معظمها حول ساحل البحر الأبيض المتوسط في المناطق السفلى من القطر المصري. بما أن تغير المناخ يعرقل الأنماط الجويّة ويدفع بالأمطار في اتجاه الجنوب، فقد يصبح من الصعب الاعتماد حتى على الحد الأدنى لمعدلات هطول الأمطار، وهو ما قد يكونُ مدمّراً بالنسبة لدولة مثل مصر تعاني من شح المياه وما يترتب عليه من مشاكل تؤثر على الأمن الغذائي وسُبُل العيش والموارد الاقتصادية لمزارعي الأراضي الجافة الذين يعتمدون على الري البَعْلي (المَطَري) في ري أراضيهم ورعي مواشيهم. وبالنظر إلى أن “معظم المزارعين في مصر يُصَنّفون على أنهم من أصحاب الحيازات الصغيرة، حيث يمتلك ما يزيد عن 80 في المئة منهم أقل من هكتارين من الأراضي ذات المحاصيل، بينما يمتلك 50 في المئة منهم أقل من 0.4 هكتاراً من تلك الأراضي”، فإن تغير المناخ سيُعَمِّق، لا محالة، انعدام المساواة الاقتصادية القائمة بين مزارعي الكفاف الذين يعتمدون على الأمطار اعتماداً كلياً، والمزارعين التجاريين الذين يعملون على نطاق أوسع بفضل مواردهم الكبيرة.
أما ما تشهده البلاد من تطرف في درجات الحرارة فمن شأنه أيضاً أن يعوق إمدادات المياه وأن يضر بالإنتاج الغذائي، وهو مثار قلقٍ بالنسبة لدولة شهدت عقوداً من التصاعد السريع في درجات الحرارة. حيث يتسبب تزايد حرارة الأجواء في مصر في زيادة معدلات التبخر السطحي للمياه ومعدلات النتح النباتي، وهو ما سيؤدي إلى تقلص كميات المياه المتاحة للزراعة. الواقع، أن التوقعات المناخية في مصر تبدو غير مُبشّرة بالمرة في ظل استمرار سياسة سير العمل كالمعتاد، حيث من المتوقع أن يرتفع متوسط درجات الحرارة السنوية بمقدار 2.1 درجة مئوية قبل منتصف القرن الحالي، وبمقدار 4.4 درجة مئوية قبل نهاية القرن. وسيرافق هذا الارتفاع طردياً تزايد الطلب على المياه اللازمة لري المحاصيل الزراعية، حيث ستتطلب المحاصيل الشتوية زيادة تقارب 7.1 بالمئة بحلول عام 2050، وزيادة تصل إلى 13.2 في المئة بحلول 2100. أما المحاصيل الزراعية الصيفية فستحتاج إلى زيادة تصل إلى نحو 11 في المئة من معدلات مياه الري السنوية لتتمكن من التغلب على اشتداد الحرارة.
من ناحية أخرى قد تؤدي درجات الحرارة المتطرفة إلى زعزعة استقرار سلسلة الإمدادات الغذائية ورفع أسعار الحبوب وإلحاق الضرر بالاقتصاد الريفي المُعتمِد على الزراعة والثروة الحيوانية. حيث سيؤثر ارتفاع درجات الحرارة تأثيراً سالباً على أطوال مواسم النمو وسيقلل كميات غلة المحاصيل وسيغير طبيعة الأراضي التي كانت تناسب زراعة محاصيل بعينها، وعلى سبيل المثال قد يضطر مزارعو القمح وأشجار الفاكهة الموسمية متساقطة الأوراق إلى النزوح بمزروعاتهم إلى المناطق الشمالة التي تتمتع بمناخ ألطف وتربة أكثر قابلية لإنتاج مثل هذه المحاصيل. ولا شك أن كل هذه التغيرات لن تتسبب فقط في ارتفاع أسعار الغذاء، بل قد تؤدي أيضاً إلى نقص حاد في المنتجات الغذائية. أما بالنسبة للمواشي فإن ما تتعرض له من إجهاد حراري سيؤثر على إنتاجها من الألبان وهو ما قد يؤثر بدوره على مصدر هام من مصادر الغذاء والدخل في المناطق الريفية.
باختصار، سيؤدي ارتفاع درجات الحرارة، وانخفاض معدلات هطول الأمطار، وما يصاحبهما من زياد معدلات بخر المياه السطحية، ونقص معدلات رفد المياه الجوفية، وتأثير هذه التغيرات على إمدادات المياه العذبة في البلاد إلى تغيير المشهد الزراعي في مصر تغييراً جذرياً وإلى تعطيل إنتاج الغذاء في البلاد وتعريضها لمخاطر الجفاف في العقود المقبلة.
لا شك بأن الخسائر الزراعية ستؤثر على المصريين في الريف والحضر على حد سواء. حيث كان القطاع الزراعي، في عام 2021، مسؤولاً عن تحقيق ما يقارب 12 في المئة من إجمالي الناتج المحلي المصري، والتشغيل الرسمي لما يقارب خُمس معدل القوة العاملة في مصر التي شارك نحو 55 في المئة منها في أنشطة زراعية من نوع ما.
وهكذا، وعلى الرغم من أن أصحاب الحيازات الصغيرة في المناطق الريفية سيكونون أكثر الفئات تضرراً من الخسائر الزراعية المتوقعة إلا أن المصريين في المناطق الحضرية أيضاً سيتعين عليهم التأقلم مع الأسعار الفلكية للمواد الغذائية ومع النقص الهائل في كميات المياه المتاحة للاستخدام المنزلي. ولمعالجة هذه التحديات المنهجية الصعبة سيتوجب على مصر مراجعة وتنشيط إدارتها المتقاعسة لملف المياه.
حوكمة المياه في مصر إلى أين؟
على مدار العقود الماضية تمكنت مصر من التوفيق بين فجوة العرض والطلب بين موارد المياه العذبة ومعدلات الاستهلاك المتسارعة عبر طريقتين رئيستين غير مستدامتين، أولاهما هي واردات المياه الافتراضية وثانيهما هو السحب المفرط للموارد المائية.
اعتمدت مصر في استراتيجيتها الرئيسة لتوفير المياه منذ سبعينات القرن الماضي على زيادة وارداتها من المياه الافتراضية. وتجارة المياه الافتراضية لا تعني عمليات الشراء والبيع الفعلية للمياه العذبة، بل تعني التجارة في المياه المُضْمَنَة في السلع. وبينما قد يبدو أن تكاليف الحصول على المياه بهذه الطريقة لا تزيد عن كونها تكاليف افتراضية، إلا أن التجارة الافتراضية للمياه لها نتائج ملموسة بالفعل، تتيح لدول مثل مصر أن تتجنب الإنفاق على المواد الأولية الضرورية لإنتاج وتنمية المحاصيل والسلع التي تحتاج للمياه بكثافة. وعلى ما يبدو فإن استراتيجية المياه الافتراضية تبدو رائجة على مستوى المنطقة، حيث يستورد الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ما لا يقل عن 50 مليون طن من الحبوب سنوياً منذ عام 2000، ما يوفر على المنطقة نحو 50 مليار متر مكعب من المياه العذبة التي كان من الممكن استهلاكها في ري كل هذه المحاصيل. ولوضع هذه الأرقام في منظورها، فإن هذه الكميات تصل إلى 30 في المئة من موارد المياه العذبة في المنطقة أو ما يقرب من كامل الحصة السنوية المخصصة لمصر من مياه نهر النيل. ونظرياً فإن هذه الاستراتيجية تتيح لدول مثل مصر أن تلقي بأعباء التكلفة المادية للمياه على عاتق دول أخرى بينما تحافظ هي على مواردها المائية.
على الرغم من أن هذه الاستراتيجية قد تبدو لأول وهلة فكرة حصيفة لتوفير الموارد، إلا أن هذا ليس هو الحال. الواقع هو أن زيادة واردات المياه الافتراضية هي خطة تنقصها الاستدامة وتثقلها التكاليف المادية الباهظة. وربما تكون واردات القمح التي تستوردها مصر خيرُ مثالٍ على ذلك. فعلى الرغم من أن مصر تُعَد أكبر مستورد للقمح في العالم بمعدل إنفاقٍ قدره 3.2 مليار دولار في عام 2020، إلا أن البلاد لا تزال تزرع ما يربو على 9 ملايين طن متري من القمح محلياً. وبدلاً من توفير المياه عن طريق شراء القمح من الخارج يبدو أن واردات مصر من القمح لم تؤثر بأي شكل من الأشكال على الزراعة المحلية. ويتم توجيه بعض من القمح المزروع محلياً للتوريد الإقليمي ما يثير التساؤل عن مدى كفاءة الواردات الافتراضية في تقنين استخدام المياه!
والحقيقة هي إن واردات مصر الافتراضية التي تستنزف مواردها المالية في وقت تعصف فيه الأزمات الاقتصادية بالبلاد، تحتاج إلى إعادة نظرٍ جدية.
كذلك، أدى الاعتماد على واردات القمح إلى وضع مصر تحت رحمة قوانين العرض والطلب العالمية، وهو أمر يُعَرّض الأمن الغذائي الوطني وسيادة الدولة للخطر. ولعل التقلبات الدولية التي شهدها العالم مؤخراً مثل جائحة كورونا، وما نتج عنها من عواقب اقتصادية، وكذلك الحرب الروسية على أوكرانيا، قد أظهرا بوضوح مخاطر هذه الاستراتيجية. حيث أدى اعتماد مصر على الدولتين المتحاربتين فيما يزيد عن 85 في المئة من واردات القمح إلى ارتفاع جنوني في أسعار المواد الغذائية وفي حجم التضخم الأساسي فور اندلاع الحرب، وهو ما أثر على حياة النساء والمواطنين ذوي الدخول المنخفضة أكثر من غيرهم. ولأن أكثر من 70 في المئة من المواطنين المصريين يعتمدون في غذائهم على الخبز البلدي المدعوم من الحكومة، اضطرت الدولة لطلب قرض طارئ بقيمة 500 مليون دولار من البنك الدولي لدفع ثمن واردات القمح المكلفة. والحقيقة أن اعتماد مصر على واردات المياه الافتراضية هي استراتيجية ذات حدين لأنها تضع الأمن الغذائي والاستقرار الاقتصادي للدولة في خطر. وبحلول عام 2030، من المتوقع أن يزيد اعتماد مصر على ورادات المياه الافتراضية عن اعتمادها على المياه العذبة التي مصدرها نهر النيل، ما يجعل الحاجة لإصلاح عمليات حوكمة المياه في البلاد مسألة أكثر الحاحاً.
أما الاستراتيجية المباشرة الأخرى التي تتبعها مصر منذ عقود لتلبية متطلباتها المائية وتعويض الفجوة بين استهلاكها، الذي تجاوز على مدار العقود حصصها المخصصة قانونياً، وبين مواردها المتجددة فهي السحب غير المستدام والمفرط لمواردها المائية سواء من نهر النيل أومن طبقات المياه الجوفية.
ومع ما يتعرض له نهر النيل من تهديدات بسبب الإفراط في سحب مياهه منذ سبعينات القرن الماضي، تحولت مصر إلى الإفراط في استهلاك المياه الجوفية ما أدى إلى تجفيف طبقات المياه الجوفية بسرعة تجاوزت قدرتها على استعادة طاقتها ومخزونها المائي. وقد تسبب كل ذلك في ارتفاع نسبة الإجهاد المائي من نحو 104 في المئة في عام 2000، إلى 141 في المئة في فترة تقل عن عشرين عاماً، وهي زيادة مذهلة.
على الرغم من أن هذا الاستنزاف لاحتياطات المياه غير المتجددة ربما يكون قد منح مصر بعض الوقت، إلا أن هذا الحل المؤقت له تكاليف غير متوقعة. حيث أدى الإفراط في سحب طبقات المياه الجوفية إلى زيادة تسرب المياه المالحة إلى تلك الطبقات وارتفاع درجة ملوحة التربة والإضرار بإنتاجية المحاصيل. وهو ما دفع مصر لمحاولة ترشيد استخدامها للمياه في السنوات الأخيرة.
ولأن الزراعة تستهلك أربعة أخماس المياه العذبة المسحوبة فقد بدأت مصر في مواءمة سياساتها لإدارة المياه مع استراتيجيتها للتنمية الزراعية المستدامة 2030.وتتمثل إحدى النتائج الرئيسة لهذه المواءمة في إعطاء الأولوية لإعادة تدوير واستخدام المياه الزراعية. وفي حين أن الغرض من ذلك هو الحفاظ على المياه، إلا أن إعادة تدوير المياه المثقلة بالأسمدة سيؤدي على المدى الطويل إلى تدهور نوعية المياه وملوحة التربة ما يعرض صحة المحاصيل والغلال للخطر. ومرة أخرى يمكن لهذه المحاولات حسنة النية للحد من فقد المياه أن تأتي بنتائج عكسية إن لم تتم معالجة الأسباب الجذرية لأزمة المياه.
لكن من المؤسف أن كل هذه المشاكل المنهجية في التعامل مع مشكلة المياه لم تردع مصر عن الاستمرار في مسارها الحالي. وبدلاً من التعامل مع أزمة تزايد الطلب على المياه، أصرت مصر على اللجوء إلى حلول تكنوقراطية تعتقد أنها ستضمن بها تحقيق الاستخدام الأمثل للمياه بينما تستمر إمدادات المياه غير المستدامة في التضخم. وفي حين أعلنت البلاد عن مشاريع بيئية عملاقة لا حصر لها، غير أن هذه المشاريع في الحقيقة تميل إلى ترسيخ المشكلة بدلاً من حلها.
وضعت الحكومة مسألة تحلية المياه حجر زاوية في استراتيجية حوكمة المياه طويلة الأجل من خلال تخصيص 50 مليار دولار لتحديث البنية التحتية للمياه في مصر بحلول عام 2037. وتأمل مصر أن تؤدي إضافة أربعة عشر محطة جديدة لتحلية المياه إلى منشآتها الحالية، البالغ عددها 82 منشأة، إلى زيادة كبيرة في قدرتها اليومية على تحلية المياه. وعلى الرغم من أن هذا التوسع الصناعي في إمدادات المياه في مصر قد يكون خطوة أولى إيجابية، إلا أنه لن يعالج فجوة الطلب على المياه على المدى الطويل.
لا يمكن لمصر الاعتماد بشكل حصري على ضبط وتصحيح استخدامات المياه في حل مشاكلها المائية، حيث إن تحسين الري ومعالجة مياه الصرف الصحي والمزيد من تحلية المياه ليست حلولا هيكلية لأزمة المياه في مصر. وبدلا من ذلك، يحتاج صنّاع السياسات إلى إعادة نظر جوهرية في الأهداف التي تقوم عليها استراتيجياتهم الوطنية لإدارة الموارد.
المشاكل الكبيرة تحتاج حلولاً كبيرة
إذا أرادت مصر أن تتغلب على تحديات النمو السكاني المتسارع وآثار تغير المناخ، فسيتعين عليها، عاجلاً أو آجلاً، مواجهة واقع محدودية مواردها وما يفرضه هذا الواقع من ضرورة إجراء تخفيضات كبيرة في معدلات استهلاك المياه وتقليص الحصص المخصصة للقطاع الزراعي.
من حسن الحظ أن الحلول الجيدة متاحة وقد تكون الادارة المتكاملة للموارد المائية هي الحل الأمثل بالنسبة لمصر. فاتباع نهج تكاملي في حوكمة الموارد من شأنه أن يسمح لمصر أن تستوعب مدى تداخل وترابط العلاقة بين الأمن المائي وإنتاج الغذاء وتوليد الطاقة، وأن تتصرف على أساس هذه المعرفة. على سبيل المثال، يمكن لهذا المنظور التكاملي المترابط أن يعلل التكاليف المائية التي يحتاجها استصلاح الصحراء وتحويلها لأراضٍ زراعية، بينما يوضح، في نفس الوقت، الآثار السلبية لمحاولات توسيع مصادر الطاقة المتجددة في مصر من خلال بناء واحدة من أكبر حدائق الألواح الشمسية في العالم، وما يمكن أن يترتب على ذلك من إجهاد كبير للموارد المائية التي ستتطلبها بالضرورة عمليات تبريد وتنظيف محطات الطاقة تلك. ومن خلال السماح لهذه المعادلات والمقايضات الصعبة أن توجه عمليات صنع القرار، يمكن للحوكمة التكاملية أن تقدم خريطة طريق ناجحة تسمح بإدارة أكثر فعالية للموارد.
علاوة على ذلك، وبما أن الاستخدامات الصناعية والمنزلية للمياه في مصر تمثل مجتمعة أقل من ربع الطلب الوطني على المياه، فمن الواضح أن أزمة شُح المياه في مصر هي جزئياً أزمة أنزلتها مصر بنفسها. وبالتالي، فإن الحوكمة الجيدة لأنظمة الموارد المتداخلة – التي تشمل المياه والغذاء والأراضي والطاقة – من شأنه أن يعضد الجهود المبذولة لسد فجوة الطلب على المياه في مصر مع الاستمرار في توفير الغذاء للمواطنين، واستكمال عمليات التنمية الاقتصادية، والتخفيف من حالة الهشاشة المجتمعية العامة.
بطبيعة الحال، فإن إحراز تقدم كبير على هذه الجبهة سيتطلب إرادة سياسية حقيقية وقدرة أفضل على الإدارة والحوكمة. والحقيقة أن اعتماد كثير من المصريين على الزراعة من أجل الغذاء والعمل، يضع الحكومة بين سندان الإدارة الحسنة لمواردها ومطرقة التخفيف من الهشاشة التي تعانيها المجتمعات السكانية في الريف والحضر. وعلى الرغم من عدم وجود حلول سهلة، فإن اتباع نهج تكاملي لحوكمة الموارد من شأنه أن يجهز الحكومة والمجتمع المدني بشكل أفضل لطرح الأسئلة الصحيحة وابتكار الحلول السياسية الأكثر استدامة.
العوائق الفيدرالية التي تواجه الزخم المناخي في تونس
سارة يركيس وهيلي كلاسين
تنعكس آثار التغير المناخي في تونس على الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية المتردية والتي يتأذى من أضرارها سكان المناطق الداخلية والجنوبية المهمشة تقليدياً أكثر من غيرها. وعلى الرغم من أن الحكومة التونسية تعمل على معالجة المخاوف البيئية منذ عام 1975، من خلال إصدار مجموعة واسعة من القوانين والتقارير، إلا أنها قد فشلت حتى الآن في وضع التغير المناخي على رأس أولوياتها من حيث تخصيص الموارد وحشد الإرادة السياسية. ووفقا لتقديرات الحكومة التونسية، فإن تنفيذ استراتيجية التكيف مع التغير المناخي والتخفيف من آثاره على البلاد سيتطلب تمويلا يبلغ 19.3 مليار دولار خلال الفترة 2021-2030، ويساهم البنك الدولي بما يزيد عن 11 مليار دولار من هذا المبلغ، في وقت تكافح فيه تونس لإقناع المانحين بتقديم الدعم. قد يكون الثمن الذي ستدفعه تونس لدعم استراتيجيتها المناخية ثمناً باهظاً، ولكن على المدى الطويل، يمكن أن تكون التكاليف المترتبة على آثار تغير المناخ – بما في ذلك انخفاض الإنتاج الزراعي، وتراجع عائدات السياحة، وزيادة الهجرة النظامية وغير النظامية، وارتفاع معدلات البطالة – أكثر فداحة.
سارة يركيس
على الرغم من أن بعض المراقبين يرى أن عدم استقرار الوضع السياسي في تونس يخلق ظروفاً غير مواتية لدعم مثل هذا المسعى الضخم، غير أن الأمل معقود على أن يدرك المجتمع الدولي أن معالجة مشاكل تغير المناخ في تونس قد تكون مكسباً متبادلاً للطرفين، وهو ما من شأنه أن يشجع الدول المانحة، مثل الولايات المتحدة وأوروبا، والتي تتحفظ في دعم حكومة الرئيس قيس سعيد في أعقاب انقلاب يوليو 2021، على تحقيق تغيير حقيقي في حياة الشعب التونسي من خلال دعم جهود المجتمع المدني والحكومات المحلية للتصدي لتغير المناخ ومساعدة تونس على إحراز تقدم في مواجهة أحد أكثر التحديات إلحاحاً في البلاد، وهو تحدٍ لا يقل أهمية عن ارتفاع معدلات البطالة وندرة الغذاء وسوء إدارة المياه.
هيلي كلاسين
تتراوح التحديات المناخية المُوَثّقة التي تواجهها تونس بين ندرة المياه وارتفاع درجات الحرارة وانعدام الأمن الغذائي. وبحسب البنك الدولي، تتسبب مجموعة من العوامل السياسية والجغرافية والاجتماعية في أن تكون ” تونس واحدة من أكثر دول البحر الأبيض المتوسط تعرضاً لتغير المناخ”. تعتبر السياحة والزراعة – وهما من أكبر القطاعات الاقتصادية في البلاد – أكثر القطاعات عُرضة لآثار تغير المناخ. حيث من المتوقع أن تؤثر زيادة الإجهاد الحراري وانخفاض إمدادات المياه على عمل المواقع السياحية في تونس، كما سيؤدي الانخفاض المتزايد في معدلات هطول الأمطار إلى الإضرار بالغالبية العظمى من التونسيين الذين يعتمدون في سُبِل عيشهم على القطاع الزراعي، خاصة سكان المناطق الداخلية من البلاد الذين سيكونون أكثر عرضة لمخاطر التغيرات المناخية لأنهم “يكسبون جزءا كبيرا من دخلهم من الزراعة، يتراوح بين 13.7 في المئة بين سكان تطاوين، و30.4 في المئة بين سكان القصرين، مقارنة بالمعدل الوطني البالغ 16.5 في المئة”.
لكن على الرغم من التهديدات الواضحة التي يتسبب بها التغير المناخي على الاقتصاد التونسي واستقراره، لا تزال الحكومة التونسية مترددة في إعطاء هذه القضية الخطيرة الاهتمام الذي تستحقه. حيث كشف استطلاع أجراه الباروميتر العربي مؤخراً أن 64 في المئة من التونسيين يعتقدون أن على الحكومة أن تبذل المزيد من الجهد لمعالجة تغير المناخ، ويعتقد 72 في المئة أن غياب المبادرات الحكومية يسهم في زيادة التحديات البيئية إلى حد كبير أو متوسط. ووجد استطلاع حديث أجرته مؤسسة أفروباروميتر أن 83 في المئة من التونسيين يعتقدون أن هناك حاجة إلى مزيد من القوانين المُنَظّمَة للعمل البيئي. وبالرغم من أن الحكومات المحلية ومنظمات المجتمع المدني تبادر في كثير من الأحيان لسد الثغرات الحكومية، فإن معالجة تغير المناخ بشكل مناسب يتطلب تنسيق جهود الحكومة الوطنية والحكومات المحلية والمجتمع المدني، بدعم تمويلي من المجتمع الدولي.
دور الحكومة التونسية
على الورق، أولت تونس اهتماماً كبيراً للتصدي لتغير المناخ، وكانت ثالث دولة في العالم تُدْرِج تغير المناخ في دستورها. حيث يشير دستور 2014 في ديباجته إلى “ضرورة المساهمة في الحفاظ على بيئة صحية تضمن استدامة مواردنا الطبيعية وتوريث حياة آمنة للأجيال القادمة”. ويحتوي الدستور على مادتين متعلقتين بالبيئة: المادة 44 التي تضمن الحق في المياه، وتنص على أن “الحفاظ على المياه وترشيد استخدامها واجب على الدولة والمجتمع”، والمادة 45 التي تنص على أن “تكفل الدولة الحق في بيئة صحية ومتوازنة والحق في المشاركة في حماية المناخ”. وقد حافظ دستور 2022 على الكثير من الألفاظ والصياغات التي استخدمها دستور 2014، وأشار إلى دور الحكومة في توفير مياه الشرب للجميع وفي مكافحة التلوث.
الحقيقة هي أن تونس تتقدم، في نواحٍ كثيرة، على جاراتها في المنطقة من حيث إدراكها للتحديات الوشيكة لتغير المناخ ومن حيث الاستجابة لها. فقد أنشأت الدولة العديد من الهيئات الحكومية للتخفيف من تغير المناخ، وتسعى بنشاط إلى التحول نحو الطاقة المتجددة. ومع ذلك، بالمقارنة مع جيرانها الإقليميين، تفتقر تونس إلى الموارد المالية والبشرية اللازمة لتنفيذ استراتيجيتها للتكيف مع التغير المناخي والتخفيف من آثاره. ويقدر أحد التقارير أن تونس تحتاج إلى 20 مليار دولار لتحقيق هدفها المتمثل في خفض استخدام الكربون بنسبة 46 في المئة بحلول عام 2030. وعلاوة على ذلك، فإن العديد من آثار تغير المناخ هي آثار شديدة المحلية، وتتطلب استراتيجية وطنية عامة وسياسات يتم تصميمها وتنفيذها محليا وهو ما يتطلب تبني سياسة اللامركزية التي تراجع عنها الرئيس قيس سعيد عندما ألغى منصب وزير الشؤون المحلية (وهو منصب مزدوج كان شاغله يؤدي مهام وزير الشؤون المحلية ومهام وزير البيئة في الحكومات السابقة)، وفشل في تزويد البلديات بالموارد اللازمة لمعالجة تغير المناخ على المستوى المحلي.
كما أن تونس لم تستفد بعد من الإمكانات الكبيرة لطاقة الرياح والطاقة الشمسية المتاحة. وعلى الرغم من وجود ثلاث مزارع رياح ومحطة واحدة للطاقة الشمسية في البلاد إلا أن بعض العوامل السياسية والمتعلقة بالموازنة أعاقت تحقيق الهدف الرسمي من هذه المنشآت والمتمثل في زيادة حصة الطاقة المحلية المُوَلّدة من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح من 2 إلى 30 في المئة بحلول عام 2030. وتعتبر شركة الكهرباء والغاز الحكومية (STEG) واحدة من أهم العقبات في طريق تحقيق هذا الهدف بسبب ما تتبعه من آليات بيروقراطية تتسبب في تعطيل عمليات الموافقة على المناقصات. ويشير المراقبون إلى إحجام الشركة عن السماح للقطاع الخاص بدخول سوق الطاقة، فضلا عن عدم وجود حملة إعلامية فعالة لتثقيف المجتمعات المحلية حول فوائد الطاقة المتجددة.
وتفيد مقابلات أٌجْريت مع بعض نشطاء المجتمع المدني التونسي العاملين في مجال تغير المناخ أن المسؤولين الحكوميين الإقليميين والمحليين يفتقرون إلى الإرادة السياسية والكفاءة الضرورية لتنفيذ استراتيجية فعالة لمواجهة تغير المناخ. وبينما يجتهد نشطاء المجتمع المدني في طرح حلولٍ لمشاكلهم المحلية، إلا أن تنفيذ هذه الجهود عادة ما تعرقله الحكومة المركزية، التي تُفضّل إعطاء الأولوية لقضايا أخرى. ويشير اثنان من الباحثين إلى أن “الطبيعة المجردة والبعيدة” لمشكلة التغير المناخي تجعل من الصعب على النشطاء الضغط على الحكومة من أجل التنفيذ، وبالتالي، تظل المخاوف الأكثر إلحاحا مثل البطالة والتوتر الإقليمي تحتل صدارة اهتمامات الدولة. علاوة على ذلك، كان تنفيذ الاستراتيجيات الوطنية المتعددة التي وضعتها تونس للتصدي لتغير المناخ منذ عام 2011، بطيئا للغاية، إن لم يكن معدوما، لأنه يتطلب التنسيق بين الحكومات المحلية والوطنية، والتعاون بين مختلف الوزارات المعنية، وكلا الأمرين لم يتحقق في ظل حكم قيس سعيد.
جهود المجتمع المدني والحكومات المحلية
حرص المجتمع المدني التونسي على تطوير استراتيجيات فعالة للتخفيف من آثار تغير المناخ، والتقدم بمقترحات مختلفة عن أفضل طرق التعامل مع النفايات الصلبة وكيفية توفير المياه والحفاظ على جودتها، وهما القضيتان الرئيستان اللتان حددهما التونسيون في استطلاعات الرأي العام عن أكبر المخاوف البيئية.
وبالفعل تمكنت الحركات الشعبية – مثل حركة الشباب الوطنية مانيش مصب (التي تعني أنا لست مكب نفايات) من تغيير نوعية الحوار الوطني الدائر عندما ذكّرت صانعي السياسات بأن تغير المناخ ليس قضية تجريدية بالنسبة لتونس، بل هي قضية يضعها التونسيون على رأس اهتماماتهم المتعلقة بأزمة المناخ في البلاد.
تؤدي مشكلة سوء إدارة النفايات في البلاد إلى تفشي عدم المساواة في تونس، ما يؤثر بشكل مباشر على التونسيين الذين يعيشون في المناطق المهمشة حيث تشيع مدافن النفايات، مثل أطراف البلاد والأحياء الحضرية التي تسكنها الطبقة العاملة. وبينما تجتهد منظمات المجتمع المدني في حشد المجتمع حول مشكلة النفايات الصلبة، لا يزال الناشطون يواجهون العديد من العراقيل بسبب سوء التنسيق وقلة الموارد وانعدام الإرادة السياسية على المستوى الفيدرالي. ويشكل الفساد المستشري عائقا واضحا آخر – تَجَلّى مؤخرا في قضية بارزة تتعلق بالاستيراد غير القانوني للنفايات الصلبة أسفرت عن اعتقال وزير البيئة التونسي السابق. وعلى مستوى البلديات، لا يتمتع المسؤولون بالدعم الفيدرالي الذي يحتاجونه للعمل مع المجتمع المدني لمعالجة مظالم المواطنين.
على سبيل المثال، في مدينة عقارب الساحلية، عملت البلدية مع مبادرة “مانيش مصب” لإغلاق منشأة لإدارة النفايات السامة، لكن حكومة الولاية ألغت قرار البلدية، بحجة أن البلدية لم يكن لديها تفويض. وفي بلدة المعمورة، حقق التنسيق الفعال بين الحكومة المحلية والمجتمع المدني انتصاراً كبيراً عندما تمكن من إغلاق مكب نفايات غير نظامي كان يتعدى على حدود المدينة. ولكن لسوء الحظ، ارتفعت تكاليف نقل النفايات إلى مطامر القمامة النظامية نتيجة لارتفاع أسعار الوقود، ولم تتمكن الحكومة الفيدرالية من تعويض المحليات عن هذه التكاليف. علاوة على ذلك، ذهبت جهود المواطنين لفرز القمامة سُدَىً نهاية المطاف، لأن النفايات تم تحويلها إلى موقع تديره الحكومة الفيدرالية التي لا تٌعنى بفرز القمامة التي تتلقاها. باختصار، على الرغم من أن الشراكة بين المجتمع المدني والبلدية قد أسفرت عن فوز بيئي ملموس، كان التأثير النهائي محدودا.
أثّرت قضايا مماثلة سلباً على جهود المجتمع المدني في معالجة مشكلة توافر المياه وجودتها. ومن المتوقع أن يزداد شُح المياه مع الارتفاع المتزايد لدرجات الحرارة وانخفاض معدلات هطول الأمطار الناتج عن التغير المناخي. علاوة على ذلك، تفتقر البنية التحتية للمياه في تونس إلى الكفاءة، ويفتقر توزيع الموارد المائية في البلاد إلى العدالة ما يؤدي إلى استشراء عدم المساواة على المستوى الإقليمي. ويمثل انعدام الدعم الفيدرالي مشكلة أخرى كبيرة تؤدي إلى إعاقة الجهود المحلية. وفي مدينة تطاوين الجنوبية6 ، على سبيل المثال، اهتم أحد قادة المجتمع المدني التونسي بمشكلة تسعير المياه وتمكن من تنظيم المجتمع المدني وقادة البلديات وتوجيههم لوضع اقتراح جديد لتحسين الطريقة التي تتقاضى بها المرافق رسوم المياه وقدمه إلى المجلس الإقليمي. لكنه قال إنه بدون “ضغط أو أولوية” من الحكومة الفيدرالية، ” ظل كل شيء على حاله لأن الحكومة المحلية لم يكن لها أي سلطة”.
توصيات للداعمين الدوليين
يشير الناشطون التونسيون إلى أن المشاريع التي يشارك فيها داعمون دوليون، مثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والوكالة الألمانية للتنمية الدولية، غالباً ما تحقق بعض النجاح. أما على الصعيد المحلي الداخلي فلا يمثل التخفيف من آثار تغير المناخ أولوية قصوى بالنسبة لمعظم المانحين. وعلى الرغم من أن آثار تغير المناخ تؤثر تأثيراً مباشراً على النتائج الإنمائية التي يهدف المانحون الدوليون لتحقيقها، إلا أن التصدي لتغير المناخ نادرا ما يكون عنصراً مفتاحاً في مشاريع التنمية. ويقول أمين بنيس، فيما يتعلق بنهج الاتحاد الأوروبي تجاه تونس، “يميل المسؤولون إلى التركيز على الدعم الذي تقدمه موازنة الاتحاد الأوروبي للاحتياجات قصيرة المدى للبلاد بدلا من التركيز على أجندة انتقالية خضراء ذات أهداف متوسطة إلى طويلة المدى”.
علاوة على ذلك، من المرجح أن يؤدي توطيد الرئيس قيس سعيد لسلطته على المستوى الفيدرالي إلى استمرار هذا الاتجاه. حيث لا يزال استيلاؤه على السلطة في 25 تموز/يوليو 2021، يؤثر على مستقبل الاستثمار في البلاد ويحتجز صفقة مع صندوق النقد الدولي رهينة، وكلاهما مصدران ماليان رئيسان لجهود تغير المناخ. ويتضمن قرض صندوق النقد الدولي البالغ 1.9 مليار دولار، الذي تتفاوض عليه السلطات التونسية حاليا، بنداً بشأن تغير المناخ يقول إن خطة الإصلاح الاقتصادي “ستكون قادرة على مواجهة آثار التغير المناخي والتكيف معها من خلال تشجيع الاستثمارات في الطاقة المتجددة وإدارة الأراضي والمياه والصرف الصحي وتعزيز التدابير اللازمة للحفاظ على السواحل التونسية والزراعة والصحة والسياحة”. ومع ذلك، لطالما تساهل صندوق النقد الدولي مع تونس – خاصة فيما يتعلق بسداد قروضها، وهو ما تسبب في أن يصبح العديد من الالتزامات التي تفاوضت عليها تونس مجرد وعودٍ فارغة. ولا يزال تقاعس سَعيد عن وضع مشكلة التغير المناخي على رأس أولويات البلاد عقبة رئيسة يمكن تلخيصها فيما قاله أحد النشطاء إنه: “عندما يأتي الدعم من كل اتجاه بلا نتيجة تذكر، فمن الواضح أن هناك خطأٌ ما”.7
أما بالنسبة للمنظمات الدولية التي تتطلع إلى دعم المجتمع المدني التونسي، فقد تكون مسألة التصدي للتغير المناخي واحدة من أهم سبل الدعم. وعلى الرغم من وجود تنسيق نشط ومستمر بين المجتمع المدني والحكومات البلدية لتحقيق مكاسب مناخية، إلا أن هناك حاجة إلى داعمين دوليين لتوفير المدخلات الأساسية وعلى رأسها الموارد. يستطيع المانحون استخدام قدراتهم المالية والتدريبية للمساعدة في تمكين المجتمع المدني – أولا، من خلال دعم المجتمع المدني والبلديات للتخفيف من آثار التغير المناخي وتحقيق مكاسب تعاونية، وثانيا، من خلال جَسْر الفجوة بين المجتمع المدني والحكومة المحلية والوطنية للمساعدة في رفع المشاكل والحلول المحلية إلى المستوى الفيدرالي.
يمكن أن تركز المشاريع المدعومة دوليا أولا على مشاكل إدارة المياه والنفايات، لأن معالجتها تصب في مصلحة قيس سعيد أيضا. حيث إن اهتمامه بهذه المشاكل سيُظهره بمظهر المهتم بالاستجابة لمظالم المواطنين وسيساعد على تجنب عدم الاستقرار على المدى الطويل. وقد تمكن الباحثون من ملاحظة علاقة تربط بين انتشار المظالم وبين التغير المناخي، على سبيل المثال، تسبب تغير المناخ في تسارع الهجرة من الريف إلى الحضر في تونس، ما أدى إلى تفاقم التوترات الاجتماعية حول التوظيف وقضايا أخرى. وهنا يمكن للمجتمع الدولي مساعدة المجتمع المدني والحكومات البلدية في تونس في الضغط على الحكومة الفيدرالية للتخفيف من آثار تغير المناخ والاعتراف بفوائد القيام بذلك لجميع التونسيين.
قد يكون تمكين البلديات من مواجهة تحدياتها المناخية الخاصة أحد أهم المسارات للمضي قدما. وبحسب أحد نشطاء المجتمع المدني فإن الإصلاحات اللامركزية تمنح المحليات، على الورق، نفوذاً كبيرا فيما يتعلق بحماية البيئة، كأن تمنحها سلطة فرض الضرائب على الأنشطة المُلوِّثَة، لكن هذا لا يعني أن المحليات يمكنها الاستفادة من هذه القوانين”.8
هناك مسار آخر للمضي قدما يتمثل في ضمان تمتع البرلمان التونسي الجديد، الذي انعقد في آذار/مارس، بالتفويض والسلطة والتمويل اللازم لتحقيق سياسة تغير المناخ. يجب أن يكون البرلمان قادرا على استكمال بعض التشريعات البيئية الشكلية التي كان يسعى لتمريرها، قبل أن يؤدي الانقلاب الذاتي الذي قام به قيس سعيد في تموز/ يوليو 2021، إلى تجميدها، حيث كانت هذه التشريعات تهدف إلى التنسيق بين مشاريع المجتمع المدني المتعلقة بتوزيع المياه بين المناطق الداخلية والساحلية وبين المشاريع المُمَولة دوليا لتوزيع المياه في المناطق الحضرية. يجب أن يتمتع البرلمان أيضا بتفويض لتمويل وتدريب وتمكين جهود المجتمع المدني والبلديات لتلبية الاحتياجات البيئية المحلية.
إذا فشل سعيد وحكومته في معالجة تغير المناخ، فستتفاقم الصدوع في المجتمع التونسي. وكما اتضح خلال العام الماضي، فقد انتشرت الاحتجاجات المتعلقة بالمناخ في جميع أنحاء العالم، وأثبتت تجارب البلدان الأخرى أن الاحتجاجات المناخية قد تتسع بسرعة لتشمل قضايا أخرى تهدد الأنظمة السياسية الموجودة وذلك لارتباط المناخ ارتباطا وثيقاَ بكل أجنحة المجتمع. إذا استمر سعيد في عرقلة جهود التخفيف من آثار تغير المناخ، وإذا تصاعدت نسبة الفاقة/الفقر في المجتمع (والتي أدت إلى الانتفاضة التونسية في عام 2010-2011)، فإن خطر عدم الاستقرار سيرتفع مع تزايد وَهَن الوضع الراهن.
الخاتمة
تحتاج الحكومة التونسية إلى وضع مشكلة التغير المناخي وخطط التصدي لها في صدارة جهودها المبذولة لإدارة الأزمات السياسية والاقتصادية الحالية في البلاد. حيث إن تزايد شُح المياه، واشتداد قسوة الطقس، واستنزاف المحاصيل لن يؤدي إلا إلى تفاقم هذه الأزمات. وعلى الرغم من أن جهود مواجهة آثار التغير المناخي قد لا تكون علاجاً ناجعاً لكل المشكلات التي تواجهها تونس، إلا أن تنفيذها الفعال في الوقت المناسب يمكن أن يساعد على الأقل في منع تفاقم مستويات البطالة والهجرة المرتفعة بالفعل. علاوة على ذلك، يمكن لهذه الجهود أن تساعد في الحد من الاضطرابات السياسية وعدم الاستقرار، خاصة أن المناطق المهمشة تقليدياً ستستمر في المعاناة من آثار تغير المناخ بشكل غير متكافئ.
لا يمكن للحكومة التونسية أن تهدر المزيد من الوقت. وفي مصلحة الرئيس سعيد، مع اكتمال مشروعه السياسي إلى حد كبير، أن يحول انتباهه لمشكلة التغير المناخي والتعامل مع آثارها التي إن تُرِكَت دون رادع ستؤدي لا محالة إلى تصاعد الاضطرابات المجتمعية.
يجب أن تجمع سياسة المناخ في تونس، وهي سياسة تحتاج بلا شك إلى جذب التمويل الخارجي، بين الدعم الفيدرالي والإرادة السياسية والجهود المحلية من البلديات والمجتمع المدني لمعالجة آثار أزمة المناخ في كل منطقة على حدة.
ولحسن الحظ، فإن تونس تتمتع بالعديد من المزايا البارزة التي تتجلى في نشطاء المجتمع المدني الملتزمين، والجهات الفاعلة المحلية المتحمسة والراغبة في التصدي لتغير المناخ، وسلسلة من التقارير والدراسات وخطط العمل التي ترسم المسار المستقبلي؛ ومجتمع المانحين الذي يبحث عن طرق لدعم البلاد بطريقة غير سياسية تعود بالنفع على الشعب التونسي. لكن كل هذه الميزات قد تذهب أدراج الرياح بدون الدعم الكامل من الرئيس قيس سعيد.
ليبيا: لامركزية القرار والتكيف مع آثار هشاشة الوضع المناخي
فريدريك ويري
ليبيا دولة شاسعة يبلغ عدد سكانها نحو 7 ملايين نسمة، وهي واحدة من أكثر دول العالم معاناة من الإجهاد المائي ما يجعلها أكثر هشاشة في مواجهة التغيرات المناخية الحادة. وقد شهدت ليبيا في السنوات الماضية ارتفاعاً كبيراً في درجات الحرارة تجاوز المستويات القياسية المسجلة دولياً تجاوزاً كبيراً، ومن المتوقع أن يرتفع متوسط درجات الحرارة في البلاد بمقدار درجتين مئويتين بحلول عام 2050. وتتعرض ليبيا للعديد من العواصف الترابية ونوبات الجفاف الطويلة والحادة والمتكررة بسبب ظاهرة الاحترار العالمي التي تتسبب في آثار مدمرة على الزراعة والصحة والنقل. أما بالنسبة للأمطار الاعتيادية فقد أصبحت أكثر ندرة وأقل انتظاماً في حين تزايدت موجات الأمطار الغزيرة التي تسبب فيضاناتٍ مُدمّرة، لا سيّما في المدن والبلدات التي تعاني من سوء التخطيط الحضري. أما بالنسبة لمياه الشرب – التي يُستَخرَج 80 في المئة منها من طبقات المياه الجوفية الأحفورية غير المتجددة الواقعة في عمق الصحراء الجنوبية عبر نظام ضخم من الأنابيب يسمى النهر الصناعي العظيم – فهي تتناقص تناقصاً سريعاً بسبب تعرضها للتبخر في الخزانات المفتوحة وبسبب استخراجها بطرق غير مستدامة. أما مستويات مياه سطح البحر على طول الخط الساحلي الممتد في ليبيا، فقد بدأت ترتفع لتصل إلى ثلاثة ملليمترات في السنة، اعتماداً على الرياح والتيارات الإقليمية، وهو ارتفاع قد يؤدي، إن استمر، لغمر مدينة بنغازي الساحلية أو الإضرار بها ضرراً بالغاً.
فريدريك ويري
تسهم مشاكل مناخية أخرى في زيادة خطورة الأوضاع في ليبيا. منها أن ليبيا تعتمد على صادرات النفط لتمويل ميزانية القطاع العام المتضخمة – حيث يعمل نحو85 في المئة من السكان في القطاع العام الليبي –ما يجعل اقتصادها عرضة لما سَيُسفر عنه الانخفاض الوشيك في أسعار النفط العالمية المتوقع هبوطها من أعلى نقطة لها، والمعروفة باسم “ذروة النفط”، بسبب التوجه العالمي الحالي للطاقة المتجددة، والتعهدات الدولية بصافي انبعاث كربوني صفري. ومنها أيضاً ضآلة حجم القطاع الزراعي الليبي واعتماد البلاد على الواردات في توفير ما يزيد عن ثلاثة أرباع موادها الغذائية ما يجعلها عرضة على نحو مماثل لصدمات الإمدادات الغذائية، خاصة تلك الناجمة عن تغير المناخ. كما تساهم ليبيا مساهمة فريدة في ظاهرة الاحترار العالمي، حيث تنتج البلاد، على الرغم من قلة عدد سكانها، واحداً من أعلى معدلات الانبعاثات الكربونية للفرد في العالم، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى ما يتسبب به إنتاج النفط من هدر كبير.
ترجع هشاشة الدولة الليبية أمام التغيرات المناخية إلى حد كبير إلى العوامل البشرية من سوءِ حكمٍ ونزاعاتٍ مسلحة وإهمالٍ للبنيةِ التحتية. وبشكل مبدئي، دفعت أزمة الشرعية السياسية المستمرة في البلاد النخب الليبية والجهات الفاعلة الخارجية إلى الإصرار على ضرورة توحيد البلاد وضمان استقرارها أولاً، قبل الشروع في إصلاحات طويلة الأجل، مثل تلك المطلوبة لدرء مضار التغيرات المناخية وتعزيز الاستدامة. لكن تبلد الطبقة السياسية الليبية فيما يتعلق بالعمل المناخي لا يمكن تعليقه على عدم الاستقرار السياسي في البلاد وحسب، فقد أدى اعتماد البلاد الطويل على عائدات النفط إلى تثبيط الإصلاحات المتعلقة بالمناخ وتعزيز ثقافة استلاب ما يمكن استلابه من مغانم، والتي تؤدي بالضرورة إلى شلل العمل المناخي. وبينما تستمر هذه الأوضاع فإن الليبيين الأكثر عرضة للمخاطر المناخية والأكثر احتياجاً للحماية، خاصة أولئك الذين يعيشون على أطراف الجنوب والشرق والغرب، مضطرون للوقوف مكتوفي الأيدي بينما تتعرض سبل عيشهم وصحتهم وأمنهم للخطر.
لكن المواطنين الليبيين ما كانوا ليتقبلوا دور الضحية أو يرضون به. وكلما تزايد الإحباط الشعبي بسبب مشاحنات النخبة والتقاعس الحكومي، ازداد إصرار السلطات البلدية ومجموعات المجتمع المدني في جميع أنحاء البلاد على ابتكار طرق جديدة لبناء قدرة المجتمع على مقاومة آثار التغير المناخي. وتعكس مبادرات تلك الجماعات نفس فضائل الاعتماد على الذات والابتكار التي أظهرتها الجهات الفاعلة المحلية في الاستجابة لوباء كوفيد 19. على السلطات الليبية والحكومات الأجنبية والمنظمات غير الحكومية أن تضع على رأس أولوياتها كل ما من شأنه أن يدعم حشد وتمكين هذه التعبئة الشعبية، من خلال الإصلاحات القانونية وإصلاح الموازنة العامة وتقديم الدعم المختص بجهود التكيف مع آثار التغير المناخي والمستجيب لها. ولا يمكن إغفال أهمية اللامركزية، على الرغم من أنها قد لا تكون العلاج الناجع لكل المشاكل كما يشاع عنها، في معالجة العديد من العلل في ليبيا، بما في ذلك الآثار الشائنة لتغير المناخ.
كيف أدى الصراع والتشرذم السياسي في ليبيا إلى تفاقم المخاطر المناخية
غالبا ما يُلقي الليبيون، وغيرهم من المهتمين بالشأن الليبي خارج البلاد، باللوم على الفوضى التي أعقبت ثورة 2011، التي أطاحت بالرئيس معمر القذافي، والتي دعمها حينذاك حلف شمال الأطلسي، على ما تتعرض له البلاد الآن من مخاطر مناخية كبيرة. ولكن الحقيقة هي أن قدراً كبيراً من هشاشة المناخ في ليبيا اليوم يمكن أن يُعزَى إلى سوء إدارة الدكتاتور للموارد وللبيئة المناخية في البلاد. فقد تسببت السياسات التي اتبعها القذافي لتوفير المياه والكهرباء من خلال الدعم والاحتكارات الحكومية الفاشلة في معدلات سحب واستهلاك غير مستدامة، وتسببت خططه الزراعية الطموحة في تسارع نضوب طبقات المياه الجوفية الساحلية، ما دفع البلاد لزيادة الاعتماد على المياه التي يوفرها النهر الصناعي العظيم، وهو المشروع الضخم الذي تبناه القذافي لنقل المياه، والذي ابتُلِيَ منذ انطلاقه بالمحسوبية وسوء البنية التحتية. أما في ثمانينات القرن الماضي فقد أدت قرارات المِلكية الجماعية التي أصدرها القذافي إلى تآكل وجرف غابات الحزام الأخضر الذي يطوق طرابلس والذي ساهم على مدار عقود في خلق مناخ محلي نافع وإبطاء زحف رمال الصحراء نحو العاصمة. ومنذ وفاته، تزايدت هذه المشاكل بسبب التشرذم السياسي والمؤسسي، والتعدي الشرس على البيئة، والفساد المتفاقم، والتدهور السريع للبنية التحتية للكهرباء والمياه.
أما بالنسبة للنخب السياسية الليبية – التي تنتشر في الوزارات المتنافسة وفلول المجالس التشريعية التي لا تزيد عن كونها إقطاعيات للإثراء الشخصي – فقد كانت استجابتها لمشكلة التغيرات المناخية وكيفية معالجة آثارها والتكيف معها بطيئةً بُطْئاً صادماً. وليبيا هي الدولة الوحيدة من بين 196 دولة موقعة على اتفاقية باريس لعام 2016، التي لم تقدم خطة المساهمة المحددة وطنياً الخاصة بها، وهي خطة عمل تقدمها كل دولة على حدة، توضح فيها ما ستبذله من جهود للحد من الانبعاثات الكربونية ولحماية المجتمع من آثار تغير المناخ. والحقيقة أن إعداد سياسة مناخية للدولة تَحَوَل في ظل حكومة الوحدة الوطنية في طرابلس، وهي الحكومة الأحدث في سلسلة من السلطات الانتقالية غير المنتخبة التي توسطت الأمم المتحدة لإنشائها منذ عام 2011، إلى موضوع خلاف شخصي وفصائلي، لا سيما بين مكتب رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة ووزارة البيئة. حيث وضع رئيس السياسة المناخية في مكتب الدبيبة خارطة طريق وطنية للعمل المناخي تشجع التنوع الاقتصادي، والانتقال إلى مصادر الطاقة المتجددة، وتحسين البنية التحتية، والتوعية بالمناخ والدعوة لإصلاحه، والاهتمام بأبحاث المناخ، وبالتحول التكنولوجي الذي يدعم القدرة على مقاومة آثار التغير المناخي.9 لكن هذه الخطة لم تنفذ بعد، ويرجع ذلك جزئيا إلى الخلافات بين رئيس الوزراء ووزارة البيئة.
على صعيد آخر، تتقاعس الهيئات الحكومية المعنية بقضايا التكيف مع المناخ عن التعاون فيما بينها: لم يُعنَى أحدٌ بإبلاغِ المسؤولين في المكتب الوطني للأرصاد الجوية، على سبيل المثال، الذين يراقبون ويجمعون بيانات قيمة عن العواصف الرملية والجفاف وآثارهما الاجتماعية والاقتصادية، بتشكيل سلطة المناخ الجديدة داخل مكتب رئيس الوزراء.10 وعلى الرغم من وضع خطة للطاقة المتجددة وتوفر الإمكانات الهائلة للطاقة الشمسية وطاقة الرياح في البلاد، لم تحرز ليبيا تقدماً يذكر على هذه الجبهات (باستثناء بعض الحالات المتفرقة لاستخدام الألواح الشمسية في المدن) ويرجع ذلك جزئيا إلى انعدام القدرة التنافسية لدى القطاع الخاص الذي ترسخت فيه البيروقراطية منذ عهد الاحتكارات الحكومية. وبالمثل، فشلت الجهود الرامية إلى الاستفادة من التمويل الذي تقدمه صناديق المناخ الدولية بسبب الفوضى المؤسسية وعدم وجود نقطة تواصل واضحة ومحددة مع الأطراف الليبية المعنية.
يزداد الوضع سوءاً في شرقي ليبيا وبعض مناطق الجنوب: حيث اشتدت قبضة أمير الحرب الحاكم المشير خليفة حفتر على قطاعات واسعة من اقتصاد المنطقة، بما في ذلك الزراعة والطاقة والبنية التحتية من خلال ما يسمى بهيئة الاستثمار العسكري، التي تتلخص وظيفتها الرئيسة في تحصيل المكاسب له ولعائلته وللمقربين منه. وتوجد مزاعم تقول إن هيئة الاستثمار العسكري وأبناء حفتر متورطون في عدد من المشاريع المخالفة للقانون مثل تهريب الوقود وحصاد الخردة المعدنية من المعدات وقطع الغيار المستخدمة في النهر الصناعي العظيم وبيعها بعد ذلك في الخارج.
أما بالنسبة للمواطنين العاديين في ليبيا، وخاصة أولئك الذين يعيشون خارج العاصمة والمدن الساحلية الأخرى، فمن المرجح أن يصبح غضبهم بسبب تقاعس الحكومة فيما يتعلق بالتغير المناخي بنداً جديداً يُضاف إلى قائمة المظالم الطويلة التي يعانون منها والتي يتصدرها إثراء النخبة، وتفاقم عدم المساواة الاجتماعية والاقتصادية، وسوء الخدمات المُقدّمة. والواقع أن العديد من الفئات الهشة في المجتمع الليبي لديها ما يكفي من الذكاء الفطري المُستَقَى من الواقع المناخي المُعاش لتدرك تمام الإدراك أن الآثار المناخية المُهَدِّدَّة تتفاقم بسبب المشاكل المنهجية لسوء الإدارة.11 وتأكيداً لذلك نجد أن بعض العاملين في القطاع الزراعي قد أٌجبِروا على التخلي عن عملهم ليس فقط بسبب المشاكل المناخية مثل الجفاف وانخفاض معدلات هطول الأمطار ، ولكن أيضا بسبب ارتفاع أسعار الوقود، و الانقطاع الطويل والمتكرر للتيار الكهربائي، الذي يجعل الحفر بحثا عن المياه الجوفية باهظ التكلفة ويعيق الري. وبالمثل، تُعطّل العواصف الرملية والترابية حصاد المحاصيل ونقلها، لكن هذه العواصف نفسها تتفاقم بسبب سوء إدارة التربة السطحية، واجتثاث الغابات، والآثار المدمرة للنزاع المسلح على الأراضي الزراعية – وكلها عوامل تتعلق بالحكم.
وبحسب السبعينين وهو أحد المزارعين الذين يعيشون في جنوب طرابلس:
“تؤثر العواصف الرملية على مزرعتي وكذلك تفعل الكهرباء، لكنها ليست أسوأ من الوزارة والحرب… بالنسبة لي، العامل الرئيس هو الإهمال. . . لا يوجد رقابة ولا دعم. . . تغير المناخ فقط يزيد المشكلة. . .. أتوقع أن أفقد مزرعتي إذا استمر سوء إدارة الموارد”.12
دعم الابتكار والنشاط البيئي المحلي لبناء القدرة على التكيف مع التغيرات المناخية
في خِضَمِّ هذا الإهمال، تتحرك مجموعة واسعة من الجهات الفاعلة المحلية في جميع أنحاء البلاد للتخفيف من مخاطر المناخ وبناء القدرة على مقاومة آثار التغير المناخي. وتجري هذه التعبئة من خلال النضال الطويل والممتد ضد المركزية المفرطة، التي ساهمت إلى حد كبير في انتفاضة 2011، ولا تزال سمة مميزة للمسار السياسي الليبي. وعلى الرغم من إحراز بعض التقدم، إلا إن السلطات البلدية الليبية لا تزال تناضل للحصول على مخصصات مالية عادلة وسريعة ولترسيم السلطات القانونية وتوضيح دورها بشكل يسمح لها بخدمة ناخبيها والاستجابة لحالات الطوارئ، بما في ذلك الظواهر الجوية المتطرفة وغيرها من آثار تغير المناخ، على نحو مثالي.13
وفقا للمادة 25 من قانون نظام الإدارة المحلية، تتحمل البلديات مسؤولية وسلطة حماية البيئة في مناطقها والاستعداد للفيضانات والحرائق والكوارث الطبيعية الأخرى والاستجابة لها. لكن تنفيذ السلطات لهذه التدابير يعوقه انعدام المساواة في إمكانيات الوصول للموارد البشرية والتقنية بين المدن في جميع أنحاء البلاد، وبالرغم من أهمية هذه المشكلة إلا أن أهم ما يعوق السلطات المحلية في تنفيذ خططها للتكيف مع المناخ هو البطء الشديد الذي تتعامل به الحكومة في طرابلس مع متطلبات تلك الخطط، وغياب تشريع واضح أو استراتيجية وطنية بشأن المناخ، واستمرار الخلافات بين الشخصيات النخبوية والبيروقراطيات المرتبطة بها كما ذكرنا سابقاً. الواقع هو أن هذا الجمود الذي يَسِم القيادات العليا للبلاد يؤثر بشكل مباشر على الكيفية التي تتعامل بها الجهات الفاعلة الخارجية الراغبة في دعم جهود التكيف مع المناخ وحماية البيئة في ليبيا. وفي كثير من الحالات، تتجه الحكومات الأجنبية والمنظمات غير الحكومية والمنظمات متعددة الأطراف مباشرة إلى الجهات الفاعلة المحلية. وبحسب أحد مستشاري التنمية الغربيين العاملين في مجال تغير المناخ في ليبيا “تأخذ المدن في الأطراف بزمام الأمور بينما يتلاشى المركز”، مشيرا إلى “البيروقراطية المملة” لحكومة طرابلس.14
يعتبر نقص المياه وتدهور جودتها بسبب التلوث والتملّح من أكبر المخاطر المناخية التي تواجه البلديات في جميع أنحاء ليبيا. وقد أصبحت الآثار الاجتماعية لهذه المشكلة والمتمثلة في النزوح وتزايد الضغط الشعبي – محسوسة بالفعل. ولا يزال توصيل المياه من النهر الصناعي العظيم يمثل قضية مركزية حيث تشكو بعض المجتمعات من عدم اكتمال بعض أجزاء النهر، ما يعيق وصول الخدمة إلى مناطقها، ومن تدهور بنيته التحتية، وتعرّض مجراه للاستغلال غير القانوني والتخريب. وتعاني مجتمعات الطوارق والتُبو بشكل خاص -وهما أقليتان عرقيتان غير عربيتان تتمركزان في الجنوب- من المظالم التي تنتج عن النهر الصناعي، وطالما عبّرت تلك المجتمعات عن استيائها من السياسات التي تمنح الأفضلية للمناطق الساحلية في عمليات استخراج المياه. وأشار ضابط عسكري سابق من الطوارق وزعيم محلي في أوباري إلى أن “هناك ثروة في هذه الكثبان الرملية… المياه الجوفية والنفط والغاز. إنه مسرح مفتوح”.15
وفي أماكن أخرى، لا يزال الجفاف والتصحر والفيضانات وحرائق الغابات مصدر قلق للبلديات: ففي بلدة غات الجنوبية الغربية، على سبيل المثال، اضطر 2500 شخص للفرار من منازلهم خلال الفيضانات المفاجئة الناجمة عن الأمطار الغزيرة، بينما في الشمال، اندلعت حرائق الغابات في جبال نفوسة الغربية والجبال الخضراء الشرقية، مما عرض المحميات الطبيعية والمحاصيل والمدن للخطر واستلزم إرسال معدات مكافحة الحرائق من كُلٍ من إيطاليا واليونان.
ولمواجهة هذه التحديات، أطلقت السلطات البلدية وجماعات المجتمع المدني عدداً من المبادرات النموذجية، تَستقي من نفس منابع العمل التطوعي الذي عزز استجابتها لوباء الكوفيد فيما سبق عندما تعاون النشطاء ومجالس المدن لتأمين معدات الحماية وتوزيع اختبارات الكوفيد ونشر التوعية بالصحة العامة. وتتجلى روح مماثلة الآن في النشاط البيئي والمناخي في ليبيا، حيث تنتشر حملات زراعة الأشجار و”تثبيت الكثبان الرملية” وقوافل تنظيف التلوث وبرامج تعليمية حول إعادة تدوير واستخدام المياه؛ وورش عمل حول تحسين البنية التحتية.
وفي بعض الأحيان، تتعاون الحكومات الأجنبية والمنظمات متعددة الأطراف مع هذه الجهود الحميدة، غالباً تحت مظلة برامج المساعدة المحلية واسعة النطاق مثل مشروع “تامسال”، على سبيل المثال، وهو مشروع يموله الاتحاد الأوروبي ويهدف لدعم التوعية المناخية والنشاط البيئي بين مجموعات الشباب وحكومات المدن عبر عشرين بلدية. وبالمثل، يعمل برنامج “تقريب” التابع للوكالة الأميركية للتنمية الدولية مع ثلاثين بلدية لتحسين الخدمات المقدمة من خلال التدريب والتوعية والمساعدة التقنية، ويُعنى البرنامج بالتوجهات الخضراء مثل إعادة التحريج وإعادة التدوير واستخدام الألواح الشمسية في إنارة الشوارع. وفي مدينة مصراتة، تتعاون اللجنة الدولية للصليب الأحمر مع أحد مختبرات التربة على إنتاج بذور مقاومة للجفاف، تُوَزّع بعد ذلك على المزارعين الأكثر احتياجا إليها، لا سيما في منطقة فزان الجنوبية.16
تمثل هذه الجهود الشعبية لتعزيز القدرة على مقاومة آثار التغير المناخي أمثلة جديرة بالثناء على سِعَة الحيلة المحلية. ولذلك ينبغي تمكينها من خلال زيادة الدعم الإداري واللامركزية القانونية والمساعدات الدولية التي تقدمها الحكومات والمنظمات غير الحكومية. ومع ذلك لا تزال تلك الجهود تواجه عقبات هائلة، من أهمها التهديد المستمر الذي تمثله الجماعات المسلحة في ليبيا – بما فيها تلك التابعة للدولة – التي تستغل ما تتسبب فيه التغيرات المناخية من نقصٍ في الموارد، خاصة في الكهرباء -التي تحسنت أوضاعها مؤخراً- والمياه، لاستهداف نشطاء المجتمع المدني. علاوة على ذلك، فإن المبادرات المحلية ليست سوى جزء من حل جذري تتطلبه الأوضاع في ليبيا. حيث يتوجب على السلطات المركزية الليبية أن تدعم الخطط التي تستدعي تدخل السلطة التنفيذية والهيئة التشريعية الوطنية، مثل تنفيذ استراتيجية وطنية للمياه، طالما طالبت بها البلديات، ومعالجة الهشاشة البيئية والمناخية في المساحات الشاسعة من الأراضي الصحراوية خارج نطاق الحكومات البلدية. والأهم من ذلك، تحتاج السلطات الوطنية إلى اتخاذ إجراءات بشأن المهام المناخية المهملة منذ فترة طويلة، بما في ذلك الوفاء بالتزامات ليبيا الدولية بشأن إزالة الانبعاثات الكربونية والتحرك نحو الطاقة المتجددة والتنوع الاقتصادي.
على الرغم من أن بعض هذه الخطوات يمكن اتخاذها الآن – مثل منح قدر أكبر من المسؤولية المالية والإدارية للحكومات البلدية – فلا يمكن أن يتحقق تقدم حقيقي في التكيف مع التغير المناخي والتخفيف من آثاره إلا عندما تتوقف النخب الليبية عن مساعيها الداعمة للفُرقة ولتعظيم الذات، وتعمل على تسليم السلطة إلى حكومة منتخبة أكثر شرعية.
التغير المناخي وآفاق الهجرة بين غرب وشمال إفريقيا
جيلز أولاكونلي يابي
يتجه العديد من مواطني القارة الإفريقية إلى اختيار مسار الهجرة بسبب الضغوط التي تشهدها المجتمعات السكانية الإفريقية الشابة من حيث تنامي الأعداد، ومحدودية الموارد، وانعدام الأمن والمساواة الاقتصادية، وقصور فرص العمل المتاحة عن تلبية الاحتياجات المتزايدة، فضلاً عن التجذر التاريخي لتقاليد الهجرة في بعض المناطق.
جيلز أولاكونلي
بطبيعة الحال، ومن وجهة نظر تحليلية، فإن مسببات الهجرة هذه لا تختلف اختلافا واضحا عن مسببات الهجرة في أماكن أخرى خارج إفريقيا، حيث تتماشى الهجرة الإفريقية مع تاريخ طويل من التنقلات البشرية في جميع أنحاء العالم. ولكن بالنظر إلى المستقبل، فإن تغير المناخ سيكون له تأثيرات معقدة، وبلا شك صعبة، على التنقل في العقود المقبلة.
تدفقات الهجرة الأخيرة من إفريقيا وإليها
شهد عام 2020 حركة تنقل كبيرة داخل حدود القارة الإفريقية، حيث انتقل ما يقرب من 80 في المئة من إجمالي المهاجرين الأفارقة إلى البلدان المجاورة. ولكن عدم وجود سجلات جيدة توثق عمليات الهجرة تلك، يحُد من إمكانية التحليل الدقيق لتطور مسارات الهجرة إلى المناطق الإقليمية المتاخمة، كالهجرة إلى دول “المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا”، التي تَعتبر حرية التنقل مبدأً حقوقياً أساسياً. ومع ذلك، لا يَخْفَى على أحد أن الأزمات الأمنية والاقتصادية التي عصفت بالقارة في السنوات الأخيرة – وبمنطقة الساحل الإفريقي على وجه الخصوص – قد أنتجت تدفقات بشرية جديدة، منها الداخلي ومنها الخارجي نحو البلدان المجاورة.
تميل معظم التغطيات التي تقدمها وسائط الإعلام الدولية عن الهجرة الإفريقية إلى الاستعانة بتقارير تتحدث عن محاولات المهاجرين غير الشرعيين للوصول إلى أوروبا، والمآسي المتكررة التي تودي بحياة الآلاف منهم. ويمثل المهاجرون الأفارقة حوالي 13 في المئة من مجموع المهاجرين الدوليين الذين انتقلوا إلى أوروبا في عام 2020. وفي عام 2021، توفي ما يقرب من 2000 شخص على طُرُق وَسَط وغرب البحر الأبيض المتوسط، أو فُقِد أثرهم، وكذلك تُوفي أو فُقِد حوالي 1000 شخص على الطريق البحري الذي يصل شمال غرب إفريقيا بجزر الكناري. ولقي مئاتٌ من المهاجرين حتفهم بسبب ما تعرضوا له من ظروف مروعة في الصحاري الشاسعة، حتى قبل الوصول إلى بلدان شمال إفريقيا ومحاولة العبور إلى أوروبا.
وفي حين يمثل الأفارقة من بلدان جنوب الصحراء الكبرى، ذات تقاليد الهجرة الطويلة، نسبة كبيرة من المهاجرين الذين يسعون للوصول إلى الشواطئ الأوروبية، فإن الآلاف من الشبان المغاربة والجزائريين والتونسيين الذين يواجهون تحديات اقتصادية واجتماعية صعبة يحاولون أيضا العبور إلى أوروبا، وهي محاولات تنتهي أحياناً نهاياتٍ مأساوية. فبحسب وكالة الحدود وخفر السواحل الأوروبية فرونتكس، تم ضبط حوالي 97000 مواطن من هذه البلدان المغاربية الثلاثة يحاولون دخول أوروبا بشكل غير قانوني في الأعوام ما بين 2015 و2019. ومن بين هذا العدد كان حوالي النصف من المغاربة، والثلث من الجزائريين، وأقل من الربع بقليل من التونسيين.
لكن أوروبا ليست هي الوجهة الرئيسة الوحيدة للمهاجرين الأفارقة. بل تعتبر بلدان شمال إفريقيا مثل الجزائر وليبيا والمغرب وتونس وجهة أساسية أخرى تستقبل آلاف المهاجرين من دول الساحل وغرب إفريقيا. ويمر بعض هؤلاء المهاجرين بتلك الدول مروراً قصيراً بينما يختار أو يضطر بعضهم أن يسكنها لفترات أطول ليتمكنوا من كسب المال الذي يمكنهم من مواصلة رحلة الهجرة، ويختار البعض الآخر أن يستوطنها إلى الأبد. وقد اجتذبت ثروة ليبيا النفطية وسياسة الباب المفتوح “الغامضة وغير الرسمية” التي انتهجها الحاكم السابق معمر القذافي على مدى عقودٍ طويلة أعداداً كبيرة ًمن مواطني الدول المجاورة الذين يبحثون عن فرصٍ اقتصادية. وفي عام 2011، في وقت الانتفاضة والحرب التي أطاحت بنظام القذافي الذي دام اثنين وأربعين عاما، قّدرت المنظمة الدولية للهجرة أعداد العمال المهاجرين في ليبيا بحوالي 2.5 مليون عامل مهاجر.
وفي المغرب، الذي يعتبر وجهة رئيسة للهجرة بالإضافة لكونه نقطة استضافة وعبور للمهاجرين من جنوب الصحراء الكبرى، حصل 18,000 مهاجر غير نظامي على تصاريح تتيح لهم الإقامة القانونية في البلاد في عام 2014. وتشير التقارير إلى أن هذا العدد قد ارتفع ليصل إلى 55.000 مهاجر في عام 2018.
والجزائر أيضاً تعتبر تاريخيا معبراً مهماً للهجرة إلى أوروبا، ومضيفاً كريماً للمهاجرين القادمين من بلدان متعددة. وتشير إحصاءات المنظمة الدولية للهجرة أن عدد المهاجرين في الجزائر في عام 2019 يتراوح بين 100.000 و150.000 مهاجر نظامي، وما بين 50.000 و75.000 مهاجر غير نظامي.
أما تونس فلا تزال تعتبر بلداً مُصَدِّراً للمهاجرين، حيث يقيم ما يُقَدّر بنحو مليون ونصف تونسي خارج البلاد، استقر 80 في المئة منهم في أوروبا في سنة 2018. وقد تسببت الأزمة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية التي تمر بها تونس في السنوات الأخيرة في تزايد التوجه العام نحو الهجرة. لكن تونس هي أيضا بلد عبور مهم نحو إيطاليا وبالتالي نحو بقية أوروبا. فالجزائريون والمغاربة والمهاجرون من غرب ووسط إفريقيا والقرن الإفريقي، وحتى المهاجرون من بلدان أبعد (مثل أفغانستان وبنغلاديش وباكستان وسريلانكا) يمرون عبر ليبيا أو تونس للوصول إلى إيطاليا. ووفقا للأرقام الرسمية في عام 2020، يعيش في تونس أكثر من 21,000 مهاجر غير نظامي من دول إفريقيا الواقعة جنوب الصحراء الكبرى (وهو عدد يمثل اقل من 0.2 في المئة من إجمالي عدد السكان البالغ حوالي 12 مليون نسمة).
من الطبيعي أن تلعب الروابط التاريخية والثقافية التي تربط بين المجموعات العرقية في منطقة الساحل وشمال إفريقيا دورا هاما في تحديد مدى كثافة التنقل في هذه المناطق. وتحكي لنا المرويات المتداولة أن الصحراء لم تكن أبداً عقبة أمام حركة وتنقل الأشخاص والأفكار والبضائع، وأن التجارة عبر الصحراء لعبت، في الواقع، دورا محورياً في توجيه مسارات دول الساحل وشمال إفريقيا، التي قام الاستعمار الأوروبي بتشكيل أو إعادة تشكيل حدودها.
غير أن مسار وطبيعة الهجرة قد تتغير في السنوات والعقود القادمة. ومن المرجح أن تتأثر الهجرة بالحالة الأمنية المتدهورة التي تشهدها العديد من المناطق في القارة. وعلى سبيل المثال، يهدد نشاط الجماعات الإرهابية المسلحة المتعددة في منطقة الساحل (في بوركينا فاسو ومالي والنيجر) وفي حوض بحيرة تشاد (في الكاميرون وتشاد ونيجيريا) سكان ساحل غرب إفريقيا (في بنين وكوت ديفوار وغانا وتوغو). وبما أن الأمن والأمان والاقتصادي من العوامل الحاسمة في خيارات الهجرة الفردية، فإن عدم الاستقرار الأمني هذا إن استمر، يمكن أن يؤثر بشكل ملموس على هذه الخيارات. يمكن لظواهر أخرى مزعزعة للاستقرار، مثل الآثار الضارة لتغير المناخ، أن تلعب أيضا دورا هاما في تطور قضية الهجرة. وينبغي الآن أخذ آثار التغيرات المناخية بعين الاعتبار عند إجراء أي تحليلات مستقبلية لعمليات التنقل في إفريقيا، ولا سيما بين الضفتين الشمالة والجنوبية للصحراء.
العواقب الوخيمة لتغير المناخ في غرب وشمال إفريقيا
على الرغم من أن التنبؤات المناخية تظل تنبؤات ولا يمكن التعويل عليها بشكل مطلق، إلا أن الأبحاث العلمية التي أجراها علماء المناخ تتطابق إلى حد بعيد مع ما يحدث على أرض الواقع المرئي بالفعل. وتعاني إفريقيا منذ زمن من أزمات غذائية متكررة وارتفاع شديد في درجات الحرارة ونقص في المياه، على خلفية من النمو السكاني السريع والظروف السياسية غير المستقرة. ووفقا للتوقعات المتشائمة الواردة في تقرير البنك الدولي بعنوان ” الاستعداد لمواجهة الهجرة الداخلية بسبب المناخ ” في إفريقيا، فإن سكان المناطق التي تعاني من شُح المياه، والمناطق التي تنخفض فيها إنتاجية المحاصيل والنظم الإيكولوجية، والمناطق المتأثرة بارتفاع مستوى سطح البحر الذي تزايد بسبب هبوب العواصف، سيسعون للهجرة. ومن المتوقع أن تسجل النيجر ونيجيريا والسنغال أكبر عدد من مهاجري المناخ الداخليين بحلول عام 2050، لتصل أعدادهم إلى 19.1 مليون مهاجر في النيجر، و9.4 مليون مهاجر في نيجيريا، ومليون مهاجر في السنغال. وعلى الرغم من أن معظم الهجرة المناخية ستكون داخلية، إلا أن بعض هؤلاء المهاجرين سيعبر الحدود الوطنية إلى البلدان المجاورة أو أبعد من ذلك.
أما بالنسبة لشمال إفريقيا، فإن جميع النماذج والسيناريوهات المناخية تتنبأ بزيادة حادة في موجات الحرارة. وفي حال وصلت الزيادة في معدلات الاحترار العالمي إلى 4 درجات مئوية، فمن المتوقع أن تشهد بعض بلدان المنطقة، كالجزائر مثلاً، زيادة في متوسط درجات الحرارة في الصيف قد تصل إلى 8 درجات مئوية بحلول نهاية القرن. وفي الوقت نفسه، من المتوقع حدوث انخفاض في معدلات هطول الأمطار في أجزاء كبيرة من شمال إفريقيا يصاحبه نقص في إمدادات المياه وتزايد في الطلب عليها بسبب النمو السكاني ومشاريع التنمية الاقتصادية، والحقيقة أن المناخ قد يتغير تغيراً غير مسبوق تصل فيه درجات الحرارة اليومية القصوى إلى ما يزيد عن 50 درجة مئوية ما سيجعل بعض الأماكن في المنطقة غير صالحة لسكن بعض الأنواع البيولوجية وعلى رأسها البشر.
تشهد منطقة غرب إفريقيا أيضا تغيراً مناخياً سريعاً، يميزه انتشار الحر وزيادة متوسط درجات الحرارة الاعتيادية ودرجات الحرارة القصوى التي تتنبأ التوقعات المناخية أنها ستشهد المزيد من القفزات الحادة. ويعتبر هذا الاحترار عاملاً ثابتاً في توقعات تغير المناخ، على الرغم من أن حجم الاحترار الذي يتراوح عادة ما بين ثلاث إلى سبع درجات مئوية، يعتمد على شكل وسيناريو الانبعاثات. أما التوقعات المستقبلية لهطول الأمطار التي تقدمها نماذج المحاكاة المناخية فلا تتمتع بنفس كفاءة التوقعات التي تقدمها عن التغيرات المحتملة في درجات الحرارة، وبالطبع تتفاوت بحسب الموقع الجغرافي على منطقة الساحل.
على الرغم من أن حجم الآثار المتوقعة غير مؤكد، فإن العديد من الدراسات تشير إلى أن زيادة انبعاثات غازات الدفيئة من المرجح أن يقلل من متوسط غلة المحاصيل ويزيد من تقلب الإنتاج في العديد من بلدان غرب إفريقيا التي تعاني بالفعل من انعدام الأمن الغذائي. ومن المتوقع أن تتأثر الزراعة والموارد المائية سلباً حتى في حال لم يتجاوز الاحترار العالمي 1.5 درجة مئوية وهو أكثر السيناريوهات تفاؤلا.
أما بالنسبة للآثار المتوقعة للتغير المناخي، فهي لن تتفاوت بين دول شمال وغرب إفريقيا تفاوتاً كبيراً، وسيكون التباين الوحيد هو في القدرة النسبية لهذه الدول على التكيف – وهي قدرة تعتمد إلى حد كبير على السياسات العامة لكل دولة، ومدى تطور البنية التحتية، ووجود المهارات اللازمة لتعزيز التكيف السريع والفعال.
على مدى العقود المقبلة، من المحتمل أن تؤثر الظروف الاقتصادية والسياسية والأمنية السائدة في الدول الإفريقية تأثيراً كبيراً ،قد يضاهي تأثير التغير المناخي، في دفع التحركات السكانية الكبيرة – سواء داخليا أو خارجياً إلى البلدان أو القارات المجاورة. ولا يمكن الجزم- على أساس تغير المناخ وحده -أنه سيكون هناك تدفق هائل للمهاجرين من غرب إفريقيا إلى بلدان شمال إفريقيا.
تأثير التغيرات الديموغرافية على الهجرة الإفريقية
يستحق العامل الديمغرافي اهتماما خاصا، لأن الآثار السلبية المتوقعة لتغير المناخ ستؤثر على مئات الآلاف أو عشرات الملايين من الناس، تبعا للمناطق التي ستكون أكثر تضررا، ولعدد الأشخاص الذين يعيشون فيها. ويمكن أن تكون المعدلات الديمغرافية النسبية في شمال وغرب إفريقيا عاملا رئيساً في آفاق الهجرة بين هاتين المنطقتين.
في عام 2020، بلغ عدد سكان دول الصحراء السواحيلية الثمانية 166 مليون نسمة، مقارنة ب 132 مليون نسمة في عام 2010. وبلغ عدد سكان الجزائر وليبيا والمغرب وتونس ما يقرب من 100 مليون نسمة في عام 2020، مقارنة ب 66 مليون نسمة يسكنون أربع دول سواحيلية مجاورة هي مالي، وموريتانيا، والنيجر، وتشاد. وقد نما عدد سكان شمال إفريقيا بمعدل سنوي متوسط قدره 2.7 في المئة في الفترة ما بين 1950 و1980، بينما نما عدد سكان الساحل بمعدل سنوي متوسط قدره 2 في المئة. لكن معدلات النمو هذه تباينت ابتداء من تسعينيات القرن الماضي، حيث تنامى عدد سكان الساحل بمعدل سنوي متوسط قدره 3.3 في المائة في الفترة ما بين 1990 و 2010، بينما انخفض معدل تنامي السكان في شمال إفريقيا إلى معدل سنوي قدره 1.4 في المئة في الفترة ما بين 2005 و 2010 قبل أن يعاود الارتفاع قليلاً.
بحلول عام 2050، من المتوقع أن يصل عدد سكان دول الساحل الأربعة إلى 141 مليون نسمة، ما يزيد عدد سكان منطقة الساحل بنحو 10 ملايين نسمة عن عدد سكان البلدان الأربعة الواقعة شمال الصحراء، لتصبح النيجر هي الأكثر اكتظاظا بالسكان في شمال وغرب إفريقيا بتعداد سكانٍ قدره 61 مليون نسمة. وستحتل الجزائر المرتبة التالية بتعدادٍ قدره 60.9 مليون نسمة وتتلوها المغرب بتعدادٍ قدره 46 مليون نسمة. ومن المتوقع أن تكون تونس هي الدولة الأقل اكتظاظا بالسكان، حيث يقل عدد سكانها عن 14 مليون نسمة – وهو ما يضعها على أسفل سلم الكثافة السكانية بعد دولتي مالي وتشاد، اللتين يبلغ عدد سكانهما 40 و31 مليون نسمة على التوالي.
آفاق محدودة للتعاون في مجال الهجرة
إن عدم الاستقرار السياسي والأمني في ليبيا والتوتر السياسي والأزمة الاجتماعية والاقتصادية في تونس والتوترات المتزايدة بين الجزائر والمغرب؛ بالإضافة للضعف السياسي والأمني والاقتصادي الذي تعانيه العديد من بلدان منطقة الساحل وغرب إفريقيا، وغير ذلك من العوامل، يجعل وضع أُطُر بنّاءة لمناقشة مشكلة الهجرة مسألة في غاية الصعوبة. ولا تزال العلاقات الثنائية غير المستقرة بين بلدان شمال وغرب إفريقيا تعرقل إدارة التدفقات السكانية عبر العديد من الحدود وتعيق قدرة الجهات الدولية الفاعلة القانونية وغير القانونية. وما يزيد الأمور تعقيدا أن الوجهات المؤقتة أو النهائية للمهاجرين ستظل تعتمد على سياسات الهجرة التي تطبقها الحكومات المختلفة.
في الوقت الذي يصعب أو يستحيل فيه إجراء حوار بين بلدان شمال وغرب إفريقيا بشأن إدارة الهجرة، يتنامى القلق إزاء مستقبل التعاون بين البلدان الإفريقية بشأن قضايا الهجرة. خاصة في ضوء التصريحات التي يصدرها بعض الرؤساء الأفارقة، مثل الرئيس التونسي قيس سعيد في فبراير/شباط 2023، عندما قال أن ”هناك مؤامرة من قبل مهاجري جنوب الصحراء الأفارقة لتغيير التركيبة السكانية” لبلاده. ومع ذلك، فإن ما نراه من توجهات ديموغرافية ومناخية وآثارها الاقتصادية، تؤكد وجهة النظر القائلة إن حركة التنقل ستتسارع وإنه يجب أن تكون هناك إدارة سياسية منسقة لهذا التنقل لصالح بلدان شمال إفريقيا والساحل. ومن الجدير بالذكر أن جميع هذه الدول أعضاء في الاتحاد الإفريقي، الذي يدافع عن حرية تنقل الأشخاص داخل القارة، بما يعزز التجارة الحرة من خلال اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية (AfCFTA)، التي تعتبر أكبر منطقة تجارة حرة في العالم من حيث عدد الدول المشاركة.
هوامش
1 جميع البيانات الأولية التي تم جمعها لهذا المقال مستمدة من مقابلات أجرتها الكاتبة عبر الإنترنت في ديسمبر 2022، ويناير 2023، مع جاسم الأسدي، المدير الإداري لمكتب الجبايش في مجوعة طبيعة العراق، والفنانة والمخرجة المشاركة والمصورة لمشروع حديقة مياه الصرف الصحي “جنة عدن في العراق” ، السيدة ميريديل روبنشتاين.
2 مجموعة طبيعة العراق، مناطق التنوع البيولوجي الرئيسية في العراق: أهم مواقع الحفظ والحماية، هنتنغتون بيتش، كاليفورنيا: تابلت هاوس للنشر، 2017.
3 مقابلة أجرتها الكاتبة عبر الانترنت مع جاسم الأسدي في يناير/كانون الثاني، 2023.
4 مقابلة أجرتها الكاتبة مع ميريدل روبنشتاين عبر الانترنت في 22ديسمبر 2022.
5 مقابلة أجراها الكاتب مع السيد باتر وردم في عمان، في 24 شباط/فبراير، 2023.
6 مقابلة أجرتها الكاتبتين مع نشطاء مجتمع مدني تونسيين عبر تطبيق زوم في 10 تشرين الثاني / نوفمبر 2022.
7 مقابلة أجرتها الكاتبتين مع نشطاء مجتمع مدني تونسيين عبر تطبيق زوم في 10 تشرين الثاني / نوفمبر 2022.
8 مقابلة أجرتها الكاتبتين مع نشطاء مجتمع مدني تونسيين عبر تطبيق زوم في 10 تشرين الثاني / نوفمبر 2022.
9مقابلة أجراها المؤلف مع مسؤول مناخي ليبي، طرابلس، ليبيا، أيار/مايو 2022.
10 مقابلة أجراها المؤلف مع مسؤول ليبي في المكتب الوطني للأرصاد الجوية، طرابلس، ليبيا، أيار/مايو 2022.
11 مقابلات أجراها الكاتب مع مزارعين ومقيمين ليبيين (عبر الهاتف وشخصيا)، طرابلس، ليبيا، 2022-2023.
12 مقابلة أجراها الكاتب مع مزارع ليبي (عبر الهاتف)، طرابلس، ليبيا، سبتمبر/أيلول. 2022
13مقابلة أجراها الكاتب (عبر الهاتف) مع خبير الحكم المحلي الليبي الدكتور عثمان قاجيجي، يناير/كانون الثاني 2023.
14 مقابلة أجراها الكاتب مع مستشار دولي يعمل في ليبيا (عبر الهاتف) شباط/فبراير 2023.
15 مقابلة أجراها الكاتب مع ضابط عسكري سابق وزعيم محلي من الطوارق ، أوباري، ليبيا، شباط/فبراير 2016.
16 مقابلة أجراها الكاتب (عبر الهاتف) مع عالم ليبي في مصراتة، ليبيا، يشرف على هذا الجهد في تشرين الأول/أكتوبر 2022.